حياة الإنسان في تحول مستمر… فالتحول والتغير، والحركة هي دليل الحياة، والنمو، والتقدم… والتحول قد يكون إلى نجاح أو إلى فشل؛ والأمران كلاها خير… فحتى الفشل، إذا وعيت منه العبرة، يقودك في النهاية إلى النجاح… وهؤلاء خمسة يعرفهم القراء: أديب، وصحفي، ومحام، ومهندس، وطبيب…
يتحدثون إليك عن نقط التحول في حياتهم…
الفشل قادني إلى النجاح
للأستاذ محمد عبد الحليم عبد الله
الكاتب القصصي
متى يعتبر الإنسان حادثة من الحوادث (تحويلة) مفاجئة ظهرت على (خط) حياته؟… يكون ذلك إذا كانت هذه (التحويلة) عاملًا مساعدًا لقطار حظه في الوصول إلى غايته بسرعة… أو إذا كانت (التحويلة) خدعة من القدر بحيث يجد الإنسان (قطار) الحظ وقد ضاع في صحراء أو تردى في هاوية!… فنقطة التحول في الحياة عادة ما تكون شيئًا لا يخطر على البال… وهي بالنسبة إلي تتلخص في حادثة بسيطة جدًا…
في سنة 1941 حاولت بكل جهدي أن أترك عملي في المجمع اللغوي وألتحق مدرسًا بإحدى المدارس الثانوية… وظهرت في الأفق أمارات نجاح أعقبتها أمارات فشل، وأخيرًا باء مسعاي بالفشل وبقيت حيث أنا أندب الحظ، وألعن الزمان!…
ثم سارت أموري الوظيفية بعد ذلك سيرًا لا بأس به جعلني أنسى أملي الأول، حتى كتبت فجأة قصة (لقيطة) وتقدمت باسم مجهول للمجمع، فنلت عليها الجائزة الأولى!…
وأنا سأفرض أنني نقلت مدرسًا ثانويًا، فماذا كان يحدث؟ لا شك أنني كنت الآن في أسيوط، أو المنصورة، أو طوخ، أو العريش؛ وليس في هذا عيب، لكن كيف كنت أكتب قصة (لقيطة)، وكيف كنت أكتب ما بعدها؟!
حادثة فشل واحدة في عام 1941 جعلتني أديبًا، وجعلتني مقيمًا في القاهرة، القلب النابض للعالم العربي…
لذلك فأنا منذ ذلك التاريخ لا أنظر إلى وجه واحد من الأمور، فقد يكون الأمر مسيئًا ويخفي وراءه السعادة… وقد يكون مفرحًا ويخفي وراءه الشقاء!
معلمي الألماني حولني إلى الفلسفة
للأستاذ أنيس منصور
الكاتب والصحفي
لا أعتقد أن هناك نقطة واحدة للتحول في حياتي، وإنما هناك نقط كثيرة. بل إن حياة أي إنسان هي تحولات مستمرة… ولكن إذا كان لا بد من اختيار نقطة فهي في الواقع نقطة ارتكاز. لقد وقفت على هذه النقطة ودرت حول نفسي وحول غيري وتحولت…
كان ذلك في مدينة المنصورة… وهناك كان لي زميل ألماني- لا أعرف أين ذهب الآن- كان يعلمني اللغة الألمانية، والفلسفة الألمانية، والأدب الألماني… وبدأت أحفظ الشعر الألماني بموسيقاه وألحانه دون أن أفهم معظم معانيه… وأسلمني الشعر للفلسفة، ولم أتخلص من الفلسفة أو لم تتخلص مني… ودخلت التوجيهية، وكنت الأول في مسابقة الفلسفة في كل المدارس الثانوية… وبعد ذلك انتقلت إلى قسم الفلسفة بكلية آداب القاهرة، وكنت الأول في الليسانس… ثم اشتغلت بتدريس الفلسفة في كلية آداب (عين شمس) خمس سنوات… وتحولت من احتراف الفلسفة إلى احتراف الصحافة، وهذه نقطة تحول أخرى ولها قصة… وهناك نقاط تحول عاطفية، وعقلية، ودينية، وسياسية، ولكل منها قصة أو قصص…
والإنسان الحي هو الذي يتحول، هو الذي تتحول الأرض تحت قدميه، أو على الأصح هو الذي يحول الأرض تحته والسماء فوقه… والحكمة تقول: (أنا أتحول، إذن فأنا موجود)!…
الصدفة حولت مجرى حياتي
للأستاذ على الخشخاني
المحامي
في سنة 1930 عينت قاضيًا، مع أن حياتي الأولى كانت حياة استقرار في مهنة المحاماة… ومع أني كنت موفقًا في المحاماة توفيقًا كبيرًا في الفترة التي عرضت علي فيها مهنة القضاء- إذ كنت عضوًا في (قومسيون) بلدي مدينة طنطا، ومحاميًا بالاستئناف، وكان إيراد مكتبي لا يقل عن مائتي جنيه في الشهر- إلا أني قبلت وظيفة القضاء، وكان سبب ذلك أنني لم يكن قد مضى على تخرجي أكثر من ست سنوات، ولم يكن قد ولي منصب القضاء أحد من زملائي خريجي عام 1923 الذي شغلوا وظائف النيابة… ولكني رغم هذا وضعت شروطًا لوزارة العدل لتعييني قاضيًا، منها أنه يجب أن يتم تعييني في الإسكندرية. وعينت بالإسكندرية. وكان مرتبي 35 جنيهًا ولم أكن في ذلك الوقت قد جمعت من المحاماة ثروة يمكن أن تعاونني على تحمل أعباء الحياة بهذا المرتب الضئيل، وبدأت المتاعب… فبعت سيارتي، ثم نقلت محل إقامتي من الرمل إلى محرم بك… ثم نقلت إلى الصعيد فظللت به ثلاث سنوات فخفت وطأة الأزمة، وكثر عدد الأولاد فبلغوا ستة… ثم عدت إلى الإسكندرية عام 1935، وظللت بها أعاني ما أعانيه من قلة مواردي وكثرة أعبائي… فقد زاد عدد الأولاد ولدين فأصبحوا ثمانية… وهنا برزت نقطة التحول الحاسمة في حياتي… إذ بينما كنت أراجع الكشف الشهري الذي اعتدت إعداده عن مصروفاتي وإيراداتي، وبعد أن لمست العجز الفاحش، لم يكن أمامي سوى التصرف بالبيع في قطعة أرض أملكها في طنطا مساحتها ۳۰۰ متر لأواجه هذه الأزمات المتتابعة… وبعد ذلك فوجئت في مساء أحد الأيام بحركة قضائية أعدت في سبتمبر ۱۹۳۷ وفيها مرسوم بنقلي قاضيًا بمحاكم القاهرة، الأمر الذي لم أطلبه وكنت راغبًا عنه للاعتبارات المالية، وما يستلزمه نقل أثاث المنزل للمرة التاسعة في سلسلة التنقلات، من إصلاحات وتجديدات… حتى أني لم أسكت عن الاحتجاج لدى الوزارة عن هذا النقل… ففهمت بأن الوزارة قد اختارت ستة عشر قاضيًا من قضاة القطر للعمل في القاهرة رفعًا لمستوى القضاء فيها باعتبارها عاصمة الدولة، وأن الاختيار قد وقع علي لأكون مفتشًا في لجنه المراقبة القضائية بوزارة العدل… فوجدت في هذه التصريحات بعض العزم، وانتقلت إلى القاهرة وتسلمت عملي بالدائرة السادسة بمحكمة مصر…
كنت خالي الذهن عن أي تفكير فيما أراد الله أن يحققه لي، وإذ بي أفاجأ برسول يزورني في بيتي موفدًا من قبل المرحوم الدكتور أحمد ماهر يطلب إلي مقابلته في صبيحة اليوم التالي، وإذا به يدعوني… وهكذا للانضمام للحزب السعدي، والترشيح نائبًا بمدينة طنطا… ورغم أني لم أكن أملك سوى 350 جنيهًا، فقد دفعت ۱۰۰ جنيهًا تأمينًا…
وهكذا عدت إلى المحاماة قاعدتي الأولى مع عضوية مجلس النواب!
ومنذ ذلك التاريخ وأنا أعمل محاميًا حتى استطعت أن أصل إلى ما كنت أتطلع إليه منذ أن تخرجت، وهو أن أكون محاميًا مشهورًا بمدينة القاهرة، وفي ظل هذه المهنة الكريمة استطعت أن أتم رسالتي في الحياة فزوجت بناتي الأربع، واستكمل أبنائي الذكور دراساتهم، واستقر حالي على الوضع الذي أرجوه…
كافحت لأغير مجرى حياتي
للأستاذ سعد زغلول إبراهيم
المهندس المعماري
تخرجت في كلية الهندسة عام 1939 وعملت عقب تخرجي مباشرة مهندسًا بوزارة الأوقاف بمرتب قدره اثنا عشر جنيهًا، وتساءلت عندئذ: متى يبلغ مرتبي مبلغًا يكفيني أن أتزوج وأنفق على أولادي في المدارس، ويكون لي في منزلي (فريجيدير) وغسالة كهربائية، وراديو، وجهاز تسجيل، و(بوتاجاز)، وكل الأدوات الحديثة!. وأدركت بعد تفكير أنني لن أصل إلى هذا وأنا مقيد بالوظيفة، ومن جهة أخرى وجدت أن معلوماتي محدودة، فانطلقت.. تحررت من الوظيفة وفتحت مكتبًا… وبعد مدة قصيرة أردت السفر إلى الخارج وخصوصًا فرنسا لاستكمال دراستي، ولم يكن معي سوى 150 جنيهًا فاتخذت مكاني على ظهر السفينة. وفي منتصف الطريق مرضت، فنقلوني إلى مستشفى الباخرة حيث بقيت حتی وصلت إلى فرنسا… ونزلت باريس، والتحقت بكلية الفنون الجميلة العليا… وكان علي أن أبحث عن عمل فالحياة المعيشية باهظة جدًا، وكنا عقب الحرب في عام 1946… فأخذت أذهب إلى المهندسين ولكني لم أجد أحدًا يعاونني إلا واحدًا فقط وهو (جاستون جيل)… طلب مني عمل (تابلوه) فقمت بعمله على الطراز العربي البديع فأعجب به وألحقني بالعمل عنده بمرتب يعادل ثمانين جنيهًا مصريًا… وفي الوقت نفسه كنت أذاكر عشرين ساعة في اليوم، ولذلك كان ترتيبي الثاني برغم أنني انتهيت من الدبلوم في ثلاث سنوات، ومدته أربع سنوات، وكنت أحضر في الصيف إلى مصر!.. ولا بد لي أن أذكر في هذا المقام أني اشتركت مع (جاستون جيل) في بناء مستشفى (سان كلو) بجوار باريس… وفي كثير من مشروعاته ومن بينها فيلا في سان كلو عليها اسمي إلى الآن!
كانت هذه هي نقطة التحول في حياتي… فقد ازددت علمًا، ورأيت كل ما لم أره عندنا من فنون معمارية، وطرز جديدة في فرنسا، ولذلك ما إن عدت حتى بدأت أظهر بآرائي على صفحات الجرائد… فتكلمت عن مشروع مدينة المقطم، ومشروع هدم المباني والأحياء الفقيرة، وبيع الأرض وإنشاء عمارات سكنية عليها… كما اقترحت إنشاء مبنى لمشوهي الحرب وإقامة أسر الشهداء على أن يزود بأقسام للصناعات الخفيفة، وعرضت جهودي لوضع الرسومات والإشراف على التنفيذ دون مقابل… وقد عقدت مسابقة عالمية لإنشاء فندق في تركيا على البسفور وفزت بالجائزة الأولى وقدرها خمسة آلاف جنيه.
لقد أثمر الجهد الذي بذلته في أوروبا حتى أني قمت ببناء أكبر مجموعة من المباني في القاهرة… والمكافح لا بد أن يصل… ولابد له أيضًا أن يرى، ويسافر. فإني أرى في السفر لا سبع فوائد فقط كما يقولون بل سبعين ألف فائدة!
ولادة عسرة غيرت مجرى حياتي
للدكتور نجيب محفوظ
طبيب أمراض النساء
كانت أهم نقطة تحول في حياتي هي التي حولتني إلى الاشتغال بأمراض النساء والولادة… كنت أعمل في مكافحة الكوليرا بالإسكندرية عام 1902… وهناك تعرفت بزميل فاضل هو وكيل المستشفى الأميري. ولما توطدت روابط المعرفة بيني وبينه طلبني لصاحبته إلى حالة ولادة عسرة. وكانت المريضة شابة من أصل شركسي، ومن عائلة كبيرة معروفة بمدينة الإسكندرية وكانت مهمتي أن أقوم بإعطاء البنج، أما الولادة فيتولاها هو مع أحد مساعديه من أطباء المستشفى، وقد حاول كل منهما توليدها (بالجفت، فلم تنجح المحاولات، فاتفقا على عمل التحويل القدمي للجنين، لكنهما لهم يستطيعا الوصول إلى القدم، فطلبا مني أن أبحث عن القدم لأن ذراعي كانت نحيفة يسهل إدخالها إلى باطن الرحم، ولكني تنحيت عن ذلك معتذرًا بأني لم يسبق لي أن حضرت قبل ذلك أي ولادة طبيعية كانت أو متعسرة!… فأعادا الكرّة مع المريضة وأخيرًا نجح الاثنان في إخراج القدم، وتخليص الجسم إلى الأكتاف… ولكن الرأس لم يخرج، فأخذا يشتدان في الجذب حتى انفصل الجسم عن الرأس الذي بقى داخل الرحم، وذهبت جهودهما في إخراج الرأس أدراج الرياح!… وأشرت عليهما باستدعاء أحد الأطباء الاختصاصيين في الولادة بالمدينة فأخبروني أنه لا يوجد بالإسكندرية طبيب واحد، مصري أو أجنبي، مختص بالتوليد! ولم يأت الصباح على هذه البائسة إلا وقد وافاها القضاء المحتوم، والرأس ما زال داخل الرحم!..
وقد تركت هذه الحادثة في نفسي أثرًا عميقًا جدًا حتى أني لم أستطع النوم ليلتين متتاليتين، ولم يهدأ لي بال إلا في الليلة الثالثة التي أخذت فيها على نفسي عهدًا أن أكرس حياتي لدراسة الولادة وخدمة المتعسرات فيها…
– نُشر أولًا بموقع حياتك.





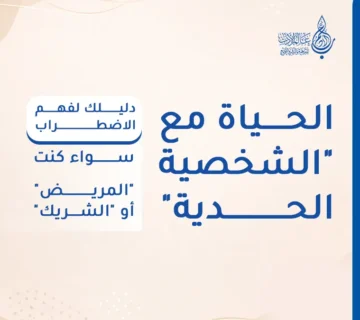

لا يوجد تعليق