دقت الأجراس في كل مكان تعلن… الشباب في خطر
للأستاذ أحمد خليفة
مدير المعهد القومي للبحوث الجنائية
سمعت هذه الأجراس العالية أينما توجهت، في ألمانيا، والنمسا، والدنمارك، والسويد وفرنسا، وإنجلترا، وأمريكا، شرقًا وغربًا…
وسمعتها في مصر..
قال لي المدير العام للسجون في السويد: (إن الشباب السويدي كان مثالًا لأوروبا كلها في دماثة الخلق، والرزانة، والشعور بالواجب. ولكننا اليوم نواجه طوفانًا من الشباب المستهتر الذي يعشق الفوضى، ويستهين بالتقاليد، ويفزع الآمنين.. إن سرقات السيارات قد بلغت حدًا مخيفًا، وكسر الخزائن ونهب المحال أصبح جريمة كل يوم!).
وقال لي قاضي الأحداث في محكمة فيينا: (لقد قضيت في هذه المحكمة ردحًا طويلًا لا أنظر سوى قضايا الأحداث، وإنه ليروعني أن الأحداث الذين كنت أراهم في مخالفات بسيطة قد أصبحوا يساقون لي في أخطر جرائم العنف، والسطو، والقتل!)
وقرأت في مذكرة عن الجرائم في اليابان أنه في الأشهر الأربعة الأولى من عام 1957 بلغ عدد الطلبة المتهمين في جنايات، ألفين وخمسمائة، بينما لم يكن متصورًا أن يتهم طالب جامعي قبل الحرب في أي جناية! واليوم يقتل طالب جامعي في إحدى جامعات طوكيو صديقته لا لشيء- كما يقول- إلا لمجرد التغيير والتجديد!
أما في أمريكا، فإن الحديث عن جرائم الشباب قد اتخذ هناك شكلًا هستيريًا.. إنه حديث الصحف، والإذاعات، والتليفزيون، وحديث الناس في سهراتهم ونواديهم، وفي القطار والسيارات العامة، بل ندر أن ترى مسرحية أو تشاهد فيلمًا لا ينوه بجرائم الشباب وانحرافهم!
هناك رأيت الشباب الأمريكي يجلس أمام القاضي وحذاؤه فوق منصته، وهو يلوك (اللبان) في فمه!.. وقاضي الأحداث في أمريكا يتقاضى عشرين ألف دولار في العام، أي ضعف مرتب أستاذ الجامعة تقريبًا!
ورأيت في سجن الفتيات في نيويورك أحداثًا في الرابعة عشرة يضعن المساحيق كأنهن في سهرة، ويرقصن على نغمات (الروك أند رول) ويدخن السجاير في نهم!
وقالت لي: (أنا كروس) مديرة شئون العقاب في ولاية نيويورك:
(إن مشروع السنوات الخمس لمدينة نيويورك لبناء سجون لائقة للجميع (كذا!) قد اعتمد له مبلغ خمسين مليونًا من الدولارات!).
وفي أمريكا بالذات يبدو أن الأمر خرج من كل يد.. خمسون في المائة من المتهمين في سرقات بالإكراه تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا! بل واحد في كل ثلاثة منهم كان أقل من ستة عشر عامًا!. خمس مدمني المخدرات أعمارهم تقل عن واحد وعشرين عامًا!. سدس حوادث الوقاع بالإكراه ارتكبها مراهقون لم يبلغوا الثامنة عشرة!.
أما الإتلاف والتخريب فيبدو أنه من أمتع شئون الشباب في أمريكا!.. إن شباب المدارس يحطمون على الأقل ربع مليون لوح زجاجي في كل عام، وهو عدد يزداد باطراد عامًا بعد عام، وهذا بغير حساب مثل هذا العدد على الأقل من ألواح الزجاج التي تتحطم خطأ نتيجة إلقاء كرات (البيسبول)!.
وهذا الإتلاف والتخريب يتجهان أيضًا إلى الآدميين.. عصابات الشبان تذرع الشوارع والحدائق وفي المساء تضرب سيء الحظ ضربًا مبرحًا، وتحرق الوجوه بالسجائر المشتعلة، وتلقي البعض في الأنهر.. والأسباب؟ (وجهه لا يعجبني).. (لا أحب المتشردين).. (لأبعث به إلى الشيطان).. (للتسلية، والترويح عن النفس)..
هذه هي الصورة القاتمة لانحراف الشباب الذي يقلق معظم دول العالم..
ولكن: هل دقت أجراس هذا الخطر في وطننا العزيز أيضًا؟
لقد وقعت من بعض شبابنا بعض الحوادث المؤسفة في السنوات الأخيرة. ونلاحظ أحيانًا ميلًا عند بعض الشبان إلى الاستهتار، وتحدى السلطة والاستهانة بالتقاليد والآداب.
ولكن السؤال هو: هل شبابنا خطر؟ هل شبابنا في خطر؟
لقد تتبعت على قدر الإمكان كل ما قيل في هذا الموضوع، وبقدر ما أعجبت بالقلة المتحفظة التي لم تنطق بحكم عاجل بل رأيت أن الأمر جدير بالبحث والتحليل وعناية الدوائر العلمية، أشفقت من آراء الكثرة الذين قفزوا إلى نتائج سريعة، وأصدروا على شبابنا حكمًا قاسيًا بالانحراف..
وخشيت عند ذلك أن يجرفنا تيار التهويل الذي يكتسح بعض الدول الأخرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أصبح الاتهام بالانحراف والجريمة هدية الصحافة إلى الشباب كل صباح!.. وأيد إشفاقي ما سمعت من أن بعض مخرجي السينما المصريين- متأثرًا بما سمع عن أمريكا أو شاهد بها- قد أعد العدة لإنتاج أفلام عن جرائم الأحداث في مصر.. نعم، خشيت أن نبدأ- مقلدين- هذه الدورة المرذولة، دورة الشك، والاتهام، وسوء الظن بالشباب، حتى ينتهي بنا الأمر إلى أن نخلق بأنفسنا الشبح الذي يقض مضجعنا فيما بعد!
والواقع أن بعض ذوي الرأي في أمريكا نفسها يحاولون إيقاف تيار المبالغة الذي يحف بمشكلات الشباب ويتهمون رجال الصحافة والسينما والإذاعة بأنهم ينفخون في الهين من الأمور حتى يتضخم إلى أن فقد الشباب حسن ظنه بنفسه، وأصبح اتهامه بالفساد دافعًا له إلى الإفساد..
إن الإحصاءات الدقيقة تعوزنا، والحادث الواحد قد يدفعنا إلى التعميم والتشاؤم وهو بعد حادث فردي لا يدل على اتجاه واضح..
ولكن هناك- فيما نرى- عوامل فعالة يخشى أن تحدث آثارها السيئة في جيلنا الحديث.. وهناك- ولا شك- سياسة وقائية يمكن أن تبنى على أساس ما تسفر عنه الدراسة العلمية لهذه العوامل..
ونرجو أن تتهيأ لنا فرصة مستقبلة لمعالجة هذه العوامل والحديث في هذه السياسة لعلنا نأخذ بأسباب الحيطة في وقت مبكر.. إنه لخير لنا أن نقرع طبول التحذير، قبل أن تدق أجراس الخطر..
– نُشر أولًا بموقع حياتك.





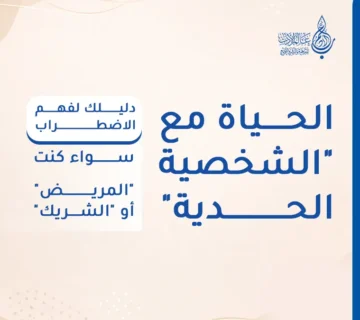

لا يوجد تعليق