(أكثرُ المشايخ والقيادات التاريخية يظنون أنهم يفهمون في كل شيء، وهذا من المعضِلات المزمنة للصحوة الإسلامية كلها، وهي في التيار الجهادي أشدُّ كارثية).
أبو مصعب السوري.
(1)
أربعون عامًا هي بالتقريب عمرُ هذا الطَّور الذي نشهده من أطوار التيارات الإسلامية، وهو الطور الذي يُسلِّم الكثيرون أنه على وشك التحول لطور جديد له معالم تختلف بدرجةٍ ما عن الطور السابق؛ وهو الاختلاف الذي يتم تحت وطأة التجربة العصبية والمرهقة التي تمر بها التيارات الإسلامية من خمس سنوات.
إشكالية القيادات والرؤوس هي واحدة من أهم الإشكاليات التي يجب أن نعتنيَ بدرسها وتحليلها، إذا ما أردنا أن نفهم هذه التيارات فهمًا صحيحًا، سواء على مستوى الدوافع، أو على مستوى التصرفات، أو حتى على مستوى النتائج.
وسأتناول هنا هذه الإشكالية من زاويةٍ بعينها، وهي زاوية نظر القيادات إلى نفسها، أو نظر أتباعها إليها، على أنها تملك الحلول السحرية والرؤى الشاملة، والمشورة المتجاوزة في قدرتها ونجاعتها لحدود التخصصات المعرفية ومختلف المجالات والظواهر الاجتماعية.
الإسلاميون في عالمنا العربي وشطرٌ كبير أيضًا من العالم الإسلامي= هم أبناء مجتمعٍ فقيرٍ في بنيته الاجتماعية المدنيَّة، فقير في مؤسساته، فقير في كوادره ونخبه، فقير في سادته ووُجهائه، إنه مجتمع الدول العربية الحديثة التي أنهكها الاستعمار، ودمَّر جماعاتها الوسيطة، ثم أتت حكومات ما بعد الاستعمار؛ لتكمل طريقَ الهدم نفسه، ولتحافظ على حالة الهشاشة المجتمعية التي تُؤمِّنُ لها سلامة أركان حكمها.
وبعد كل هذه الهشاشة، فإن الإسلاميّ عند التحاقه بالمجموعة الإسلامية التي اختارها= يُفارق البقية الباقية من روابطه الاجتماعية، ويقطع جزءًا كبيرًا من ولائه لها؛ لينتقل بولائه للتيار الإسلامي الذي التحق به، ولأفكاره وتوجهاته وأدبياته، والأهم: لرموزه وقياداته ورؤوسه.
ودعونا نضيف لعاملِ الفقر الاجتماعي، عاملَ فقر الوعي والمعرفة، وضعف العملية التعليمية في العالم العربي، وعجزها عن مد المتخرجين منها بأدواتٍ للتفكير السليم، وفقدان العملية التعليمية لخارطةٍ معرفية لا تركز على الكم قدرَ تركيزها على الكيف، خاصة من حيث حرصُها على تكوين عقلية علمية مُنظَّمة تُحسن اختبار صدق المعرفة المقدَّمة لها في مختلف المجالات.
هذان العاملان، ما هو مجال تأثيرهما؟
دعونا نكمل القصة!
(2)
مع حدوث هذا الانتقال، تتعمَّق الرابطة التي تربطك كإسلامي بهذه القيادة، وهي رابطةٌ تتنوع بين الرابطة التنظيمية في تيارٍ كالإخوان المسلمين ويشبهها السلفية التنظيمية، وبين الرابطة المشيخية في السلفية العلمية والدعوية، وبين رابطة الإمارة في التيارات القتالية/ الجهادية.
هنا يبدأ العاملان في التدخل؛ فالرابطة التي تتعمق، مع ضعف البِنى الاجتماعية المحيطة بك، مع فقرك المعرفيّ وضعف أدوات التفكير عندك، وشعورك بهذا وباحتياجك لمصدرٍ آمنٍ للمعلومات والأفكار= تبدأ في التسليم لقيادتك، وليس هذا فحسب، وإنما أنت في الغالب تُسَلِّم تسليمًا غير مشروط، وغير محدود، ويتحول الشيخ/الرأس إلى مصدر كليّ المعرفة، إنه الشيخُ البصير، الفقيهُ بالشرع والواقع، إنه واحدٌ من إخواننا الذين بالأعلى، الذين يرَون ما لا نرى، أصحاب التضحيات، والعبادة المجلَّلة بالعلم والتقوى، ولا. ليس هذا في الفتيا الفقهية أو الخبر عن الشرع فحسب، بل حياتك الزوجية، خياراتك التعليمية، مساراتك المهنية، تحليل الواقع ورؤيته، والتحكم برؤاك وخياراتك، كل شيء تقريبًا يتم تسليمُ دفته للقيادة.
والقيادة بدورها تستمع بهذا، فمن ذا الذي يبغض تبعية لا تسأله عما يفعل، ولا تراجعه الأمر؟!
في أحد الحوارات مع الشيخ محمد الغزالي السقا رحمه الله، سأله المحاورُ عن أسباب استبعادِ الشيخ حسن البنا له من التنظيم الخاص رَغم ترشيحه له= فأجاب الشيخُ الغزالي بأن البنا قال نصًّا لمن رشح له الغزالي: (لا يصلُح هذا الرجل للنظام الخاص بتاتًا، نظامُكم نظامٌ عسكريّ، وهذا الشيخ يعترض ما لا يعقِل).
هل هذا خاصٌّ بالتنظيم الخاص، أو بعبارة أدق هل هذا خاصٌّ بالنُّظُم العسكرية؟
| في الواقع إن التيارات الإسلامية -على اختلاف تنوعاتها-، تستحضر في علاقاتِ القادةِ بالأتباعِ مفاهيمَ الجُندية، وإن كان هذا يَحدث بدرجات متفاوتة بلا شك، إلا أنه يبقى قيمة كامنة تحكم العلاقة بين القادة والأتباع. |
(3)
إنَّ استبطان القادة والأتباع لمفهوم الشيخ/القائد السوبر مان كان واحدًا من خطايا وكوارث التيارات على اختلافها وتنوعها؛ إن حالةَ الفقرِ المعرفي العام، وانحسار الموارد التكوينية والمعرفية لقيادات التيارات الإسلامية، ومحدودية تخصصاتهم= تَحوَّل بصورةٍ مباشرة، وبين امتلاك أحدهم لشرعيةِ أن يكون مصدرًا للرأي والقرار ورسم المسارات، بهذه الصورة.
وحتى التيارات التي تزعم أنها تَصدُر عن مجالس شورية تتلاقح فيها الآراء، أثبتت شواهدُ الخمس سنوات الأخيرة مدى صُورية هذه المجالس، أو على الأقل: مدى فقر وضحالة أعضائها بحيث لا يُقوِّي بعضهم بعضًا -إذا استعملنا لغة علماء الرجال في نقد الأسانيد.
قد يوجد النوابغُ في أمةٍ ما في بعض حِقَبِها الزمنية، وقد يوجد في التيَّار الواحد فردٌ فذٌّ متنوعُ المعارف وُهِب أدوات القيادة وسداد الرأي ونفاذ البصيرة، لكن أن يُظن هذا في كل شيخٍ ترأَّسَ قومًا، أو في كل قيادةٍ أعطاها مكانتَها تسلسلٌ تنظيميٌّ لا تُعرف له أسسٌ عقلانية مُعلَنة= فهذا ضربٌ من الفساد تشهد عليه خطايا السنين الماضية.
إن المسؤولية عن هذه الكارثة مسؤوليةٌ مشتركة؛ سهمٌ منها للقيادات التي استروحت لمكانةٍ غير مشروعة، أعطتها لهم جموعٌ لا تدري ما تصنع.
وسهمٌ منها لأتباعٍ قعدوا عن تطوير أدواتهم ومعارفهم، ورضوا أن يَبقوا في وهدةٍ سافلة، تُلقَى إليهم لُقَيمَات الأوامر، وترتعدُ فرائصهم خشيةَ الطَّرد والحرمان إن هم طلبوا حقَّهم حتى في فَهم ما يُلقى إليهم، فضلًا عن مناقشته، أو المحاسبة على نتائجه وآثاره.
وسهمٌ فيها للكل مجتمعين، حيثُ قلَّ فيهم الفقهاءُ، وقلَّ فيهم السادةُ والوُجهاءُ، وقلَّ فيهم الخبراءُ أهل الاختصاصات المتنوعة.
(4)
إن من أكثر ما تُسلَّمُ له العقولُ في قضية السمع والطاعة: لزومَ الطاعة في الجُندية، وأنَّ الجندي لو فكَّر وناقش = لم تستقم العسكرية، وربما أدى ذلك لكوارث في الحروب.
ورَغم ذلك فإن أحدَ أهمِّ أحاديث الطاعة، وأنها لا تكون إلا في المعروف = جاء في سياق الجندية والعسكرية؛ ليكون هذا من أهم إصلاحات الإسلام للنُّظُم العسكرية القائمة في العالم.
عن علي رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعثَ سَرِيَّةً، وأمر عليهم رجلًا، وأمرهم أن يُطيعوه، فأجَّجَ لهم نارًا وأمرهم أن يقتحموها، فهمَّ قومٌ أن يفعلوا، وقال آخرون: إنما فررنا من النار، فأبَوا، ثم قدِموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذُكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، لا طاعةَ لبشرٍ في معصية الله عز وجل إنما الطاعة في المعروف).
وهذا يقتضي أن العقلَ لا ينبغي أن يتوقفَ عن محاكمة ما يُصدَر له من أوامر، حتى في سياق الجُندية؛ ليُمَيِّز ما يتعلَّق بالحلال والحرام من غيره، ثم يَعرِض هذا الذي ميزه على الوحي فلا يُطيعُ في معصية.
ولم يَخلُق اللهُ بني آدمَ إلا لعبادته، ولا تستقيم عبوديتُهم حتى يتحرروا من كل عبوديةٍ لغيره سبحانه، ولا يتم لهم هذا التحرر إلا بأن يستقلَّ نظرُهم وتفكيرُهم عن الطاعة العمياء، ولا يستقل لهم هذا النظر حتى يستكملوا أدواته؛ فإن طلبَ الاستقلال بغير أدوات سيزيد الأدعياءَ المُتسنمين ذُرَى ما لا يُحسنون، ولن ينفع صاحبه ولا المسلمين.
واستكمالُ الأدوات عمليةٌ متتابعة مدة العمر، لا ينفكُّ عنها الإنسان، وهو مأمورٌ في كل حالٍ، بحسب طاقته وما حصله من العلم: أن يعرِضَ ما يُؤمر به على الوحي، فلا يطيع في معصيةٍ بانت له، وإن ساغَ له التأني فيما اختلف فيه الفقهاء ،إن كنا في سياق المباحثات الفقهية= فإن أكثرَ ما يُفسِد الناس ليس التسليمَ في هذه المنطقة، وإنما تسليمُهم عقولهم لرؤوسهم في قطاعاتٍ واسعةٍ من المعارف والظواهر والخيارات= ليس قولُ أولئك الرؤوس فيها بأولى من قولك فيها، وليسوا فيها بأعلم منك، لا أعني أن تقول مثلهم، ولكن أعني أن كليكما يحتاج لغيره ينظر له، وتلك عاقبة تيارات أَفرغت بِناءَها من ذوي الاختصاص القادرين على تقديم الرأي.
وتلك عاقبةُ قومٍ قلَّ فيهم السادةُ أهلُ الرأي والمشورة والنظر.


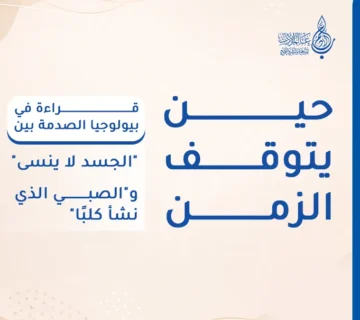
لا يوجد تعليق