“لا يُقاس غنى المجتمع بما يملك من أشياء، بل بمقدار ما فيه من أفكار”
المفكر مالك بن نبي
جلست إلى صديق لحظةَ صفاء روحي، أبثه حبي للسفر قائلًا: “أحببت السفر منذ طفولتي…”، ولم أكد أتم حديثي حتى قاطعني كعادته قائلًا: “وما المميز في الأمر، فالجميع يحبونه أيضًا! هل ثمة مَن لا يحبه؟” وكعادتي في طرح أفكاري للنقاش بيننا، أجعله يلتقط طرف الكلمات؛ ليلوكها بلسانه مقلبًا أفكاره الجامدة عن الحياة من حوله.
سألته وأنا على علم بما يعتنقه من أفكار تجاه السفر “وما السفر بنظرك؟”. نظر إليَّ كأنه لم يكن ينبغي أن أسال سؤالًا كهذا؛ إذ الإجابة معروفة مسبقًا، فهو الذي ذهب إلى حيثُ لم أذهب، ورأى ما يعتقد أني لم أره. بثقته التي تعودتها حين يتحدث عن نفسه، أخبرني وأنا أعرف مسبقًا ما سيقوله، بأنه طاف سبع بلدانٍ، وهو لم يتجاوز السابعة والعشرين من عمره، وتلك منقبة وسبق، يستحق الثناء والكتابة بماء الذهب في سجل سيرته الذاتية.
أشهد أنه أحسن إلى نفسه؛ إذ أخرجها من نطاق عالمنا العربي الضيق الأفق، المتقوقع حول ذاته، الواقف على خط الزمن ينظر إلى ماضيه بنوستالجيا مرضية؛ ليرى ويسمع ويشهد على التقدم الذي أحرزه إخواننا في البشرية في شتى بقاع الأرض، التي تدور دورتها فترفع بمرور زمن دورانها أممًا، وتخفض أممًا أخرى.
غير أني أردت أن أفتح عينيه على أفق أرحب لمعنى السفر، فسألته مُثيرًا لحفيظته التي لم يؤثر السفر في جمودها، “وهل تغيرت التجربة البشرية بسفرك؟”. بدا كأنه لم يفهمني ودارت عيناه في محجريهما تبحثان عن إجابة… لحظات طالت حتى استعان بفيالق شخصيته، التي تبدو قوية؛ ليرهب بها سماحتي في الحديث؛ لئلا أجرؤ على الخوض في تلك الأمور الفلسفية، التي تتخطى حاجز منفعته الذاتية من وراء السفر لتشمل الأمة والتجربة الإنسانية، وهو الذي أنفق على سفره من ماله الخاص، وليست الإنسانية مَن دفعت عوضًا عنه.
لاطفته بابتسامة، وألنت له القول؛ لتنبسط أسارير وجهه العبوس، وليلين جسده المتحفز ليوجعني ضربًا… انتظرت قليلًا حتى حدثني جسده بأنه أصبح جاهزًا لتلقي صفعة فكرية أخرى، وكنت قد شحذت آلات جراحتي الفكرية كأمهر الجراحين؛ لأستأصل من ذاته حبها للنفعية الفردية.
قلت: “يا صديقي، أرى أن المسافر وغايته المتعة والمنفعة الذاتية كالذي يستأثر بالطعام لنفسه، والمجاعة تصيب قومه، ألست توافقني الرأي؟”
لم أمنحه الفرصة ليرد، تابعت حديثي “إن الأمة تنقصها الأفكار الإصلاحية حتى أصابتها جراء ذلك مجاعة فكرية، وأوشكت على الموت إفلاسًا، إلا من حبل يربطها ببعض أفكارها التاريخية التي حفظت بقاءها حتى اليوم. وإن المسافر إلى بلد آخر يمكنه إلى جانب تمتعه بما يراه ويسمعه ويتعلمه أن يسجل الأفكار التي يرى مناسبتها لحال الأمة، ثم ينشرها في الناس حال عودته؛ ليملأ بها عقولهم وينقذهم بها من موت محقق”.
قام من حيث يقعد مشيرًا بإصبع الاتهام إليَّ قائلًا: “اصمت أيها الأبله، فإنني لم أذهب إلى هناك لأذكر الأمة التي تتحدث عنها، فما أخرجني للسفر إلا حاجتي للهروب من هذا الواقع الأليم، ما تظن قد يدفعني لإنفاق مالي هنا وهناك.. إنني أهرب.. وما إن أعود حتى تعتريني الرغبة في السفر مجددًا”.
لله دره؛ إذ وضع إصبعه على موضع الألم، فجملة الأفكار التي تعتنقها الأمة جعلت بيئتها خانقة لا تصلح للعيش، ودليل ذلك هجرة الشباب أصحاب الكفاءات، وهل قد تبني نهضة بغيرهم؟
لا زال ثمة بُعد آخر يمكنني طرحه؛ لأثبت له أن أزمة الأفكار قابلة للحل في حال إرادتنا ذلك.
قلت مستخدمًا لغة الرياضيات التي يفهمها جيدًا: “هاجر الملايين من أبناء الأمة، وسأفترض أنهم فقط عشرة ملايين! فكم عينًا فيهم تري؟ وكم أذنًا فيهم تسمع؟ وكم عقلًا فيهم يفكر، وكم قلبًا فيهم يعي ويفهم؟”.
أجابني بالأرقام، لكنه أخبرني أنه لا يفهم ما أرمي إليه.
قلت: “إن هذه الملايين رأت وسمعت، بل وطورت من الأفكار ما ساهم في تطوير الأمم التي يحيون فيها، أفلا تظن إن عاد هؤلاء إلى حضن الأمة أن يقضوا على مجاعة أفكارها؟”.
قال: “بلى، ولكن ما قد يدفعهم لفعل ذلك، وبقاؤهم هناك خير لهم؟”.
قلت: “إن هم جاؤوا وعدلوا أفكارنا تغير مناخ الحياة على أرض الأمة، وأصبحت جاذبة لنا ولغيرنا، ولن تكون أنت، ولا غيرك في حاجة إلى السفر هاربًا إلى أمم أخرى، بل فاتحًا لها، مطورًا لأفكارها، ومعيدًا لها إلى حظيرة الإيمان”.
أضاءت فكرة في رأسه؛ إذ شعر بعقلانية ما أقول، فماذا لو عاد الطير المهاجر إلى عشه فأعاد بناءه، وأنجب فيه فراخه، وعلمها الولاء للعش والعمل على ريادته”.
قال: “ولكن كيف نجذبهم ليعودوا؟”.
صمتُّ قليلًا حين علمت أن مشرطي قد أزال بعضًا من خبث ذاتيته، وأصبحت نفسه مستعدة لتقبل العلاج.
بلغة الأرقام حدثته مرة ثانية “كم مليون شخص يسافر كل عام إلي حيث المهاجرون، ليعودوا بعد نزهاتهم إلى الوطن الذي لا زال يربطهم به رابط ما، على غرار الذين هاجروا وحققوا ذواتهم وأحلامهم خارجه؟”.
أجابني بالأرقام أيضًا معتقدًا أنه فهم ما أرمي إليه هذه المرة قائلًا: “لعلك تقصد أن نحاول إقناع المهاجرين بالعودة إلى الوطن”.
قلت مشجعًا: “أحسنت، لكن إجابتك هي شطر أخير من فكرة أوسع”.
قلت: “لو أن كل مسافر تبنى فكرة واحدة مما جذبه من أفكار حال سفره، وجيش إمكاناته؛ ليزرعها في عقول الناس ونفوسهم حال عودته، بل وعمل على أن تكون واقعًا في حياتهم؛ لأصبح لدينا ملايين الأفكار كل عام، ولتهيأ المجتمع لعودة طيوره المهاجرة التي ستبني عش الوطن بأسرع مما نتخيل. ولا بأس بالمسافر لأجل المتعة أن يضع في خطة سفره لقاء مهاجر لتذكيره بواجبه نحو الوطن، وليستلهم من أفكاره ما يعود به نميرًا إلى الوطن فتتهيأ الأمة”.
سكتُّ حين رأيت بريق الفهم في عينيه، ومنحته وقتًا للتفكير، ففي عقيدتي كل شخص هو كنز مكنون عليه قفل من أفكار مطبوعة في ذاته، ما إن تجد المفتاح المناسب، حتى يفتح لك عن كنوز لم تكن لتتخيل أن مثلها على الأرض، فهاكم الأقفال، فأين المفاتيح؟
لم أكتفِ بذلك، وإنما أبحرت به إلى أبعد… أخبرته بحقيقة هي من أوثق المسلمات في حياتي، قلت وأنا أعلم أني سأزيده حيرة: “في الوقت الذي لم أجد مالًا ليكفيني مؤنة السفر، اعتدت السفر بين الكلمات“. في هذه المرة لم يغضب، بل طلب مزيدًا من الإيضاح.
قلت: “إن الذي قصرت به حاجتي للسفر، لم تقصر به حاجتي لشراء الكتب، وإن السفر عبر الطائرات إلى الأقطار يماثله السفر عبر الكتب إلى عوالم تفوق العالم الأرضي سعة، وإن ما يؤلم حقًّا أن أمة اقرأ، لم تعد تقرأ، والقارئ منهم -إلا قليلًا- يبحث عن مسكنات فكرية لا مقويات فكرية، وقلة تقرأ بغية بناء صروح خاطفة للأبصار للأفكار الخالدة التي ضمنت بقاء الأمة إلى الآن. أعتقد أن القراء من الأمة عليهم أيضًا أن ينبذوا النفعية الذاتية في القراءة، وأن يقرأوا ليُقرِئوا الناس الأفكار والجواهر المكنونة في الكتب التي غطتها الأتربة، فيُغاث الناس بذلك من مجاعتهم الفكرية”.
توقفت حتى لا يتيه مني بين الكلمات، وأنا مبحر على شواطئها.
تعجبت من جوع عينيه طالبًا المزيد؛ ليروي ظمأ خياله، أردت أن أبسط له الأمر فعقدت مقارنة بين السفر والقراءة؛ لأشرح له بعد ذلك أن كليهما يمكنه مساعدة الأمة في التغلب على محنة أفكارها.
قلت: “إن كان السفر قد منحك الإلهام، فإن القراءة ملهمتي؛ إذ إني سافرت في ماضي الزمن حين طالعت كتب التاريخ الإنساني بمشتملاته، وحاضره لما أبحرت في عقول الكُتَّاب المعاصرين لأحوال البشرية، ومستقبله حين غذيت خيالي بقراءة كتب الخيال والروايات، وما أشبه ذلك بالسفر إلى دولة ذات حضارة قديمة حديثة، ولها مستقبل باهر. بل إني ذهبت إلى أبعد من ذلك حين سافرت بين النجوم، ولامست أسطح الكواكب، وطفت مع الأقمار، وغصت في عمق المادة، وسبحت في الفضاء، ورأيت المجرات، والعوالم والأكوان لما طالعت كتب علوم الكون.
لا تعتقد يا صديقي أني اكتفيت، فالقارئ منهوم لا يشبع، لا لم أشبع، وما روى ذلك شبقي إلى المعرفة، لكن ما قد يكون أبعد من ذلك؟
النفس البشرية يا صديقي هي الأرحب والأعقد، والأكثر غموضًا وسحرًا، إنها بين جنباتنا، ولا نكاد ندرك ماهيتها. القراءة عنها تجعلك تدرك روعة التنوع البشري المعجز، وما معين مثل كتب علم النفس والاجتماع لتغوص في أعماق التجربة الإنسانية.
وإذا أردت الإعجاز، فحدثني عن الروح، هل تعلم عنها شيئًا؟ من يعلم عن كنهها شيء! طالع الأديان، وطف بالبلدان، وسل الثقلان، فلن تصل إلا إلى حيث أعلمك الديان “قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا”.
يا صديقي أكررها على مسمعك مرة أخرى “إن المسافر/القارئ وغايته منفعة ذاتية يحققها، كالذي يستأثر بالطعام لنفسه والمجاعة تنهك قومه“.
لست أُمْلِي عليك أو على غيرك ما ينبغي فعله، فلستُ إلا مُقصرًا، ولكني من قومك الهلكى في زنزانة الوطن، وأناشدك الإحسان الجميل.
يا صديقي، إن السفر والقراءة هما الحياة الحقيقية، وهذه دعوتي إليك، وإلى أهل الأسفار، صرنا في حاجة إلى ما أسميه سفر الأفكار، فلست أرى وسيلةً أخرى للنجاة غيره…”.
وساد بيننا صمت…
-نُشر أولًا بموقع حياتك.





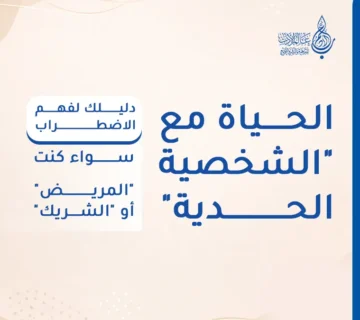

لا يوجد تعليق