بينما كان «فرويد» يراقب ردة فعل حفيده تجاه غياب أمه عنه إذ لاحظ أن الطفل يعاني قلقًا شديدًا ثم قام بالإمساك بكرة مربوطة بحبل مطاطي، وأمسك بالحبل وأخذ يلقي الكرة بعيدًا ويقول: (For/ ذهبت) ثم يجذبها إليه ويقول: (Da/ جاءت)، هدأ هذا السلوك من قلق الطفل، وكان فرويد مهتمًا باللاوعي، فاعتبر أن سبب هدوء الطفل هو توحّد الطفل بأمه، واحتفظ بشيء منها وهي هنا سلطتها عليه وتحكمها فيه، ووضع ذاته في الكرة، وكأن اللعبة كانت تعني هذا ما تفعله بي أمي! احتفظ بهذه القصة جانبًا فسنعود إليها فيما بعد.
إلى الشمال من فرويد، وعلى خطاه كان العالم الإنكليزي «باولبي» يضع كل اهتمامه في هذا الأمر، أهمية الارتباط بين الطفل ومقدّم الرعاية (الأم كمثال)، وتبعته «آينزورث» في أميركا بتجربتها الشهيرة (Strange Situation، أو موقف الغريب) لتكتشف أن توافر تعلق حقيقي وعميق بمقدم الرعاية منذ اللحظة الأولى للميلاد، وشعوره بالأمان في محيط التنشئة يعمل على بناء واحد من ثلاثة أنماط من الارتباط بين الطفل ومقدم الرعاية، وتمت إضافة نمط رابع في أول التسعينيات.
أفضل الحالات هي التعلق الآمن حيث يستطيع الطفل اللعب في حضور مقدم الرعاية، ويصيبه القلق والتوتر عند غيابه، ولكن يسهل تهدئته عند عودته، ويفضّل راعيه الأساسي على من سواه، ويعتبره قاعدة أساسية لاستكشاف البيئة فوجوده فارق في استمتاعه باللعب واطمئنانه لوجود شخص غريب. ويمثل هذا النمط من (65-70% من الأطفال)، ووجد أن البيئة التي نشأ فيها هذا الطفل يغلب على مقدم الرعاية الاهتمام باحتياجات الطفل، والانتباه لها والعمل على إشباعها.
بينما أسوأها هو النمط المتفكك/ المشوّش غير متوقع الاستجابة دائم القلق، ونسبته من (10-15%)، ووجد أن البيئة التي نشأ فيها هذا الطفل حدثت فيها إساءة فعلية للطفل، أو فقد جسيم أو أزمة كبيرة، وبينهما نمط المتجنب، والنمط المتردد.
وتعتمد تهدئة قلق الانفصال على ثقة الطفل في العالم، واستقباله كمكان آمن، وثقته بآخرين خلاف مقدّم الرعاية، واطمئنانه إلى أنه لن يفقده بالكلية.
لكن قلق الانفصال لا يتعلق فقط بمرحلة الطفولة المبكّرة، بل يمتد لحياة المراهقة والنضج، والذي قد يكون من رواسب قلق الانفصال المبكّر وقد يكون بسبب آخر، فحين يجد الشخص من يثق فيه ويأمن لوجوده -وخاصة إذا كان مفتقدًا لذلك- فإنه يتخذ من ذلك الآخر مركزًا لأمانه ويبدأ قلق الانفصال بالظهور، وتظهر علاماته بوضوح في العلاقات الحميمية، وعلاقة الوالدين بأبنائهما، بل وبين الأصدقاء وبعضهم بعضًا، وفي ما يلي أشهر مظاهر قلق الانفصال في البالغين:
- الغيرة الزائدة:
وبالطبع لا تنبع كل أنواع الغيرة من قلق الانفصال، بل قد تكون علامة على رغبة التحكم والاستحواذ المجرّدة، لكنها قد تنبع أيضًا من خوف الفقد وقلق الانفصال.
- الوالدية المفرطة:
حيث نجد الأم التي تتصل على ابنها كل ساعة للاطمئنان على سلامته، أو التي يصيبها القلق الواضح إذا تأخر قليلًا عن موعد عودته، وكذلك الآباء الذين يشترطون خطة مفصلة عن تحركات الأبناء.
- العلاقات الاعتمادية:
وقد سبق لنا الكلام في كثير من مقالاتنا عن الاعتمادية وأسبابها، وكما قلنا عن الغيرة، فبعض العلاقات الالتصاقية تنبع من خوف الفقد، فعدم سؤال طرف عن الآخر لفترة ليست بالطويلة تصيب الطرف الآخر بقلق ظاهر.
- والحل؟
– بالنسبة للأطفال
ينبغي تفهّم قلقهم واحتياجهم لمقدّم الرعاية وتقديم الحنان والاهتمام لهم، ويمكن تدريبهم على القليل من الانفصال بالغياب عن ناظرهم داخل المطبخ أو الحجرة وزيادة المدة تدريجيًا، مع شرح الخطوات لهم: «أعلم يا حبيبتي أنك تحتاجينني بجوارك، لكن علي أن أطهو الطعام لك» «لا تقلق يا صغيري، سأغيب قليلًا وسأعود» ثم تنبيههم عند العودة: «أنا عدت».
ويفضل القيام بالفترات الأطول بعد تناول الطعام حيث يميلون للقلق في ساعات الجوع والتعب بشكل أقوى.
– بالنسبة للكبار
فبالرغم من أن بعض الحالات قد تستدعي مساعدة متخصصة للتدخل بالعلاج المعرفي السلوكي والعلاج الجمعي المساند، إلا أن بداية الحل تكمن في الاعتراف بوجود مشكلة، والعمل على قبول حقيقة الفقد، وأن خوف فقدان الشيء/ الشخص يفسد الاستمتاع بوجوده، والتدرب على جلسات الاسترخاء والتأمل ومحاولة تهدئة أنفسنا بأنفسنا، والتوقف عن السلوكيات القهرية المصاحبة كمحاولة الاتصال القهرية.
وهنا نرجع إلى حفيد فرويد، فاتصاله بأمه التي يحملها داخله ساعده على خفض قلق الانفصال، فقد كان يحملها ليس فقط في وعيه بل لا وعيه أيضًا، فإننا حين نحب بحق نحمل شيئًا من أحبابنا داخلنا، شيء أبعد من مجرّد وجودهم الذاتي، نحن نحملهم حيث لا فراق، حيث يمكننا دومًا أن نتواصل مع أحبتنا الساكنين فينا، الباقين ببقائنا.
– نُشر أولًا بموقع صحتك.


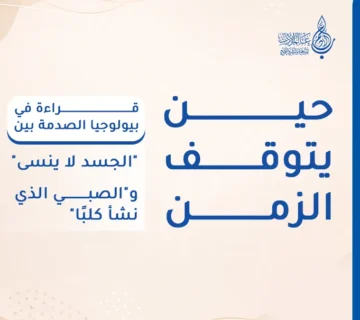
لا يوجد تعليق