((الإسلامي هو: كل مَن يرفض الفصل بينَ السلطةِ الدينية وسلطةِ الدولة، ويسعى إلى إقامة شكلٍ من أشكال الدولة الإسلامية، أو على الأقل يدعو إلى الاعتراف بالشريعة كأساس للتشريع))
تقرير راند 2007.
(1)
لا أملك أي نوع من الحساسية التي توجد عند بعض الناس من استعمال مصطلح الإسلامي، وعلى الرغم من وعيي بالإشكاليات الواقعية الناتجة عن الفصل بين فئة من المسلمين وباقي المسلمين عن طريق هذا الاسم= فأنا لا أرفض بقاء هذا اللقب؛ لأنه كما يميز فئةً من المسلمين بحضورِ هَمٍّ واشتغالٍ مخصوص، فهو يميزهم أيضًا بحضور أنواعٍ مخصوصة من العيبِ والنقصِ والخللِ، والصرامةُ العلمية لا ينبغي أن تتحسس من استعمال المصطلحات متى وُجدت الحاجة المعرفية والمنهجية لها، وطالما وُجد الوعي بتحيزاتِ المصطلحِ وظلالِه؛ التي قد تؤثر على فهم الظواهر والتعامل معها.
في تراثنا استُعمل لفظُ الإسلاميين مرادفًا للفظ المسلمين، لكنه في العصر الحديث، وعقبَ نشوء الوعي بمفارقة الحقبة التاريخية الحديثة لما قبلها، وعقبَ نشوء التيارات والحركات الإسلامية التي تواجه أثرَ البتر الاستعماري للجسد الإسلامي، ومظاهرَ الاغتيال العلماني لنُظُمِ الحكم والسياسة والثقافة الإسلامية= صار يُستعمل للدلالة على طائفة من المسلمين اختُصَّت بخوضِ هذه الحرب الدائرة، ورفعِ راية استعادة سلطان الوحي، وحُملِ همِّ مواجهة آثار الاستعمار وخلفائه، والعلمانية ومظاهرها، وذلك في مقابل عموم المسلمين؛ الذين تنوعت تصنيفاتهم بين؛ من استَلَبَتْه العلمانيةُ فصار جزءًا من جيشها بعلمٍ أو تأويلٍ أو جهل، ومَن لا يَحضُر لديه القدرُ الكافي من الوعي، أو القدر الكافي من الهم، للاشتغال بهذه الحرب الدائرة، فهو منصرفٌ إلى شأنه؛ وهو الشأن الذي يتنوع بين انغماسٍ في الدنيا، أو طلبٍ للدين عبر شُعَبٍ للإيمان ليست تلك الحرب جزءًا منها إلا من ناحية إجمالية.
يُشكل الإسلاميون في معظم المجتمعات العربية والإسلامية نسبةً تتراوح بين ثلاثةٍ إلى عشرةٍ بالمائة، فيما يشكل باقي المسلمين -على اختلاف تصنيفاتهم- باقي تلك المجتمعات، بعد استبعاد الأقليات الدينية، والتي تختفي في بعض تلك البلاد وتزيد في أخرى حتى تصل إلى نسبةٍ تعادل نسبةَ الإسلاميين، كما هو الحال في مصر مثلًا.
(2)
يمكن تلخيص معالم السياسة التي تَعامَل بها الإسلاميون مع مجتمعاتهم في ثلاث نقاط:
الأولى: الثناء الأيديولوجي؛ الذي يتم استعماله إعلاميًا وفي أزمنة الحشد، باعتبار الشعب “متدينًا بطبعه”، وأن الشعوبَ محبةٌ للخير، وأنهم يُبجِّلون المتدينين، وأن الشعوب صارت واعية، وأنها لن يضحكَ عليها أحدٌ بعدَ اليوم.
الثانية: الذم الاحتقاري؛ والذي يتم استعماله في أزمنة الأزمات، وذلك بالإشارة إلى أن الشعوب جاهلة، ومغيبة، وأن عقائدها فاسدة، وأنهم لا يرفعون بالدين رأسًا، وأنهم جماداتٌ لا خيرَ فيها، وبهائمُ تركبها السلطة، وقد يتطور ذلك لاستعمال عباراتٍ تكفيريةٍ بقصد التكفير أحيانًا، وبمجرد الإطلاق الخطابي غير الواعي للوازم العَقَدية أحيانًا.
الثالثة: وهي الحالة الثابتة التي لا تغيب وقت الثناء ولا تختفي وقت الذم، أعني: التعامل مع المجتمعات المسلمة باعتبارها غابة الصيد التي ينبغي أن تخوضها نُخَب الإسلاميين؛ لتعود منها بالغنائم التي تُزيد من عدد التيار الإسلامي الذي أطلق فرقة الصيد، وبالتالي تُزيد من نفوذه المجتمعي، أو قوته السياسية، مع عدم غياب الدوافع الدينية والدعوية لإخراج الناس من الظلمات إلى النور أيضًا.
يستعمل السلفيون مصطلح “أخ” و”مسجد إخوة” للدلالة على تجمعاتهم في مقابل تجمعات ومساجد عامة الناس، ويشيع بدرجةٍ ما بينهم شعورٌ من الهشاشةِ ودوافع المحبة والسلام عند رؤية الملتحي أو المنتقبة، في مقابل حالة من الجمود والسكون عند رؤية عامة الناس.
والإخوان المسلمون -لطبيعتهم التنظيمية- يمارسون انفصالًا أشد حدة، وروابطهم الاجتماعية أشبه بالمجتمعات المغلقة، لا تكاد تنفتح على ما بخارجها إلا لدوافع مصلحية، ووفق حسابٍ دقيق لدرجة الانفتاح وغاياته وذرائعه وصُوره.
ووفق تتبعي فإن ممارسة التبليغ والدعوة فيها مزجٌ بين الطريقتين، لكنّ انفتاحَ خطابهم الدعويّ على فئات المجتمع، وتواري كثيرٍ من مظاهر نشاطهم التنظيمي، مع تخفيضهم الاختياري لسقف مطالبهم من المجتمع= يخفي طبيعتهم الانفصالية التي لا تختلف كثيرا عن السلفيين والإخوان.
(3)
الواقع أن المجتمعات الإسلامية شديدةُ التنوع والثراء، وهو شيءٌ استلزمته طبيعة الأعداد الغفيرة، مع طبيعة التنوع الثقافي، وتعدد الظروف التاريخية والجغرافية، ولأجل ذلك تشيع فيهم الظواهر بصورة تكفي لاستخراج تعميماتٍ بالثناء، وتعميماتٍ بالذم، ولا إشكال في هذا؛ فإن التعميم -بناءً على شيوع الظواهر- منهجٌ علميٌّ سليم شريطة أن يكون المعمِّم لا يزعُم الاستغراق، وأن يكونَ واعيًا بأنه يعمِّم بناءً على ظاهرةٍ توجد في مقابلها عدة ظواهر يمكن التعميم على وفقها أيضًا، وهذا الوعي بوجود الظواهر المختلفة والمتقابلة، وبوجود الثراء والتنوع في تركيبة المجتمعات المسلمة= هو ما تغيب آثاره في طرح كثير من الإسلاميين وفي خطابهم الدعوي والإعلامي والسياسي وحتى الديني.
التيار الإسلامي -بصفة عامة- تعامل مع مجتمعه بمنطق الأقلية التي تحاول أن تصطاد من المجتمع؛ لتزيد في عددها وجندها في مقابل منافسيها: سواء من الدولة أو التيارات غير الإسلاميَّة، أو حتى التيارات الإسلاميَّة التي تصارعها على مناطق النفوذ، واقترن هذا بإحساسٍ -غير معلَن- بالنقاوة والتميز على المجتمع؛ وهي نقاوةٌ دخلت عليهم من الإحساس بالتميز المعرفي كونهم واعين بأزمات أمتهم وتحدياتها، ومن الإحساس بالتميز الإيماني جرّاء استقامتهم والتزامهم الظاهر في مقابل نقصٍ وتقصيرٍ ظاهرَين في مختلف الشرائح المجتمعيَّة. وصار منطق دعوتهم هو أن يصطادوا رجلًا من أرض الظلمات ليدخلوه أرض النور.
والخلل الأساس في هذا التصور: أنه يتغافل تمامًا عن أن هذه المجتمعات مجتمعات مسلمة، وتعميمها بحكم يجعلها كلها في مقابل الشريحة الإسلاميَّة تقابل الهدى والضلال = خطأ كبير، والحقيقة أن في المجتمعات المسلمة شرائحَ غفيرةَ العدد هي أحسن دينًا وإيمانًا من كثير من الإسلاميين، وخُلوُّها من بعض الشعائر الظاهرة أو عدم اشتغالها بالمعركة التي يخوضها الإسلاميون لا يعيبها، فإن الدين شُعَب، والخير والشر يُوزنانِ بميزانٍ يستحضر جميعَ شُعبِ الإيمان، ولا يعتبر بعضها ويهدر أخرى.
إنَّ متوسط عدد الإسلاميين في معظم المجتمعات لا يكاد يبلغ العُشر، وإن الذي لا ينبغي أن يُشك فيه أن معظم المجتمعات لا تخلو من نسبة تزيد على هذه النسبة، ليسوا من الإسلاميين من حيث الهدي الظاهر أو الارتباط المجتمعي، لكن لهم من شعب الدين والإيمان وإرادة الله والرسول ما لا يقل عن معظم الإسلاميين -إن لـم يزد-، ويبقى معظم الناس على درجاتٍ من الخير والشر، والوعي والاستلاب، والتدين وضعفه= تزيد وتنقص.
(4)
كلا التيارين الكبيرَين -السَّلفيِّين والإخوان- أرادوا التعامل مع المجتمع بمنطق الصياد والفريسة، وتحولت الدعوة من كونها وسيلة أساسيَّة لرفع التدين المجتمعي، وتحسين نسيج الأمم = حتى أصبحت آلةَ صيدٍ هدفها أن تُكثر سوادَ أحزابٍ مفترقة.
واختلفت سياسات السَّلفيِّين عن الإخوان؛ فالإخوان يريدون جنديًّا نظاميًّا، فتوسعوا في قبول الناس بدون تشديدٍ في الفرز على أسس ترتبط بالهدي الظاهر، وقاموا بعد ذلك بتربية هؤلاء المدعوين داخلَ أُسرهم التنظيمية، بما يؤهلهم لخوض الصراعات السياسيَّة التي سيختارها لهم مكتب الإرشاد بعد ذلك.
أما السَّلفيُّون فاعتنوا بالفرز على معايير الهدي الظاهر، وتشددت فيها على مسائلَ كانت أهون من أن يتم الفرز على أساسها، مع قلة عنايةٍ بعد ذلك بمتابعة هؤلاء الأفراد -اللهم إلا في السَّلفيَّة التنظيمية، وبدرجة أقل من الإخوان.
اشترطت ثقيفُ على رسول الله ﷺ أنْ لا صدقة عليها، ولا جهاد، فبايعهم النَّبي ﷺ وقال: «سيصَّدَّقُونَ ويجاهدون إذا أسلموا».
وأتى رجل إلى النَّبي ﷺ فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين، فقبل ذلك منه.
وكان النَّبي ﷺ يقبل إسلام من لـم يسلم إلا لأجل الدنيا، ويخبر أنس عن هؤلاء فيقول: ((إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها)).
وهذا الباب كله يرجع إلى أصلٍ واحد: السكوت عن البلاغ أو تأخير الإلزام، وهذا من الأبواب التي وسّع الله فيها للنبي، ولخلفائه من الدعاة، والعلماء، والأمراء، تأليفًا لقلوب الخلق، وتمهيدًا لتمكن الإسلام في قلوبهم.
وإنَّ من أعظم مُحدَثات الدعوة إلى الله ،خاصة من السَّلفيِّين = رفع درجة النقاوة المطلوبة فيمن يدعونهم فلا يقبلون توبة الرجل -بمعنى دخوله فيهم، وعَدِّه من أصحابهم، وتسميتهم إياه ملتزمًا ونحوها- حتى يبلغَ درجةً من النقاوة ،في ظنهم، لا تقف فحسب على ترك الصغائر وأمور مختلَفٍ فيها، بل تتعدى حتى إلى أن يُطلب من المدعوِّ الالتزامُ بأمورٍ عُرفية حسْبُها أن تكونَ من جنس المباحات، فضلا عن أن تكون سننًا.
وهم يظنون هذا شيئًا حسنًا، بل ويترفَّعون به عن غيرهم من التيارات التي يتهمونها بالتمييع لأجل أنها لا تَفرز فرزهم هذا في قبول الناس.
(5)
إن التوسعَ في قبول الخير من الناس، وقبولِ توبة الرجل بمجرد عزمه عليها، وإظهارِه معالم السعي لها، ولو لـم يتخلص من كل ذنوبه، والسعي في تحسين نسيج المجتمعات المسلمة على ما هي عليه من تنوع، والفرحِ بزيادة نسب من يحب الدين والوحي، ويسعى للاعتصام به، ولو بقيَ على شيءٍ من المعاصي غلبه عليها هواه، والفرحِ بكون الناس مندرجة في الدين العام واستصلاحهم، وطَرق قلوبهم بالمعاشرة، وحسن الخلق في المخالطة، وترك بشاشة الإيمان تعمل عملها في القلوب، مع اليقين أن السابقين بالخيرات سيبقون هم الأقل في الأمة، ولن يكونوا غالبها، وليسوا هم رجال التيارات الإسلامية بالضرورة= كل ذلك أشبه بدعوة الأنبياء من مسالك الفرز والنقاوة ومقصلة الالتزام التي يظنها بعض السَّلفيِّين تصفية واجبة.
الدعوة المجتمعيَّة للناس ينبغي أن يكونَ مركزُها جُملَ الكِتَاب والسُّنَّة المنصوصة، والتي كان النَّبي ﷺ يعلمها الأعرابي ويبايع عليها الناس، ما وراء ذلك من المفاهيم والأفكار، والتفصيلات والاختيارات، والهموم والانشغالات = لا ينبغي أن تكون مركزًا للدعوة، وإنَّما يتنوع ذكرها بتنوع الأمكنة والأزمنة والأشخاص، وليست خطابًا عامًا للناس، ولستَ واسعًا كل الناس في مذهبك، لكن الإسلام يسعكم.
| والخطأ العظيم: هو جعل منظومة المفاهيم والأفكار – وإن كنتَ تعتقدُها الدينَ الحق، ومذهب السلف، وواجب الوقت، ومعركة الوعي= حقيبة دعوية، وتطلب أن يحفظها كل الناس. |
لذلك تجد الواحد من هؤلاء لا يستطيع ذكر القول حتى يقدِّم له بذكر خلافات أيديولوجية هي من أنتجت تلك الأقوال، فيُحمل الناس على تفاصيل لـم يكلفهم الله بها.
وتبقى أحوالُ الناس في أزماننا أحوجَ ما تكون إلى تدرج العفو والسكوت، ولين الجانب، واستصلاح الناس للدين كما يُستصلح المريض للحياة، وتوظيف العوامل النفسية في الدعوة، وعدم محاصرتهم بنصائح الفَرز والنقاوة، والنصح ببلاغ الأصول، ثم ترك ما بعدها يعتمل في نفوس المدعوين بالمخالطة والإحسان وصالح الأخلاق.
أقم دعوتك على أن الظالمين لأنفسهم كثرة، وأنهم -رغم ذلك- من المسلمين، وأن العاصي يضيق عطنه إن حاصرْتَه بذكر معاصيه، لا تُحل حرامًا، ولكن احتمِل واسكت وارفق، وتلمَّس للنصيحة خصب النفس وتهيؤها، ولا تُعِن الشيطان عليهم؛ فإنك إن لـم تَسَعْهم وتحتملهم، وتتصل بهم على حالهم كما هم، لا يقطعك عنهم بقاؤهم كما هم = فلست داعية.
الدعوة بنيّةِ القَطْعِ إن لـم يستقم= عِشرةٌ مخدوشة، ومودةٌ ناقصة، ونهجٌ دعوي مُحدث، دعك من معاييرك في الفرز والاستقامة وما فيها من خلل،
ولستَ بمستبقٍ أخًا لا تلمهُ *** على شعث؛ أي الرجال مهذبُ؟!
الداعيةُ لا يفرز الناس في الدنيا إلى أقسامهم في الآخرة، فمخبآت السرائر لا يعلمها إلا الله، وهو في سعي مستمر لا يرى فيه أنه أفضل من أحد.
الذوبان في الناس بمحكمات الوحي، ومواصلة طَرْق أبواب القلوب بلا أجل، والرضا من الناس بأقل بادرة استجابة، ومواصلة تنميتها واستصلاحها، ستبلغ بعملك وخلقك ما لا تبلغه ببيانك، وثمة معادن حسنة تواريها زحمة الحياة، اطلبها وانتفع بها، واحذر أن يفسدها معيارك في الفرز، صاحبِ الناسَ على علَّاتهم، وارفُق بهم، ولا تقطع قطُّ حبلَ الإسلام.
الدعوة المجتمعيَّة، وإصلاح دين الناس ووعيهم واستصلاحهم، وتحسين نسيجهم مع احترام اختياراتهم المشروعة في هموم حياتهم= خيارٌ ثابت، لا ينبغي أن تغيره الحوادث، ولا اختلافنا في تقييمها، ولا ينبغي أن يكون مركز خطابنا أن يكون الناس جميعًا مثلنا.


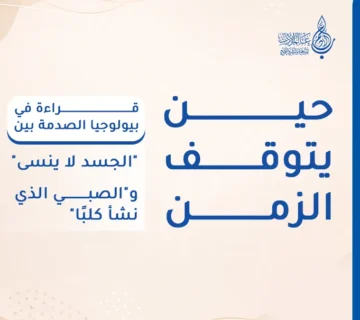
لا يوجد تعليق