للأستاذ جيمي بشاي
مدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
نشأت في أسرة متواضعة احترف أكثر أعضائها مهنة التدريس، فقد أمضى والدي زهاء أربعين عامًا في التعليم، كما اشتغلت والدتي بالتدريس فترة طويلة حتى أكثرت من إنجاب الأطفال وأصبح من العسير عليها الجمع بين المدرسة والمنزل فاستقالت من المدرسة، واكتفت بالإشراف على دراسة أبنائها فكانت –رحمها الله- مثلا أعلى للأم المتعلمة!
وعلى الرغم من هذا المحيط المدرسي الذي نشأنا فيه فإني لم أفكر مطلقًا في اتخاذ التدريس مهنة!… وأذكر أنني حينما كنت في المدرسة الابتدائية زارنا أحد المفتشين، وأراد أن يتلطف معنا في الحديث فراح يسأل كل واحد منا عن المهنة التي يفضلها ويسعى إليها عقب تخرجه في المدرسة وسر المفتش كثيرًا حينما علم أن أكثر الطلبة قد عقدوا العزم على دخول الجامعة، ولكنه عاد فتجهم حينما علم أن أحدًا منا لا يرغب في اتخاذ التدريس مهنته!… بل كانت الميول متجهة نحو الطب، والهندسة والمحاماة… وكنت أنا أحد الطلبة الذين عقدوا العزم على دخول الطب… ولا أذكر سببًا معقولًا لاختياري هذه المهنة سوى رغبتي الشديدة في حمل لقب دكتور!
ولكني اليوم أجد نفسي مدرسًا خلف وراءه خبرة أعوام طوال في ممارسة مهنة التدريس!… نعم، اتخذت هذه المهنة العظيمة راضيًا مختارًا، وكان في مقدوري أن أدخل كلية الطب، ولكني فضلت كلية الآداب كي أصبح مدرسًا، وأنا سعيد كل السعادة بهذا الاختيار الموفق، وأزيد القول بأنني لن أرضى بغير التدريس بديلًا!
ولا أذكر بالتحديد كيف حدث هذا التغير المفاجئ في حياتي، وكل ما أذكره هو أنني أثناء دراستي بالمدرسة الثانوية كنت أعجب للجهد الذي يبذله أحد الأساتذة في إثارة اهتمامي، فكان لا يبخل على بوقته خارج ساعات التدريس يسألني ويناقشني ويشجعني على البحث والابتكار وأصبح هذا الأستاذ مثلي الأعلى فقررت أن أتخذ التدريس مهنة.
وشاءت الأقدار أن أوفق في تحقيق أمنيتي، فحصلت على عمل كمدرس في كلية الأمة العربية بالقدس حال تخرجي في الجامعة… وكانت نصيحة أحد المدرسين القدامى لي قبل دخولي أول حصة هي أن المدرس الناجح يجب أن يرهب طلابه ويشعرهم بقسوته وجبروته، وفهمت منه أنه يعزو نجاحه في التدريس إلى تقمصه شخصية الحجاج بن يوسف الثقفي حينما ولي حاكمًا على شعب العراق، فهو قد أحل في روع طلابه أنه هو أيضًا (ابن جلا وطلاع الثنايا…)!
وفكرت في اتباع نصيحة زميلي المحنك، وأعددت مقدمة ملتهبة تفيض بألفاظ القسوة والصرامة، واعتدلت في وقفتي، ورحت أدق الأرض بقدمي قبيل دخولي الفصل لأتدرب على شخصية المدرس الحازم!…
ولكنني ما إن دخلت الفصل حتى نسيت كل شيء… نسيت نصيحة صاحبي، ونسيت خطاب الحجاج بن يوسف، فقد وجدت أمامي وجوها تشع بهجة ورضاء، وعيونا شاخصة إلي في شغف واهتمام، وشعرت بأني أحب هؤلاء الطلاب، وأن في مقدوري أن أعلمهم وأساعد كلا منهم على أن يصبح فردًا نافعًا في المجتمع.
وهكذا علمتني التجربة أن خير وسيلة يمكن أن يستخدمها المدرس لحمل طلابه إلا إذا أحب مهنته وأخلص لها.
وحب المهنة ينبثق من إيمان الفرد برسالته إيمانًا راسخًا لا تزعزعه قلة المرتب، أو جفاء الطلاب، أو إجحاف الناس. وتكاد مهنة التدريس تكون من أسمى المهن وأعلاها شأنًا وأرفعها مقامًا. فالمدرسة قلب المجتمع النابض، ورسالة المدرس هي رسالة الحياة.
ولكل مهنة منغصات… ومهنة التدريس لا تخلو من هذه المنغصات تظهر في شكل أصبح يعرف باسم (مضايقات الطلبة) ولعل هذه المنغصات هي التي تدفع ببعض المدرسين إلى اتباع نصيحة زميلي صاحب الحجاج بن يوسف الثقفي!
وأذكر أنني في أول عهدي بالتدريس دخلت فصلًا، فإذا هو غاية في السكون والهدوء على غير العادة، ورأيت الطلبة جامدين في أماكنهم وكأن على رؤوسهم الطير، وعلمت أنهم قد دبروا مكيدة ما!… وكان على أن أدرس مادة الإنشاء باللغة الإنجليزية، وبدأت بكتابة رأي الموضوع على السبورة… وبعد لحظات سمعت الطلبة يتصايحون وانفجر السكون المخيف إلى هرج ومرج… وانكشفت المكيدة عن ثعبان خبأه أحد الطلبة في درج زميلة… ولما كنت أعلم أن أكثر الثعابين في هذه المنطقة غير سامة- وكان هذا أثناء قيامي بالتدريس في العراق- فإني لم أرتعد خوفًا، بل اشتركت مع الطلبة في إلقاء القبض على الثعبان المسكين الذي كان يناضل في سبيل بقائه أمام خمسة وثلاثين طالبًا، ومدرس… وانتهت المعركة بفوزنا على الثعبان، وقررت بمناسبة هذا الحادث أن أغير رأس الموضوع الذي كنت قد كتبته وكان عن (الشمس) واخترت بدلا منه موضوع (الثعابين)… وكانت حماسة الطلاب على المنافسة والكتابة في هذا الموضوع بحيث أنستني أثر المكيدة!
وهكذا ترى أن المدرس يستطيع أن يحول منغصات المهنة إلى مغانم، وأن في مقدوره أن يستغل نشاط الطلبة في أعمال مجدية تعود عليهم بالخير، وكل ما يحتاج إليه في تصريف أموره هو اللباقة والابتكار… ولعل مهنة التدريس من أكثر المهن حاجة إلى هاتين الصفتين…
وأحب مهنة التدريس لأنها تجعلني أطبق مبدأ (اطلب العلم من المهد إلى اللحد). فالمدرس يعيش في مجتمع زاخر بالحياة والمعرفة، وهو يمضي زهرة العمر في طلب العلم، يأتي إليه الفتى الصغير فيتعهده في المدرسة حتى يشب ويخرج إلى معترك الحياة ليحتل مكانًا في المجتمع… أما هو فيعكف على قراءة كراساته ومطالعة كتبه، وتحضير دروسه، ومثل هذه الحياة تزيده ثقافة وتضفى عليه الثقة والاعتداد بالنفس التي قلما تتوفر في المهن الأخرى…
والمدرس ينمو فكريًا لا من سنة إلى أخرى، بل من محاضرة إلى أخرى، فهو حلقة مهمة في سلسلة الجهاد العلمي الذي بدأه أساتذته من قبل، وسوف يكمله طلابه من بعد.
وأحب مهنة التدريس لأنها تجمع بين الزعامة الرشيدة والتعاون الصادق. فالمدرس زعيم في مدرسته. وهو سيد مطاع إذا ما تعاون مع طلابه وأخلص في أداء رسالة العلم… هذه الزعامة تفرضها عليه مهنته لأنه ينقل العلم إلى عقول أبناء الجيل، وقادة المستقبل… ولكن عملية النقل هذه لا تتم إلا في جو صالح مشبع بروح التعاون والزمالة، لدى المجتمع النواة الصالحة للحضارة والرقي.
-نُشر أولًا بموقع حياتك.





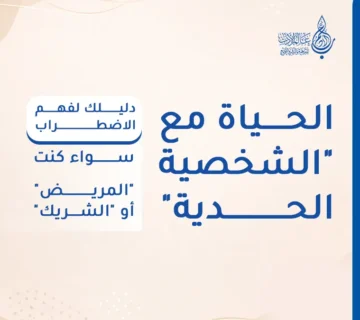

لا يوجد تعليق