للسيدة صوفي عبد الله
للكرنفال أو المساخر عند الغربيين مواسم وأعياد، يتفنن خلالها كل واحد وواحدة في اتخاذ أغرب الأشكال، وأعجب أنواع الثياب، بقصد إثارة الضحك والمرح والتنفيس عن النفس من الضغط الشديد المستمر لحياة الجد والرزانة والوقار.
ونحن أيضًا عندنا في شرقنا هذه الأيام كرنفال، ولكن موسمه مستمر على الأيام… وهو كرنفال مضحك، وإن لم يكن ضاحكًا، لأنه يثير ضحكًا كالبكاء ضحك الرثاء والإشفاق والمرارة، وما أشد اختلاف هذا الضحك عن انطلاقة المرح!
لقد اجتمعت في شرقنا تيارات شتى من أفكار موروثة عتيقة، وأفكار طارئة حديثة، فأصبح الشخص منا عصريًّا جدًّا بأدوات مواصلاته، وبارتياده دور السينما وسماعه (الراديو) وركوبه الطائرة، وحتى أدمغتنا صارت عصرية بقراءة الصحف ونور العلم، وصارت مشكلات العالم، وموضوعات الذرة من مشاغلنا الذهنية ومع ذلك نجد هذا الشخص نفسه يعيش بقلبه وعواطفه، وعلاقاته العائلية، وتصوراته الجنسية في واد آخر في واد متأخر عن عصرنا بقرون وقرون!
وما أشبه إنسان هذا حاله بمن يرتدي فوق رأسه القبعة العالية، وفوق جسده الجلباب، أما قدماه ففي أحدهما حذاء إيطالي وفي الآخر قبقاب!
***
وليست الفتاة أحسن حالًا في هذا الكرنفال من أخيها الفتى…
الفتاة الشرقية دخلت المدرسة واقتحمت الجامعة والوظائف العامة، وهي بزيها وزينتها عصرية من آخر طراز، وبمعلوماتها المتقدمة لا تفوتها آخر الآراء في السياسة، والعلم والاجتماع، ولكن عقليتها كما تتجلى في سلوكاه الاجتماعي، وعلاقتها العائلية، ونظرتها وموقفها من مسائل العاطفة والجنس، فإنها للأسف الشديد لم تزل تتعثر في أذيال الحجاب العتيق، وتعيش في جو الحريم المغلق!
فكأنما الفتاة بهذه الصورة نموذج آخر من الكرنفال ترتدي أحدث قبعات باريس، وآخر مبتكرات الحُلي في الأذنين والجيد ومع هذا ترتدي البردة تغطي بها عينيها وسائر جسدها -وإن لم يفتها أن تلبس من تحتها بنطلونات الوجوديين!- وفي ساقيها خلخال، وأخشى أنها تسير حافية أيضًا على طريقة الراقصات في قصور آل عثمان!
إن التناسق المعقول ينقص جوانب حياتنا العقلية والاجتماعية والأخلاقية. فنحن نقتني في أدمغتنا مبادئ العصر الحديث، ثم نبقيها محبوسة في عقولنا ونستوحي لأفعالنا وصلاتنا الاجتماعية والإنسانية مبادئ أخرى نقيض المبادئ الأولى: مبادئ متخلفة عن عصور نعلم جيدًا أنها مظلمة.
ولن يكون لنا كيان سليم ما لم يتم التكامل بين أفعالنا وأفكارنا، بين قلوبنا وعقولنا، ولن يتم ذلك إلا بكفاح تسوده الشجاعة الكاملة في مواجهة الخرافات، لأن هذه الحفريات العتيقة تتشبث بالحياة ولا تتورع عن أي سلاح لتأخير قافلة التقدم الإنساني نحو عالم يسوده نور العقل، وصدق الإحساس ومنطق الحياة والتجديد.
***
ونفتح اليوم الباب على أسرة صغيرة من أوساط الناس تقطن بيتًا صغيرًا في إحدى ضواحي الإسكندرية…
وسنجد موجة العصر الحديث غمرت في زحفها تلك الأسرة المحافظة. فالبنت ذهبت إلى المدرسة التي لم تعرف أمها في زمنها طريقها إليها، وتخرجت البنت في مدرسة متوسطة تجمع بين حظ من الثقافة، وإلمام بتدبير المنزل، لأن هذا اللون من التعليم النسوي يحفظ على الرجل المحافظ -رب الأسرة- ماء وجهه. فمن الممكن أن يقال إن ابنته دخلت المعهد النسوي؛ لتكون ربة بيت، لا لتتوظف.
فلما تخرجت في المعهد وانقضى الأمر، شجعته موجة العصر الزاحفة على توظفها فقد شاع توظف الفتيات ولم يعد ذلك أمرًا منتقدًا.
إذن تدخلت ظروف العصر فوضعت فتاة هذا البيت في وضع مساوٍ تمامًا لوضع فتى البيت، فهي متعلمة، موظفة، كادحة، كاسبة.
ولكن، هل وراء هذا المظهر العصري الجميل السار تكمن حقيقة جميلة سارة عصرية حقًّا؟
للأسف الشديد كلَّا! أقولها بملء فمي، وأكتبها بالخط العريض!
إن (موجة) العصر الزاحفة غمرت هذا البيت، ولكن (روح) العصر لم تستطع أن تحتل المواقع التي غمرتها موجته!
إن هذا البيت الذي تخرجت ابنته في المدرسة كأحدث بنات الغرب، وتوظفت كما تتوظف أحدث فتيات الغرب، لم يزل هذا البيت يعيش بروح الحريم، وبعقلية الحريم، برغم الكهرباء، والراديو، والوجه السافر، والبوتاجاز!
رجل هذا البيت لم يزل يعتبر نفسه حاكمًا مطلقًا! الغرور الأحمق، والكبرياء الاستبدادي اسمهما عنده كرامة وتصون!
إنه يتصور ابنته المتعلمة الموظفة نسخة أخرى من زوجته الأمية حبيسة الدار وينتظر من الزمن أن يكون زواج هذه الابنة بالطريقة نفسها التي تزوجت بها أمها من قبل. فهذا الرجل يتقبل من الزمن هداياه وخيراته في صورة ترف علمي، ومبتكرات في المعيشة والعمل، وتعليم، وارتفاع في المستوى الاقتصادي، ولا يفكر أن يرفض شيئًا من ذلك ولكنه لا يستطيع أن يفهم أن ذلك الخير الذي يتقبله ليس إلا جزءًا من كل لا يتجزأ، وهذا الكل هو روح العصر، وعقليته، وذوقه، ومزاجه.
ومن عجب أن جهل الرجل بالحقيقة الكامنة وراء واقع عصره ومظاهره، سمح له أن يظل متشبثًا، تحت هذه المظاهر كلها، بحقيقة اجتماعية عفى عليها الزمن. فاعتقد أن البنت التي تعلمت وتوظفت لم تستيقظ في أعماقها الحاسة الشخصية التي تشعرها باستقلال كيانها، وحقوقها في أن تحيا حياتها كما تفهمها وتريدها، مثل الفتى تمامًا! فلها قلب كقلبه، وآمال كآماله، وكرامة إنسانية ككرامته، وأشواق ورغبات كأشواقه ورغباته، لا بد أن تجد شبعها في الحياة، وإلا ظللت التعاسة بأجنحتها السوداء عمرها كله!
جهل الأب ذلك جميعه، وظن أن الأنثى في بيته لا قلب لها إلا قلبه هو، ولا إرادة لها إلا إرادته هو. فحياتها العاطفية شيء مستحيل أو معدوم، ولا وجود للأنثى إلا كظل لوجوده الشخصي لا يمكن أن تهفو إلى رجل، ولكن عليها أن تلبي بلا تردد متى أشار بيده إلى رجل، أي رجل يختاره وقال لها:
– كوني لهذا الرجل متاعًا، انتقلي لملك يمينه ليولدك ما شاء من البنين!
لو لم تكن هذه مأساة فاجعة لكانت حرية أن تكون مهزلة رائعة!
ولست أتصور هذا المخلوق البشري العجيب بتكوينه هذا المتناقض السخيف إلا أن يكون شخصًا رقيعًا. وليس يقدح في ذلك أن يكون له من مظاهر الرجولة شارب مفتول أو معقوف، وجهامة بادية، وتزمت ظاهر. فإن أسوأ أنواع الرقاعة هي الرقاعة العقلية حيث يكون الانقسام الفاضح بين مجالين متجاورين أو متكاملين من مجالات السلوك في الحياة!
وأقول الانقسام الفاضح مقترن بالتبجح والاستهتار بالقيم الرفيعة التي لا يغتفر لكائن بشري أن يدوسها أو يتجاهلها، وأي قيمة بشرية يمكن أن تكون أقدس من عرض ابنته؟!
نعم من عرض ابنته، ولا أقول كلمة أخرى! فأول واجباتنا أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية، وما كان للرائد أن يكذب أهله.. فعرض ابنته هو الذي يتعرض لانتهاك لا ريب فيه حين يجبرها أو يكرهها على معاشرة رجل لا تعرف عنه شيئًا، ولا تشعر نحوه بميل أو احترام فضلًا عن شوق أو حب! ولا يشفع له أن يرتكب هذا الرجس تحت ستار مستعار من أقدس نظام عرفته البشرية، وهو نظام الزواج!
لقد اجتمعت نواميس الخالق على وجوب رضاء الطرفين رضاء صادقًا عند الارتباط بعقدة الزوجية، أما أن تكون المعاشرة الزوجية خضوعًا جسديًّا لا تشارك فيه دخيلة النفس، فذلك هو الغش المفسد لطبيعة الزواج إفسادًا يقلبه إلى صلة خسيسة غاية في الخسة، لم تعرف البشرية أقبح منها، ولا أخرى لبنينها وبناتها منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا!
***
ولأكونن مقصرة في حق إنسانية المرأة الحديثة تقصيرًا يصل إلى الإجرام لأنه اشتراك في جريمة النزول بها عن المستوى الأخلاقي لبني الإنسان، لو أنني برأت ساحتها من الملام في هذا الموقف، ووضعت الوزر كله على الوازر الأول منذ القدم وهو الرجل!
فعليها هي أن تقف دون عرضها وكرامتها وقفة الحرة الكريمة بأي شكل وبأي ثمن. وما لم تثبت قدرتها على تلك الوقفة البطولية، فلن تثبت جدارتها بالمكان الذي تدعيه تحت الشمس على قدم المساواة في القيمة الإنسانية مع الرجل، فالخضوع السلبي في أقدس ما يمس عفتها وعزتها هو الدليل الدامغ على عدم جدارتها بالكرامة والعزة!
يجب أن يكون ذلك مفهومًا لدى كل فتاة عصرية، فالمعركة معركتها أولًا وقبل كل شيء. ويجب أن تخوضها بلا توقف وبلا هوادة ولن تستطيع ذلك إلا إذا آمنت أولًا، بينها وبين نفسها بحقها الأخلاقي في الحياة النظيفة فشجاعة الإيمان هي السلاح الأول والأعظم في معركتها. وهذا الإيمان هو الذي سيمكنها من عدم الإغضاء أو النكوص إذا اتهموها بالتبجح، وعدم الحياء، والخروج على المفهوم العتيق الرجعي للخفر والعفة. فإن هؤلاء الرجعيين والرجعيات يظنون العفة هي القبول السلبي للرجل الذي يفرضه الأهل، لأنه ليس للفتاة تفضيل خاص لرجل على رجل…
ولكن الخفر والعفة بريئان من هذا التصور الجاهلي الذي يجعل المرأة بالبهيمة أشبه!
-نُشر أولًا بموقع حياتك.





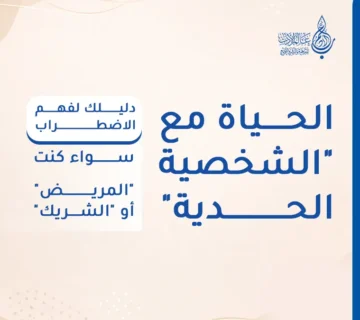

لا يوجد تعليق