﴿قُل إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وَما بَطَنَ وَالإِثمَ وَالبَغيَ بِغَيرِ الحَقِّ وَأَن تُشرِكوا بِاللَّهِ ما لَم يُنَزِّل بِهِ سُلطانًا وَأَن تَقولوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعلَمونَ﴾
[الأعراف: ٣٣].
(1)
الدينُ فيه جانب هو علاقة روحية، وهو من هذا الجانب صلة مفتوحة بين العبد وربه، لا تحتاج إلى وسائط، بل قد يكون إدخال الوسائط فيها بدعة أو شركًا.
ومن جانب آخر هو منظومة معرفية تقوم على نصوص ومناهج تأويل، وهو من هذا الجانب كغيره من المعارف والعلوم لا يصح أن يقول فيها فيعتبر قوله قولًا علميًا إلا من كان مؤهلًا ممتلكًا لأدواته.
وهذه المنظومة المعرفية من الممكن أن نطلق عليها اسمًا عامًا هو الفقه، وهنا يكون الفقه: هو طريق الدين كله.
ليس هو المعرفة التقنية بالعلم الخاص بالأحكام العملية، الفقه هو تفسير الوحي، باستعمال أدوات هذا التفسير التقنية.
وفيما يتعلق بتعيين الرؤية الكونية، والحلال والحرام، والقيم والأخلاق، فقهُ الدين والوحي وتفسير نصوصه هو مجال السعي، ووسيلة المعرفة، وهو المنطق الذي يتوسل باستعماله لاستخراج الأحكام والتصورات.
وهذا الأصل هو فصل ما بين الدين والفلسفة التي هي نزعُ المًقدَّس عن هذه الأبواب، وهو فصل ما بين الدين والكلام الذي هو محاولة خلطٍ فاسد بين الوحي وأدواته، ومنطقه بمنطق الفلسفة وأدواتها ومفاهيمها، دون جعل السيادة مرجعيًا للفلسفة.
وأيَّةُ محاولةٍ للعبث بهذا الأصل أنظرُ لها بارتياب شديد جدًا، خاصة إذا صدرت ممن لا تؤهله أدواته ليكون فقيهًا، ثم هو في الوقت نفسه يريد أن يَغصِبَ الفقهاءَ وظائفَهم؛ ليقول في الدين والشرع والناس برأيه ما شاء.
وقد تكرر هذا العبث في التاريخ كثيرًا من بعض المعتزلة، والفلاسفة، والصوفية، وهو اليوم يُلبس ثوب الفكر، أو الأدب، أو الوعظ، أو الثقافة، أو ما شاء العابث، وكله في الخطأ والخطر سواء.
ومن القضايا المهمة التي يُعِينُ فهمها على إنزالِ الناس منازلَهم، وعلى الانتفاع بالمواهب والكفاءات في الأمة، وعلى البصر أيضًا بمواطن الفساد التي تدخل على الأمة: قضيةُ الفرق بين الفقهاء وغيرهم.
والفقهاء هنا: هم كلُّ من له أهليةُ الاجتهاد والفتوى العامة في الدين، فيَخرُج: طلابُ العلم، والمجتهدون الجزئيون، ويَخرُج المتخصصون في علم من العلوم دون أن يستوفوا أهلية الاجتهاد العامة، بما فيهم فقهاء المذاهب المقلدون، فليسوا هم المقصودين بالفقهاء هنا.
وبالتالي قد يكون الفقيه مفسِّرًا، أو محدثًا، أو أصوليًا، لكنه مع ذلك ممتلكٌ لأدوات الاجتهاد العامة، وليس مجرد عالمٍ متخصص يُحسن شرحَ تخصصه، ولا يحسن النظر في جملة الشرع ومسائله.
ومن أمثلتهم: أئمةُ الصحابة والتابعين وأتباعهم، والأئمة الأربعة، ومثل: ابن عبد البر، والبيهقي، وابن حزم، وابن قدامة، وشيخ الإسلام، والسبكي، وأحمد شاكر، والأمين الشنقيطي، والمعلمي اليماني، وأناس دون هؤلاء لكنهم في نفس حزام أهلية التفقه العام.
والمراد بغيرهم شريحة واسعة جدًا، تبدأ من عامة الناس، وتنتهي بالمتخصِّص المبرز في علم -مثلًا- لكنه لا يمتلك باقي أدوات الاجتهاد، مرورًا بالخطباء والقُصَّاص، والأدباء والشعراء، والدعاة والمفكرين، والمتخصصين في العلوم الطبيعية والإنسانية، ونحو ذلك.
تنبيه: قد يكون الفقيهُ بالمعنى العام موهوبًا في واحدة من هذه، وليس هذا مرادًا هاهنا، كأن يكون الفقيه خطيبًا، أو شاعرًا، أو أديبًا، أو مفكرًا، أو داعية.
الفكرةُ الأساسُ هنا:
أنه لا يجوز لهؤلاء -غير الفقهاء- الاستقلالُ بتفسير الوحي، أو تحرير كلام أهل العلم، أو إنشاء النظريات والأصول والقواعد الكبيرة المتصلة بالوحي والشرع، والحكم على تصرفات الناس وأحوال الحياة، والواجب الشرعي فيها، بل تلك وظيفة الفقهاء، لا يجوز لأحد أن يتسور على محرابهم فيها، ولا أن يقول فيها بقولٍ ليس تابعًا لواحد من أقوالهم، فإن هذا حينها من القول على الله بغير علم، ومِن تشبُّع مَن ليس مِن أهل الذكر بما لم يعطه الله إياه، مع كون رتبة الفقهاء هذه مفتوحة في أي وقت؛ لكي ينضم لها من امتلك أدواتها، وهي رتبةُ تفسيرٍ للدين، وليست رتبة عصمة ولا قداسة، ولا إنشاءً للحق.
وإنما وظيفة هؤلاء ترجع لبابين أساسَين:
الأول: أن يُمِدُّوا الفقيهَ، وأن يَرجعَ إليهم الفقيه فيما يُعينه على حسن الفقه والفتوى والاجتهاد، وهذا يظهر جدًا في حاجةِ الفقيه للمتخصصين في العلوم الطبيعية والإنسانية والمفكرين.
وكررنا كثيرًا أن عدمَ رجوع الفقيه لهؤلاء، أو عدم تعلُّمِه للأسس التي تُعينه على الانتفاع بكلامهم= من زَغَل الفقهاء وعيوبهم التي تؤدي للخلل في التفقه.
الثاني: أن يأخذَ غير الفقهاء هؤلاء، كلٌّ في مجاله، وبحسب قدرته= ما عند الفقيه -بحسب اختيارهم النزيه من أقوال الفقهاء- فيقومون ببسطه ونشره، داعين إليه، مُجمِلين إياه في أعين الناس، مُظهِرين حُجتَه؛ فتحيا به الحياة، ويصل إلى حيث لا يبلغ مدى الفقيه المكاني، أو الزماني، أو البياني.
وهذا يظهر جدًّا في حاجة الفقيه، وحاجةِ الدين كله للقنوات الوسيطة من الخطباء، والأدباء، والشعراء، والقصاص، والدعاة، والمفكرين، والساسة= يُبسِّطون مفاهيم الفقهاء وأصولهم ونظرياتهم في الناس، ويعالجون بها واقع الحياة بما يزيد على معالجة الفقهاء، ويصححون بها ممارساتهم، فيقتدي الناس بهم اقتداءً تابعًا لاقتدائهم بأولي الأمر من العلماء والأمراء الراشدين حال وجودهم.
من هنا تعلم أهمية إنزال الناس منازلهم، وعدم رفع غير الفقهاء مقام الفقهاء، ووجوب ألا يَتعالى الفقهاء عن خلط معارفهم بمعارف غير الفقهاء؛ فإنه كما يَحرُم أن يُفتي في الناس غيرُ فقيه = يحرم أن يفتي فيهم من لم يقف على أحوال الواقع الذي يفتي فيه، ويستعين بما لا بد منه من معارف غير الفقهاء وخبراتهم.
ومن هنا تعلم أهمية وحاجة الأمة لكل الكفاءات والمواهب فيها، وأهمية تشغيلها جميعًا كلٌّ في محله، وأن هذه هي حال الأنبياء مع أصحابهم، والراشدين مع أُممهم.
ومن هنا تعلم -وهو أهم ذلك كله-: خطورة أخذ أصول الدين وقواعده وكلياته ونظرياته التشغيلية، وتحرير ما يجب على الناس في الأحوال والمواقف والقضايا= من وُعَّاظٍ وقصاص وأدباءَ ومفكرين ليسوا فقهاء، ولا يمتلكون أدوات الاجتهاد العام في الدين والشرع وتفسير النصوص.
ولو قال قائل: إن معظم الخلل الذي دخل على الأمة خاصةً في قرنها الأخير هو من أن قادة العاملين فيها جُلُّهم من غير الفقهاء= لما كان بعيدًا.
(2)
واستهانةُ الناس بالدين، وجعلُه كلأً مباحًا لكل جاهل: ليست شيئًا خاصًا بالعلمانيين.
نعم، ابتدأتها العلمانيةُ الأوربية في سعيها لهدم سلطة الدين في نفوس الناس، وتَبِعهم في ذلك العلمانيون العرب.
لكنْ -رَغم ذلك- ستجد أثر هذه الاستهانة في نفوس كثير من الإسلاميين الذي يُعِزُّ على الواحد منهم ألا يتكلم في الدين كما يتكلم الناس، ويشق عليه في الوقت نفسه طريق العلم، فماذا يصنع؟
بدلًا من استعمال لفظ العقل الذي يستعمله العلمانيون كمُسوِّغ لِخَبطهم الجاهل المتعالم في الدين= يخترع هو بدائل ويجعلها مسوغًا لِخبطه الجاهل المتعالم في الدين.
- أحملُ الفكرة الإسلامية.
- أغارُ على الدين.
- نعرف أصول الإسلام.
- نتكلم في الأمور البينة.
وكل تلك دعاوٍ كاذبة، فلا حَمْل الفكرةِ الإسلامية يعني أن تتكلم في دين الله عز وجل، “ممكن حضرتك تخدم الفكرة في توزيع الصدقات مثلًا”، لكن لا تتكلم في الدين إلا إذا كنت مؤهلًا.
ولا الغيرة تُؤْذن بالقول على الله بغير علم، ولا أنت تُحسن أصول الإسلام أو تَفقهها، ولا الأمور البينة والمعرفة بها تؤهلك للانتصاب بالثرثرة، ولا أنت أصلًا تكتفي بالأمور البينة، بل أنت تَخبِط هاهنا وهاهنا بلا تقوى، ولا ورع، ولا وازعٍ من قلب حي يحفظ حرمةَ القول على الله بغير علم.
وكثيرًا ما أحزن وأُشفق -والله- على كثيرٍ ممن يثرثر ليل نهار، ثم أقف له على كوارث تدل على جهله بما لا يسعُ الجهل به من دين الله عز وجل، ولا أدري بأي وجه سيلقى هؤلاء ربهم؟!
والكلام عن تقرير أصلين:
الأول: الخطاب بالتعلم خطابٌ عام في الوحي لكل الناس، لا يجوز القعود عن الاستجابة له إلا العجز، وكل وظيفة لها اتصالٌ بالدين فَفِيها معرفةٌ واجبة يجب تحصيلها قبل ومع الاشتغال بها.
الثاني: ليس كل الناس سيكونون علماء، هذا طبيعي ومفهوم، لكن من لم يكن عالمًا: فلا يتصدر لوظائف العلماء.
لذلك نقول: إن طلبَ العلم فرضٌ لازمٌ، لا خيارَ فيه لأحد إلا أن يبذل فيه أحسن ما يستطيع، وما دام لَديك وقتٌ للثرثرة؛ فعندك وقت للتعلم.
| لا يوجد معيارٌ لتقييم شخص يتكلم في أي شيء له صلة بالدين إلا أن يكون مشتغلًا بالعلم جاريًا على قانونه، فنحاكمه إلى أسس العلم وقوانينه. |
إنَّ تعلُّم الدين، وتحرير أدلة الشرع ثبوتًا وتفسيرًا، وفهم كلام أهل العلم= كل ذلك شيءٌ شاقٌّ ليس سهلًا، وهو أعسر من العلوم الدنيوية التي يسهُل على الناس كفُّ لسانهم فيها، ويتورع الواحد منهم عن الكلام فيها بغير علم، ثم هو لا يُنزل دينَ الله ووحيه وتفسيره وفقهه هذه المنزلة!
طريقُ العلم ظاهر، اسلكه واصبر عليه، ثم إذا بلغت= فتكلم كلام من إذا أخطأ أُجر، وإياك والعجلة إلى منازل الجرأة على الشرع، فتتكلم بكلام من إذا أصاب = عاقبه الله عقوبة من دخل فيما لا يحسن، وإن أصاب، فإن عامة البلاء من دخول الناس فيما لا يحسنون، وقلة صبرهم على الإتقان والتعلم.
أيُّ شيءٍ سوى هذا: هو تعليل الجاهل نفسه؛ ليبقى جاهلًا، ولكن بضميرٍ مستريح.
وبهذا تستمر جناياتُ الذين يقولون على الله بغير علم، يحسبونه هينًا، وهو عند الله عظيم.


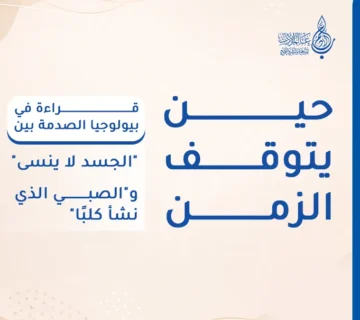
لا يوجد تعليق