بقلم ألفريد أدلر
مؤلف كتاب (سيكولوجية الخلق)
من أسوأ العادات البشرية في هذا الزمان عادة (التأفف من الحاضر)! ففي كل صباح نستيقظ فنفكر في مسئولياتنا ونتصور باستياء سائر الأعمال (الروتينية) التي سيكون علينا الاضطلاع بها في يومنا، ثم نتماسك ونقول لأنفسنا: (لا بد مما ليس منه بد، فلنقم بهذه الأمور، وليكن ما يكون…).
وبهذا (الاستفتاح) الواجم نخرج إلى أعمالنا المتباينة، ناظرين في ثبوط همة، ووجوم إلى حاضرنا، وعزاؤنا الوحيد أن نتخيل المستقبل خيرًا منه وأفضل متناسين أن حاضرنا كان هو المستقبل يومًا ما، بالنسبة لماضينا… وأن لهذا الماضي علاقة وثيقة بسلوكنا الحاضر…
ومنذ أمد قريب، راقبت أحد الضيوف الذين قدموا للجبال لقضاء عطلة آخر الأسبوع. ولا شك أنه حضر إلى هناك ليقضي وقتًا طيبًا ويحظى بالمرح، وقد اتخذ كل عدة ممكنة لذلك، ومع هذا كان ظاهرًا عليه أنه غير سعيد، ولا مستمتع بوقته.
وكنا في أكتوبر، واليوم صاف جميل، والتلال في حفل رائع من الألوان… كأن الطبيعة تعمدت أن تحتفي بنا فقدمت إلينا خير ما لديها. وكان مضيفنا وزوجته يبذلان خير ما في وسعها… بيد أن هذا الضيف كان يمر بذلك كله وكأنه لا يراه، ولا يترك في نفسه أثرًا!
ولما قدمت أقداح (الكوكتيل) ومضت عيناه بعض الشيء، وبدا على حركاته شيء من الارتياح والاسترخاء، وبذل مجهودًا ليبدو مرحًا، ولكن كان واضحًا أن عقله مشغول بمشكلة ما…
ولو استطاع أحد الناس أن يقرأ أفكاره، لوجدناها شيئًا من هذا القبيل:
(بالله كيف يمكنني أن أواجه تلك الصفقة في الأسبوع المقبل؟ سيحتم عليَّ القيام بتسليم البضاعة وحدي، وهذا مستحيل! إن مساعدي لا يمكن الاعتماد عليه، وهؤلاء الناس من حولي لا يدرون شيئًا عن مشاق الحياة ولهذا فهم مرحون…
أما أنا فعلي أن أكافح وحدي، فكيف أمرح؟).
لعل هذا هو سبب حزنه ووجومه. أنه يجتر آلامه الماضية، ويتطلع بأسى إلى المستقبل. أما اللحظة الحاضرة فلا وجود لها عنده.. مع أنها وحدها اللحظة الواقعية!
وراقبت رجلًا آخر كان يلعب الجولف، فرأيته عند أول ضربة غير موفقة يسب سبابًا فاحشًا. ولكن أزعجني أكثر من هذا السباب نظرة الأسى وخيبة الأمل التي فاض بها وجهه، وتوالت بعدها أخطاره في اللعب. وفي كل مرة كان وجهه يتوهج، وعيناه تقدحان بالشرر… وبعد عشر ضربات طائشة، فقد الاهتمام باللعب. وعندئذ يا للعجب!- بدأت ضرباته تتحسن، حتى بلغت حد الروعة، ولكنه لم يظهر عليه الاكتراث أو السرور… فإن غيظه بسبب فشله السابق أفسد عليه لحظته الحاضرة… فالمسكين خسر لنفسه في لحظة الفشل، وفي لحظة النجاح على السواء! لماذا؟ لأنه صارم مع نفسه، لا يسمح لنفسه بالتخلف عن ذروة الكمال، ولا يغفر لها التقصير… وأظن أن منشأ هذا الطبع عنده أنه كثيرًا ما سمع من أهله- أبيه أو أمه، أو أخيه أو أخته- وهو صغير أنه خائب لن يفلح في شيء؛ فاستبد به الإصرار على التفوق والنجاح، إصرارًا جعله يخوض كل شيء بعداوة وصرامة!..
وأعرف رجلًا آخر ليست له أمنية في الحياة سوى الاعتكاف في كوخ جميل بسيط على الشاطئ، حيث يقضي وقتًا سعيدًا، ولا يعمل إلا ما تهفو إليه نفسه. بيد أنه لا يستطيع تحقيق حلمه هذا فورًا، لاضطراره بسبب ظروفه، للبقاء في المدينة… إلا أنه كان يستعد لتحقيق حلمه! والذي أعلمه أن هذا الاستعداد للتقاعد الموعود دام الثلاثين السنة الأخيرة، ومع هذا لا يبدو أنه اقترب من غايته!
ومعنى هذا أن فترة الاستعداد للتقاعد استغرقت الجانب الأكبر من رحلته بين مهده ولحده!..
ومع هذا فهو يعتبر هذه الفترة الهائلة (فترة انتقال) لا أهمية لها، أي أنها مجرد (شر لا بد منه)، يتجلد لاحتماله بغير تلذذ أو قابلية!
وعلى هذا الأساس لم يتذوق الرجل طيلة ثلاثين عامًا طعمًا للحظة الحاضرة، مدخرًا كل حواسه وذوقه لفترة التقاعد المستقبلية. وكيف لم يسأل نفسه متى يتاح له هذا المستقبل؟ وإلى أي حد يضمن استمتاعه به، حتى يوقف كل بهجة حياته عليه؟
إن هذا المسكين فاته أن يعيش في الحاضر، مكتفيًا بالماضي والمستقبل، وبذلك فاتته لذة الحياة الحقيقية الواقعية! أليس هذا سخيفًا، مضحكًا، مؤسفًا في آن واحد؟ أوليس هذا- مع ذلك- هو ما يفعله الكثيرون هنا؟
إننا نتجلد للحاضر، ونعانيه على مضض، من غير تذوق أو تلذذ أو استماع بما يقدمه لنا فعلًا، لأننا مشغولون بما نأمل أن نناله في المستقبل القريب أو البعيد وبذلك لا نتمكن من الحياة مطلقًا في أي وقت، لأن المستقبل سيتحول إلى حاضر، فإذا بنا ندير ظهورنا له ونتعلق بمستقبل تالٍ له، وهكذا تمر أيام العمر كلها ونحن لاهون!
ما أصدق من قالوا (عش كل يوم من أيامك كأنه آخر يوم لك في الدنيا) فعلى هذا نستخرج من يومنا الحاضر كل نقطة من عصارة اللذة والمتعة، في كل دقيقة من دقائقه.
(إن الحاضر يضم كل ما يمكن أن يتاح لك من اللذة، والبهجة، والاستماع والسعادة..)
اسمح لنفسك أن تشعر بتجربة الحاضر التي تمر بها شعورًا كاملًا شاملًا عميقًا، فهذه هي الطريقة المثلى التي بها تشعر أنك حي حقًا.
إن كل نقص في قدرتك على التمتع باللحظة الحاضرة تمام التمتع يدل على أنك من بعض الوجوه كنت تعسًا في الماضي. فقد ألفيت طفولتك، في الغالب غير بهيجة، لم تسمح لك بإمتاع نفسك على هواك، فاستقر في سريرك- أي في اللاشعور- أنك لا تستمتع ولن تستمتع بحاضرك، وأنه ليس أمامك إلا أن تنتظر مستقبلك، فعندما تكبر سيكون لك أن نصنع ما تريد، وتستمتع بوقتك كالكبار كلهم!…
وتأصلت هذ الفكرة في نفسك حتى نمت جذورها، وصارت عادة مقيمة في ذهنك، وصارت فكرتك الثابتة أنك لن تستمتع بحاضرك. فلما كبرت جعلت هذه العادة ترسم لك سلوكك ومشاعرك، وهكذا أمسيت تعيش دائمًا في الماضي أي تحت تأثير ماضيك الواجم، فكأن الماضي هو الذي يسيطر على حاضرك، أي على شعورك بحاضرك… وهذا هو معنى قولنا إنك تعيش في الماضي…
وهذه العادة الذهنية المتأصلة هي بعينها التي جعلتك تنظر دائمًا إلى المستقبل على أنه فرصتك للمتعة والسعادة. فلما أصبحت الآن في المستقبل، إذ به غير موجود لديك، لأنك تعودت ألا تنظر حولك إلى ما هو واقع، بل إلى أمامك، إلى ما لا تنتظر أن يقع!… ومتى وقع لم تجد فيه متعة، لأنه لم يعد مستقبلًا! والمستقبل وحده هو مستودع اللذات عندك!
وأنا شخصيًا لا أعرف إلا عددًا قليلًا من الناس يبدو عليهم أنهم مستمتعون بما تقدمه لهم الحياة فورًا، ومعنى ذلك أن العدد الأكبر من الناس مصابون بمرض التأفف من الحاضر، وهي علامة غير طيبة من علامات الاضطراب العصبي، قد لا تكون خطيرة جدًا، ولكن يكفي أنها تحرم المرء من لذة الحياة ومتعتها.
وأعرف رجلًا يحب الريف وحياة الريف جدًا، ولكن ظروفه تحتم عليه الحياة في المدينة، اللهم إلا أسبوعي إجازته السنوية فظل سنوات وسنوات يزمجر على الدوام: (الحياة في المدينة لا يطيقها إلا المجانين! نسمة واحدة من الهواء النقي… كلما فتحت عينك دخلها الرماد!).. فكدر على نفسه وقت حياته كله، وخسر حاضره بتشويهه في عينيه باستمرار، وتأففه منه.. إلى أن كان يسير ذات أصيل من أصائل الربيع البديعة على شاطئ النهر وقد اكتسى وجهه القطوب المعتاد وإذا بسحنته تتغير فجأة وقد فطن إلى صفاء السماء، وزرقتها، ورقة النسيم، وجمال الزوارق التي تنساب فوق صفحة النهر الهادئة، فانتابه موجة سرور، وشعر ببهجة الحياة لأول مرة في المدينة، واستمتع بمنظر الأطفال وهو يلعبون بين خمائل الحديقة العامة، وجعل يتطلع لأشجارها بهيام…
وعبرة هذا المثل، أن المعول ليس على المكان الذي تعيش فيه، بل على كيفية استقبالك للظروف والمواضع، وكيفية تأثرك بها، وتذوقك لما فيها من مباهج، إن أحسنت التنقيب عنها، فكل منا يعيش في ظروف ليست من اختياره مائة في المائة، ولكننا نتفاوت في قدرتنا على التكيف لها، أي على استخلاص ما فيها من جمال ومتعة بقدر الإمكان…
إننا جميعنا نشد البهجة والسعادة أكثر من أي شيء آخر في الدنيا. فكلنا نعيش على أساس ما يسمى مبدأ اللذة. ومقياس كل الأفكار والأعمال هو مقدار ما يمكن أن تقدمه لنا من السرور أو اللذة. فإذا انحرفنا عن ذلك الاتجاه، فلابد أن هناك اختلالًا عصبيًا أو نفسيًا في تكويننا يوسوس لنا أن أكبر لذة تتاح لنا هي التفكير في الماضي، والتحليق في أحلام المستقبل، بيد أن السرور الذي نحصل عليه عندئذ سرور وهمي لا جدوى منه…
ولكي تغير أسلوبك هذا العقيم تشبث باللحظة الحاضرة وحاول جهد إمكانك أن تستخرج منها آخر قطرة من اللذة… اشعر بالحاضر، وثق أن اليوم، بل الآن، هو فرصتك الوحيدة للحياة فعلًا. وإذا كان مقدرًا لك أن تظفر بالسعادة فلن يكون ذلك إلا الآن، أي في الحاضر، فالماضي قد ولى، والمستقبل لم يحل بعد.
إن الحاضر يضم كل ما يمكن أن يتاح لك من اللذة والبهجة والاستمتاع والسعادة. وهذا الأسلوب الواقعي هو الكفيل بأن يغير وجودك كله. من التأفف والتذمر، إلى تجربة كاملة حافلة غنية بما يثير ويسر…
-نُشر أولًا بموقع حياتك.





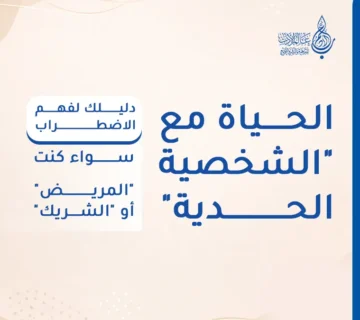

لا يوجد تعليق