(إن ترتيلَ سُبع القرآن في تهجُّد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة، والضحى، وتحية المسجد، مع الأذكار المأثورة الثابتة، والقول عند النوم واليقظة، ودبر المكتوبة والسحر، مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله، مع الأمر بالمعروف، وإرشاد الجاهل وتفهيمه، وزجر الفاسق، ونحو ذلك، مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان، مع أداء الواجب، واجتناب الكبائر، وكثرة الدعاء والاستغفار، والصدقة وصلة الرحم، والتواضع، والإخلاص في جميع ذلك= لشغلٌ عظيم جسيم، ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين).
الإمام شمس الدين الذهبي
(1)
عندما أمسكت بالقلم متهيئًا لكتابة هذه التدوينة، دارت في ذهني أسماءُ الحقول التي يتصدى الناس للكتابة فيها في أيامنا هذه، هل أكتب في السياسة، أم في الفكر، أم في الأدب، أم هل أقصُّ على الناس شيئًا من التاريخ، أو شيئًا آخرَ أوظف فيه شذرةً قرأتها هنا وورقة قرأتها هنا؟
لا يخلو الأمر من نوعٍ من الانتقاء النُخبَوي يفرض نفسه على الناس بلا شك، دوَّامةٌ معيارية صامتة تجذبك إليها، تفرض عليك بقوتها الناعمة موضوع كتابتك، هناك شيءٌ يشبه ماركات اللباس العالمية(براندات) للكتابة لا بد أن تسلكها حتى لا يُزريَ بك الناس باعتبار “إنك لوكال يا عم الحاج”.
ثم سألت نفسي: لماذا لا يكتب الناس عن الإيمان؟
لا. لا أقصد تلك الكتابة الفلسفية أو اللاهوتية، أو تلك الكتابة الروحية المُحلِّقة في فضاءات تصوُّف المتشدِّقين بالعبارات الشعرية؛ فتلك خُدعةٌ أخرى تريد أن تبقيَك داخلَ حزام نخبة الكُتَّاب المختارة.
أنا أقصد الإيمان الآخر، إيمانَ الجوامع، والصوامع، والدراويش، ومُطعِمي الطعام المصلين بالليل والناس نيام.
إيمانَ أرصفة المشافي، وعمَّار البيت، والناهلين من زمزم، والواقفين بطابور الروضة.
إيمانَ زوَّار القبور الساعين على الأرامل والأيتام والمساكين.
إيمانَ أهل الله وخاصَّته؛ ممن رزقهم اللهُ العملَ، ووقاهم شرَّ الجدل.
لماذا لا يكتبُ الناسُ عن هؤلاء؟
ربما يخشى الكُتَّاب من وصمةِ الدروشة، أو أن يَعُدَّهم الناس وُعَّاظًا قد سئم الناس منهم.
ربما يرون محنة التدين التي تَغمُر الناس في أيامنا، ستزري بهم إن كلموا الناس عن هذا.
لا أدري، لكن الذي أعلمه جيدًا أن الأرض تعجُّ بالذاكرين والذاكرات، أهل العمل الصالح، عمار جوف الليل، من لم تشغلهم فتن الدنيا وأمواجها عن طلب الله والدار الآخرة.
ربما أزرى بهم أهل الأحاديث الكبرى، والهموم العظمى، والانشغالات الجسيمة لكنهم لا يبالون، تراهم حول البيت خُشَّعًا أبصارهم، قد فرغوا من الدنيا وفرغت منهم.
عن إيمان هؤلاء أريد أن أتحدث معك.
(2)
1) الصلاةُ، والزكاة، والصيام، وزيارة البيت الحرام.
2) قراءة القرآن، وصلة الرحم، وإطعام الطعام.
3) نفع الناس، والسعي على الأرملة واليتيم والمسكين.
4) عيادة المرضى، واتباع الجنائز.
5) دوام ذكر الله ودعائه، وتعلق القلب به، وتوكله عليه.
هذه أوراد النفس، وزاد الروح، ودواءُ نَصَبِ الأيام، سعادةُ الدنيا وزينتها وجنتها، وطريقُ الآخرة وسعادتها وجنتها أيضًا.
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لن تجد في الوحي شيئًا يُساق مثالا على العمل الصالح وشُعَبِ الإيمان كهذين، ولن تجد يوم القيامة شيئًا ينفعك كهذين، ولن تجد شيئًا يستهين الناسُ بمنزلته في إصلاح الأمم وإقامة الدين كهذين.
﴿الَّذينَ إِن مَكَّنّاهُم فِي الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمورِ﴾ [الحج: ٤١].
إنه السير إلى الله جل جلاله، والاعتبارُ في السير إلى الله إنما هو بِسَيرِ القلب، وربما يسير الجسد أميالًا، فقط ليتحرك بالقلب خُطوةً واحدة للأمام.
ولم أرَ لحفظِ الإيمان، وحياةِ القلب، وسلامةِ الصدر واللسان = مثلَ إدامة ذكر الله ودعائه والثناء عليه، ماشيًا، أو قائمًا، أو قاعدًا، أو على جنبك.
ولا يميت القلبَ مثل الذنب بعد الذنب، ولا يُحيي مواته مثل الطاعة بعد الطاعة، كأنما تدقُّ حجرًا قاسيًا بِمِعولٍ دؤوبٍ حتى تتفجَّر منه الأنهار.
ولا شيءَ أسرعُ بيِّنة من ضعف الإيمان، ولا أدلَّ عليه من التثاقل عن الصلاة، والنفرة من المكث في المسجد، وطول الغفلة عن الذكر، وهجر القرآن.
وكما يعلو القلبَ السوادُ نكتةً بعد نكتة= فإنه يزول عنه سجدةً بعد سجدة، ولربما تجده وهو قاسٍ مُظلم، ثم لا يَلبَثُ أن يلينَ ويعلوه نور الله.
﴿وَإِنَّها لَكَبيرَةٌ إِلّا عَلَى الخاشِعينَ﴾ [البقرة: ٤٥].
لكن الناس لا يصبرون على هذا الطريق، وسرعانَ ما تتخطفهم الشياطينُ قاطعةً طريقَ سيرهم.
هجرُ القرآن، هجرُ الجماعة في المسجد، تضييعُ رواتب الصلاة والصيام، غيابُ الصدقة كممارسةٍ متكررة ومنهجية، جفافُ اللسان من الذكر، سوءُ الصحبة أو الخلو من الصحبة الصالحة، من العبث بعد هذا أن تشتكي همًّا، أو ضيقًا في الصدر، أو حرمانًا للتوفيق، أو معصيةً غالبة.
أنت من فتحت نوافذَ قلبك للهوامِّ تعشش فيه.
عندما يقع البلاء أو تُقبِل الفتنة= ينتصب الشيطان؛ فهي ساحةُ معركته معك، فإما أن يجدك آخذًا للأُهبة، مُعدًّا للعدة، وإما أن يجد خصمًا سهلًا قد بدت مقاتله.
والطاعة درعُ القلب، لا يتركها العبد إلا بقدر ما يريد أن يدع صدرَه عاريًا، لا يحجزه عن السيف شيء.
وإن البابَ الأعظم للشيطان ليس أن تقع في الذنب، البابُ الأعظم للشيطان هو في أن تهجر الطاعةَ، وتصير الذنوب لك حالًا دائمة.
فالمشكلة الكبرى في الذنب ليست هي نفس الذنب، ولكن أن الذنب يتركك في حالةِ وهاءٍ نفسي، يختلط فيها احتقار النفس بتخلِّي حفظِ اللهِ عنك= مما يقود للاسترسال في ذنوبٍ شتَّى، ويقود للمصيبة الكبرى حقًا= وهي ترك الطاعات.
ولعل هذه هي الأزمة العظمى التي تتسبب فيها كبائرُ الذنوب، أنها تقود إلى هذا أسرع بكثير،
فمِن أسوأ عقوبات المعاصي: أنَّها تُفقِدك الثقةَ بنفسك، وتُحدِث خللًا في جهازك المناعي .
وهذا هو الأصل الذي يندرج تحته ما يذكر من أنَّ من عقوبة الذنبِ: الذنبُ بعده.
فأنت تكونُ بعد الذنب في حالة وهاءٍ نفـسي وفقدانٍ للثقة، وهذه الحالة هي مفتاح القنوط،
لكنَّها ليست حالة لازمة لا فكاك منها، وإلَّا لَـمَا قال – صلى الله عليه وسلم -: ((وَأَتْبِعِ السَّيِئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا)) .
ومن أعظم الوسائل المعينة على استعادة الثقة بعد الذنب: التوبة، والاستغفار، والفزع إلى الصلاة، وقراءة القرآن .
وإن عدت للذنب= عد ثانية لهذا العلاج؛ فإنه: ((لَنْ يَمَلَّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا)).
﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الحَسَناتِ يُذهِبنَ السَّيِّئَاتِ ذلِكَ ذِكرى لِلذّاكِرينَ﴾
[هود: ١١٤].
وفي الخبر أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ؛ لَخَلَقَ اللهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ)).
فما أُعلمك إياه: هو أن تصنع لك مسارًا ثابتًا للطاعة، لا يتأثر بوقوعك في الذنب، واحرص على عدم الاسترسال في ذنوبٍ أخرى حتى ولو ابتُليت بذنبٍ أصررت عليه لا تطاوعك نفسك على تركه، فلا تنتقل من خانةٍ إلى خانة، لا تنتقل من خانة الإذنابِ بلا إصرار إلى خانة الإذناب بإصرار، ولا تنتقل من خانة الإذناب بإصرار إلى خانة الاسترسال في الصغائر، ولا تنتقل من خانة الاسترسال في الصغائر إلى خانة الوقوع في كبيرة، ولا تنتقل من خانة الوقوع في كبيرة إلى خانة الذي لا يبالي أيَّ محارم الله انتهك، حتى يُختم له بالكفر والعياذ بالله.
| دائمًا احرص على الوقوف بالخسارة عند حدها الأدنى، واحرص على بقاء مسار الطاعة ثابتًا لا يتأثر بمسار المعصية، فإذا كنت تحرص على الجماعة ولك وردٌ من القرآن والذكر، فَلِمَ تتركُ شيئًا من هذا إذا وقعت في ذنب؟ |
إنك كمن وجد في بيته ذبابةً ففتح كُوة الحائط لتتسرب منها سائر أنواع الهوامّ، فلا يلبَث الحائط أن يسقط ويتهدم البيتُ كله.
ثم إني أحذرك أن تكون ممن يستبشعُ ما يستبشعه الناس من ذنوب الشهوةِ مثلا، ثم إن لسانه لَيسترسل في أعراضِ الناس، وإن قلبه ليحملُ الضغائن والأحقاد، وتعشش فيه سموم القلوب.
مهما غلبتك نفسك لا ينبغي أن تنقطع عن ثوابت العمل اليومية، والتي هي بمثابة زادك الروحي، أعني: القرآن، والصلاة، والذكر، والدعاء، وتذاكُر كلام النبي – صلى الله عليه وسلم – وسيرته وسِيَرِ أصحابه، وتربية النفس على مكارم الأخلاق.
وبعض الناس ربما أنكَرَت نفسُه أنَّه يلازم هذه الثوابت، ثم إنَّ قلبه لا يلين، ونفسه لا ترتدع عن سقطات الذنوب المتتابعة، والحقُّ: إنَّ العلم والعبادة، ولين القلب، وملازمة المساجد، ووصال القرآن، وسائرَ شُعَب الإيمان= لا تعطيك حلاوتَها إلَّا مع الصبر والمجاهدة، وكثرة القرع على بابها. وأكثرُ الناس يقرع ثلاثًا، ثم ينصرف، فكيف يصيب حلاوتها ؟!
(3)
سياسةُ النفس لا تكون إلا بتوفيقِ الله، فلا يُكِلكَ الله إلى نفسك، ومن توفيق اللهِ لك أن يرزقك إطالة النظر في محاسبتها، وتُلَمُّسَ مواطن قوتها ومواطن ضعفها.
من حرمان التوفيق أن تطحنك الحوادث فلا تجد وقتًا لتقف مع نفسك.
معالجةُ النفس = مفتاح النجاة، ﴿وَالَّذينَ جاهَدوا فينا لَنَهدِيَنَّهُم سُبُلَنا﴾ [العنكبوت: ٦٩].
إن كمالَك في نقصك، وليس ذلك من جهة أنك تنقص، وإنما من جهة أنك تجاهد في علاج النقص.
صدقُ البلاء في معركة الهوى، هذا هو شرف الإنسانية.
وشجرةُ العُنَبِ لا تحمل ولا تُنتِج ثمرتها المعتبرة؛ إلا في السنة الخامسة،كل عام من هذه الأعوام الخمسة يتدخَّل الزارعُ؛ ليُقَلِّمَ فروع العنب، ولا يُبقي إلا أقلَّ القليل من الأغصان النابتة، لكنْ هذا التقليم السنوي يَزيد من قوة الأغصان الباقية حتى لا يبقى إلا أقواها، فيحملَ الثمار الناضجة تملؤها العافية.
وكذا..
تزكيةُ الرجل لنفسه يُزيل الآفات منها،
وتربيةُ العالمِ طلابَه يَستصلحُ منهم ويُبعد،
وسنةُ الذي قال: {إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ
وامتحانُ اللهِ للمؤمنين يَميزُ الخبيثَ من الطيب،
كل ذلك يزيد في قوة الزرع، ويُمَحِّصه، وينفي عنه خبثه.
انتفاشُ الأغصان يَغُرّ، وكثرتُها تُصَيِّر لها سُطوة وسُلطة، وتَصيرُ محرابًا يُطلبُ رضاه.
وإذا حِدتَ عن الطريق، وأعجبتك الأغصانُ المنتفشة فلم تهذبها، وصارت تأسرك كثرتُها= فلا تحزن بعد ذلك إذا لم تحمل ثمرًا يطيب للآكلين، ولا تطلب منها ظلًّا؛ فإن ظِلها مرعى الهوام، ولا حتى هي تنفعك تشعل بها نارًا، فهي -حينئذٍ- ذاتُ دخانٍ خبيث.
إن التعامل مع مجموعة متتالية من التحديات الصغيرة والجزئية على مدار اليوم، فالأسبوع، فالشهر، فالعام= هذه هي حياة الإنسان، وطريقتُه وقِيمُه في التعامل مع هذه التحديات هي ما يشكِّل مصيرَه،
وهذا بطبيعته يحتاج إلى حضورِ ذهنٍ، وجهادِ نفسٍ، وسعيٍ متواصلٍ؛ لتحصيلِ المهارات والمعارف التي تعين على التعامل مع هذه التحديات، مع دوام الاستعانة، وتعليق القلب بالحيِّ القيُّوم.
هناك بلا شك طريقٌ أسهل من ذلك كله؛ وهو: أن تكتفيَ بالثرثرة، لكنه ليس طريقَ الذين يُنادَون في كل يوم: حيَّ على الفلاح.





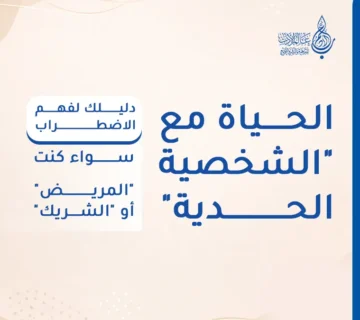

لا يوجد تعليق