للدكتور حسن شحاتة سعفان
أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة عين شمس
علم الاجتماع الجمالي:
من بين فروع علم الاجتماع المتعددة، نجد أن علم الاجتماع الجمالي، الذي يدرس المعايير الجمالية في المجتمعات المختلفة، بدائيها ومطورها، قديمها وحديثها، ويستخلص من هذه الدراسة القواعد التي يخضع لها الذوق الجمالي أو الفني في المجتمعات المختلفة كالمجتمعات اليونانية، والرومانية، والعربية، في عصورها الجاهلية والإسلامية، والمجتمعات الحديثة لا سيما منذ القرن الرابع عشر حتى اليوم..
وإذا كانت هذه هي الغاية من دراسة علم الاجتماع الجمالي من حيث كونه علمًا وضيعًا، فإنه يفتح الطريق أمام نوع من الدراسات المعيارية التي تستهدف رسم القيم الجمالية التي يجب أن تراعى في الإنتاج الأدبي والفني، حتى يكون متناسقًا مع الذوق الاجتماعي من جهة، ومفيدًا للمجتمع من جهة أخرى.
• نصف المنحرفين الذكور تسببت الأفلام في انحرافهم!
• الطلبة يذكرون الأفلام بنسبة 80% والدروس بنسبة 40%!
• مجتمعنا مازال قاصرًا عن اتقاء ضرر الاختلاط!
فالغرض من هذه الدراسات المعيارية إذن هو رسم النماذج أو الأنماط التي ينبغي للأديب أو الفنان أن يراعيها في إنتاجه. ولا شك أن هذه الدراسة تقوم على بحث رئيسي أولي فيما إذا كان على الفنان أن يستهدف تحقيق أغراض اجتماعية في إنتاجه، أو أن له الحق في أن يتجاهل المجتمع الذي يعيش فيه؛ أو بمعنى آخر: البحث فيما إذا كان الفن للفن بصرف النظر عن أي أهداف أخرى يفرض على الفنان تحقيقها في إنتاجه، أو أن الفن يجب أن يراعى فيه تحقيق غرض أو عدة أغراض اجتماعية.
ومن الأوجه المتعددة لهذا الموضوع تلك المعركة (القديمة الحديثة)، وهي معركة الأدب الهادف التي ما زالت تشغل بال المفكرين الأوروبيين والمصريين حول الأدب الهادف، أي الذي يستهدف تحقيق غاية من الغايات الاجتماعية. ولكننا لن نخوض في هذه المشكلة بل سنتركها للأدباء والفنانين، لا سيما وإن معظم علماء الاجتماع يعتقدون أنها ليست مشكلة، لأن الفنان أو الأديب لا يمكن أن يتجاهل المجتمع الذي يعيش فيه، أراد ذلك أو لم يرده، لأنه مهما بعد في إنتاجه عن المجتمع يلاحقه باستمرار ويؤثر في تفكيره بشكل شعوري ولا شعوري لا حيلة له في التخلص منه… أما المشكلة الحقيقية فهي البحث فيما إذا كان على الفنان تصوير الحياة الاجتماعية الماثلة أمامه بما فيها من خير وشر، وما فيها من محاسن ومناقص، أم أن عليه أن يرسم نماذج مثالية يطلب إلى الأفراد تحقيقها…
ونجد العلماء هنا ينقسمون إلى فريقين: فريق يقول بضرورة التزام الفنان للحياة الواقعية الماثلة أمام عينيه؛ وهؤلاء هم أصحاب المذهب الواقعي أو الانعكاسي؛ أي الذين يعتقدون أن الفن يجب أن يكون أشبه شيء بالمرآة الصافية التي تنعكس عليها الحياة الاجتماعية بخيرها وشرها.
أما الفريق الثاني فيذهب إلى أن الفن يجب أن يكون مثاليًا، يرسم فيه الفنان صورًا خيالية مثالية لما يجب أن تكون عليه الحياة الاجتماعية، موحيًا إلى الأفراد أن يحذوا حذوها في حياتهم. وهذه المسألة هي التي ستشغلنا في هذا المقال فيما يتعلق بالفن القصصي والمسرحي وصلته بالسلوك الاجتماعي والفردي عامة، والسلوك الانحرافي والإجرامي على وجه الخصوص.
كيف نفيد من القصص والروايات:
ماذا يجب على الروائي أو القصصي حتى يكون إنتاجه ذا فائدة للمجتمع؟ هل يتبع أصحاب المذهب الواقعي أو الانعكاسي فيتخذ أشخاصه من صميم الواقع؛ أم يتبع أصحاب المذهب الخيالي فيرسم شخصيات لا تمت للواقع الملموس بصلة؛ شخصيات يرسم هو ملامحها العقلية والخلقية، ويضفي عليها صفات لا وجود لها في الحياة الاجتماعية، وإن وجدت فإنما توجد لمامًا وعلى سبيل الاستثناء؟!.
نجيب على هذا السؤال بأن الإصلاح الاجتماعي يستلزم أن يكون كلا النوعين موجودًا جنبًا إلى جنب… أي يستلزم أفلامًا، وقصصًا، وروايات تمثل الجانب الواقعي من الحياة، إلى جانب قصص تمثل الجانب الخيالي المثالي… ذلك أن النوع الأول، أي النوع الواقعي يؤدي وظيفة على جانب كبير من الخطورة، لأنه إذ يعرض على الجمهور نماذج الحياة الواقعية، يحاول في الوقت نفسه أن يمجد ما فيها من محاسن ومزايا، ويسخر مما فيها من مناقص ومعايب، وبذلك يوجه النظر إلى ما في الحياة الواقعية من مشكلات لنعمل على حلها؛ ثم إنه يحقر من شأن مناقصنا فيوحي إلينا بضرورة التخلص منها، كما يعلي من قدر المحاسن ويجعلها نتشدد في التمسك بها. كما أن للقصص والروايات الواقعية وظيفة مهمة أخرى، وهي أنها تنفس عن الطاقات المكبوتة في نفوس جمهور القراء أو النظارة، ولا سيما تلك الفئة من القراء أو النظارة الذين تكتنفهم ظروف تشبه الظروف المحيطة بأشخاص الرواية.
فقد دلت الأبحاث على أن الإنسان كما يحب رؤية صورته الشخصية إما على الورق أو في المرآة، كذلك هو مغرم برؤية قصته أو مشاهدتها على الشاشة أو في قصة من القصص التي يقرأها؛ بل في أغنية من الأغنيات التي يسمعها إذا كانت تصور ما يجيش في نفسه من عواطف، وما يحس به من انفعالات… ومن هنا نفهم خطورة الدور الذي يلعبه الفيلم أو القصة على المشاهد أو القارئ الذي يوجد في نفس الظروف المحيطة لشخص من شخصيات الرواية؛ لأن القارئ أو المشاهد غالبًا ما يدمج نفسه في الشخصية الممثلة أمامه، وبذلك يؤثر سلوك هذه الشخصية على سلوك الشخص بعد الفراغ من القراءة أو بعد مشاهدة الفيلم، إذ يعمد أحيانًا إلى تقليدها والسير على النموذج المرسوم في الرواية.
ودلت الأبحاث أيضًا على أن الفرد المشاهد لفيلم، أو القارئ لقصة يتخذ في معظم الأحيان موقفًا سلبيًا إزاء الوقائع الواردة، ويتقبل حوادثها تقبلًا تلقائيًا، إذ يستقبل هذه الوقائع التي تنطبع في نفسه دون تمحيص من جانبه، ومن هنا نفهم كيف يمكن استخدام الأفلام والقصص الواقعية في إصلاح السلوك الفردي والاجتماعي لآلاف من الأفراد المشاهدين أو القراء إذا أحسن اختيار شخصيات الرواية، وحبك الأدوار التي يقومون بها، وحل العقد الواردة بها.
أما بالنسبة للأفراد الذين ليس ثمة صلة بين ظروفهم وظروف شخصيات الرواية، فإن أثر هذه الأخيرة عليهم ضخم أيضًا، لأنها لا تكون معهم بمثابة قصة فحسب، بل عبرة أيضًا؛ أي تكون بمثابة نموذج يحذون حذوه إذا هم أحيطوا يومًا ما بنفس الظروف…
بل لقد أمكن استخدام الأفلام والمسرحيات الواقعية في كشف كثير من الأمراض النفسية والاجتماعية وعلاجها، ولا سيما عند علماء القياس النفسي والاجتماعي. فإذا فرض وتقدم مريض نفسي إلى معالج. ولم يتمكن هذا الأخير من اكتشاف مرضه بالوسائل العادية كالمقابلة مثلًا، فإنه قد يلجأ إلى تأليف مسرحية تمثل ظروفه، ويأتي بممثلين محترفين ليقوموا بتمثيلها أمامه، ثم يقوم المعالج بملاحظة انطباعات حوادث المسرحية على نفس المريض وقياسها بالوسائل العلمية الدقيقة، وحينئذ يستطيع أن يصل إلى أسباب المرض، وظروفه؛ وهي تلك الأسباب التي لم يستطيع الوصول إلى اكتشافها بالوسائل العادية. ولقد أحرزت هذه الوظيفة نجاحًا منقطع النظير في الكشف عن كثير من الأمراض وعلاجها. ولقد استخدم ابن سينا وسيلة شبيهة بهذه الطريقة لبعض الأمراض.
هذا فيما يختص بالأمراض النفسية… أما الأدواء الاجتماعية فقد عمد كثير من الباحثين في القياس الاجتماعي إلى استخدام القصص المسرحية في علاج بعض هذه الأدواء. فإذا قام خلاف بين أصحاب العمل والعمال حول الأجر، أو أي شرط من شروط العمل، فإن مسرحية تؤلف بحيث يعرض المؤلف فيها الخلاف بشكل محايد، ثم تمثل الرواية أمام جماعة من النظارة الذي يمثلون مختلف الطبقات التي يتألف منها المجتمع، وبعد عرض المسرحية تؤخذ الأصوات على حل يعرض عليهم، أو يقام بعمل استفتاء يتعرف عن طريقه على رأيهم في الخلاف والحل الذي يرتضونه..
أما الروايات والقصص المثالية فإنها هي الأخرى ترسم لنا نماذج للسلوك المثالي طالبة إلى الأفراد تحقيقها، وهذا يتطلب أحيانًا بيان ما في السلوك الواقع في المجتمع من مناقص وعيوب، وما في السلوك المرسوم من مزايا. فالروايات المثالية تنقل المجتمع إلى مسئوليات جديدة من النماذج والأنماط الاجتماعية، وتغري الأفراد بمحاكاتها والنسج على منوالها، فهي إذن من العوامل المهمة المؤدية إلى تطوير الحياة الاجتماعية.
والروايات والقصص، سواء منها المثالي والواقعي، ذات أثر فعال على الأطفال على وجه الخصوص، إذ ثبت أن ذاكرة الطفل تعي حوادث الأفلام والقصص أكثر مما تعي ما يلقى عليهم في حجرة الدراسة بالوسائل التربوية العادية؛ إذ لوحظ في أحد الأبحاث أن أطفالًا بين العاشرة والثالثة عشرة يعون وقائع الفيلم بعد رؤيته مباشرة بنسبة 100%، ويعون هذه الوقائع بعد انتهاء عرض الفيلم بأسبوع بنسبه 80%! فنسبة ضياع المعلومات في ظرف أسبوع تبلغ إذن 20%؛ على حين أن هذه النسبة فيما يختص بما يلقى عليهم في المدرسة تبلغ 40%.! ولذلك قام علماء النفس والتربية والاجتماع بدراسة استغلال الأفلام والقصص والروايات في وسائل الإيضاح داخل المدارس وخارجها.
القصص والروايات والسلوك الانحرافي:
ومنذ سنة 1915 والعلماء يبحثون عن الصلة بين السلوك والانحراف من جهة، ووسائل النشر على العموم من جهة أخرى… أي يبحثون فيما إذا كانت وسائل النشر من أفلام سينمائية، وروايات مسرحية، وقصص وصحافة، بتعرضها لمعالجة النواحي الإجرامية والانحرافية تؤدي إلى زيادة نسبة السلوك الإجرامي، بما تؤدي إليه أحيانًا من إغراء الشباب بتقليد حوادثها، وبما تعرضه أحيانًا من تفاصيل الجريمة وطريقة تنفيذها بشكل يضع أمام الأفراد برامج إجرامية معدة للتنفيذ، لا سيما وأن أثر هذه الوسائل كما رأينا ضخم على نفسية قرائها أو مجموع نظارتها.
وعلى الرغم من أن البحوث التي قام بها العلماء في هذا المجال قد أدت إلى نتائج متباينة أحيانًا، فإنها قد دلت على أن مدى تأثير الأفلام والقصص على السلوك الفردي يتوقف على الظروف الاجتماعية التي تحيط بالفرد من جهة، وما يتميز به من صفات نفسية وحيوية من ناحية أخرى.
على أننا نستطيع أن نؤكد أن معظم البحوث التي أجريت لاختبار مدى العلاقة بين وسائل النشر- ومن بينها الأفلام، والقصص، والروايات المسرحية- وبين انتشار السلوك الانحرافي قد بينت أن هذه الوسائل تثير في الأفراد دوافع وأفكار إجرامية خطرة!.. وقد تظهر نتائج هذا التأثير على الفرد، وقد تكمن في الفرد وتستقر لمدة ثم تظهر بعد ذلك واضحة جلية، وقد يتلاشى التأثير ويزول بمرور الزمن… وذلك كله وفق ما يحيط بالفرد من عوامل فردية واجتماعية.
ومن أهم هذه البحوث ما قام به (بلومر) و(هوزر) من أبحاث أجريت على عينات من منحرفي السلوك. وقد دل أحد هذه الأبحاث على أن 49% من المنحرفين الذكور في عينة من العينات قد أثارت فيهم الأفلام السينمائية الرغبة في حمل بندقية؛ 28% علمتهم وسائل جديدة للسرقة؛ و21% أرتهم وسائل لتضليل البوليس؛ و12% شجعتهم على سلوك طرق إجرامية خطرة، 45% كونت لديهم فكرة عن سهولة الحصول على المال بلا عناء، و20% غرست في نفوسهم الإعجاب بمسلك العصابات… الخ.
كما دل بحث أجري على عينة من المنحرفات على أن 25% منهن قد أدت الأفلام إلى انزلاقهن في هوة الانحراف الجنسي، و41% كن يترددن على الحفلات الماجنة تقليدًا لما رأينه في السينما… كما دل بحث أجراه بعض العلماء على حدث في الثامنة، على أن إصابته بالصرع وانحرافه إنما يرجعان إلى تأثير فيلم رآه قبل ظهور أعراض المرض عليه بثلاث سنوات؛ وكانت مناظر الفيلم تدور حول حوادث مرعبة أثارت خوفًا شديدًا لدى هذا الحدث.
وصايا علم الاجتماع
وثمة بحوث كثيرة أجريت في هذا المجال ومعظمها يقودنا إلى الانتهاء بالتوصيات الآتية:
1- يجب الابتعاد في القصص والروايات عن كل ما من شأنه تحقير الأنماط والقيم الاجتماعية التي يحرص عليها المجتمع، والتي تكون الأسس المهمة للحياة الاجتماعية؛ وذلك كبعض القصص التي تصور الفرد على أنه يستطيع المعيشة (بالبلطجة) وبلا عمل على حساب الآخرين، أو تلك التي تصور الحياة الإنسانية على أنها تسير بلا نظام معين، ووفق الصدفة، وأن الكسالى قد ينجحون بينما يفشل العاملون المجدون!.
2- القصص والأفلام التي تدور حول حوادث العصابات، أو تكثر فيها المناظر الوحشية العنيفة، من أخطر ما يمكن على سلوك الأطفال والشبان اليافعين، لأنها قد تؤدي إلى إصابتهم بأمراض نفسية من جهة، ثم من جهة أخرى تؤكد في نفوسهم حب الشهرة ولو عن طريق أفعال غير مشروعة. فكثير من الأفراد في هذه السن يفرقون بين أعمال البطولة بمعنى الكلمة، والأعمال الإجرامية التي تؤدي إلى شهرتهم بين الناس. بل لقد ثبت من بعض البحوث أن كثيرًا من الأفراد قد قاموا بجرائمهم لكي تنشر صورهم في الصحف ويشتهر أمرهم بين الناس.
3- الأفلام أو الروايات التي تنشر تفاصيل الجريمة وتطنب في بيان كيفية تنفيذها، من أخطر الأفلام على سلوك الأفراد، لأنها أحيانًا تعطي وسائل سهلة للأفراد لكي يتخلصوا من خصومهم. فهي كما ذكرنا تضع أمام أعينهم وسائل سهلة للتنفيذ، وذلك مثل إطنابها في طريقة تحضير بعض السموم وكيفية الحصول عليها، أو كيف يمكن التمويه على رجال البوليس، أو إخفاء معالم الجريمة حتى لا تثار الشبهات حول المجرم… ومن أنواع المحاكاة الطريفة في هذا المجال، ما ساد بعض البلاد الأوروبية في وقت ما بين الحربين العالميتين من اتجاه بعض المجرمين إلى مصادقة ضحيتهم والتقرب إليها، حتى إذا ارتكبوا جريمتهم كانوا بمنأى عن الشك والشبهة. وقد تستلزم هذه الصداقة عدة سنوات… ومن هذا النوع أيضًا رسم وسائل السرقة والنشل والتدرب عليها بشكل مفصل محبوك الحلقات.
4- ومن أخطر الأنواع ما يشاهد خصوصًا في بعض الأفلام والروايات المسلسلة، أي تلك الأفلام والقصص التي يشاهدها الفرد على دفعات أو حلقات، من تصوير المجرم وقد استطاع أن يفلت من العقاب بينما يعاقب الأبرياء؛ لأن من شأن هذه القصص إغراء الشبان بارتكاب الجريمة على أمل الإفلات من العدالة. وأخطر أفلام هذا النوع هو الذي نجد فيه أن الجزاء لا يتكافأ مع ما ارتكبه المجرم من آثام، وذلك كبعض الروايات التي تصور المجرم في صورة بطل يقتل عشرات الأفراد، ويهتك عشرات الحرمات ثم ينتهي بأن يشنق أو يموت؛ فهي تصور هلاك شخص بمفرده نظير قيامه بعشرات الحالات الإجرامية، وهذا يظهره أمام الأفراد بمظهر البطولة، ويجعلهم ينظرون إليه بإعجاب وشفقة، وبذلك تأتي العبرة من الفيلم متأخرة، ولا تكون بذي أثر كبير! يجب إذن أن يكون الجزاء في القصص وفاقا ومتكافئًا مع ما ارتكب من جرائم، وأن تحبك الوقائع بحيث لا يستدر المجرم عطف القارئ، أو يثير إعجابه.
5- يجب أن يراعي المؤلفون حالة المجتمع الذي يؤلفون له، فقد يتفق فيلم من الأفلام مع الروح العام لمجتمع آخر. ولذلك يجب عليهم ألا يعمدوا إلى تقليد كل ما هو سائد في البلاد الأجنبية من أذواق، إلا بعد أن يضعوا الفيلم، في قصته وإخراجه، في شكل يتفق مع الروح العام للمجتمع. ويراعى ذلك خصوصًا في الأفلام العاطفية…
ونحن وإن كنا لا ندعو إلى التزمت في هذه الناحية لما يؤدي إليه من عواقب وخيمة، إلا أننا لا نرى الإسراف في تقليد المجتمعات الأوروبية والأمريكية فيما يظهر في أفلامها العاطفية. ذلك أننا لو قلدنا المجتمعات الأوربية مثلًا في أفلامها العاطفية التي تخرج عن الحد المألوف لدينا، وبشكل مبالغ فيه، فإن هذا من شأنه أن يحدث ما يسميه علماء الاجتماع (الهوة الاجتماعية) أو (التخلف الاجتماعي)؛ لأن الأفراد سيعمدون إلى تقليد وقائع الفيلم وتطبيقها في حياتهم العاطفية، وهم لم يصلوا بعد في تكامل نفسيتهم وأخلاقهم إلى المستوى الذي ينقلهم إليه الفيلم، ومن ثم تزيد نسبة السلوك الانحرافي المتعلق بالجنس…
فالشبان والشابات الأوروبيون إذا عرض عليهم فيلم عاطفي مثير بشكل خارج عن الحد (بالنسبة لنا)، فإن هذا قد لا يحدث نفس الضرر الذي يحدثه فيما لو عرض على شباب مصري أو عربي، لأن للأوروبيين تاريخًا طويلًا في اختلاط الجنسين، وفي رفع الكلفة بين الرجل والمرأة.. ولقد هيأ هذا التاريخ الطويل من الاختلاط للشبان والشابات فرصة التعلم من التجارب والتبصر بأضرار الاختلاط وفوائده، ومن ثم تعلموا كيف يتقون معظم أضراره ويجنون ثماره، أي أن شخصية الرجل والمرأة قد تكيفت بحيث أصبح لا يخشى عليها من أضرار الاختلاط. أما المجتمعات الشرقية فإن بعضها ما زال سائرًا على سياسة منع اختلاط الجنسين، وبعضها أباحه منذ عهد قريب، وعلى ذلك فتجارب الشاب والشابة في هذا المجال ما زالت قاصرة عن الوصول بهما إلى اتقاء أضراره بشكل كامل.
ثم إن ما نعنيه بكلمة (أضرار) يختلف هو نفسه في المجتمعات الأوربية عنه في المجتمعات الشرقية، فإذا قلنا مثلًا أن فتاة قد فقدت (أغلى ما تملكه)، فإن هذا الفقدان لا يعتبر خسارة بالمرة في كثير من المجتمعات الأوربية، أو على الأقل لا يعتبر خسارة كبيرة.. وإذن فيجب أن نراعي في الأفلام والروايات العاطفية جانب الاعتدال في غير تزمت، حتى يأتي يوم يكون لنا من التجارب، ومن تكامل النفسية في هذا المجال ما يقينا الانزلاق.
تأتي هنا بعض التوصيات المستخلصة من البحوث التي قام بها العلماء في هذا المجال. ولكن ثمة نقطة مهمة أثارها كثير من العلماء، وهي أنه لوحظ أن (بعض) الأفراد الذين يشاهدون أفلامًا أو يقرأون روايات لا تراعي فيها المعايير التي ذكرناها ينحرفون… ولكن هذا الانحراف لا يصيب (كل) الأفراد المشاهدين للفيلم، مما يقطع بأن الفيلم وحده لا يؤدي بذاته إلى السلوك الانحرافي، بل لا بد من وجود عوامل أخرى فردية واجتماعية تتضافر كلها مع الفيلم، وتؤدي بالفرد إلى الانحراف…
فنسبة الشبان الذين ينحرفون بسبب الفيلم تتراوح بين 5% و20% من مجموع المشاهدين أليس معنى هذا –فيما يرى بعض العلماء-أننا نظلم المؤلفين والمخرجين حينما ندعي أن أفلامهم التي لا تراعى فيها هذه المعايير تؤدي إلى الجريمة؟.. والرد على هذا السؤال سهل؛ ذلك أننا لو فرضنا جدلًا أن نسبة من ينحرفون بعد رؤية الفيلم ضئيلة، وأن الفيلم وحده لا يؤدي إلى الانحراف بل لا بد من عوامل تصاحبه، فإن هذا لا يعني إعفاء هؤلاء المؤلفين من المسئولية، إذ مهما صغرت نسبة الذين ينحرفون بسبب القصص والأفلام، فإن هذه النسبة تمثل مواطنين يعيشون معنا في المجتمع، ولهم على المجتمع حق حمايتهم وعلاجهم، شأنهم في ذلك شأن الآخرين…
إن التسبب في انحراف نسبة ضئيلة، ولو كانت هذه النسبة تمثل شخصًا واحدًا، تعتبر جريمة لا تغتفر سواء من المؤلف أو المخرج، ومن المجتمع نفسه، ولذلك يجب مراعاة هذه المعايير بصرف النظر عن نسبة من تؤدي القصص والأفلام إلى انزلاقهم. على أننا نؤكد أن ثمة بحوثًا أثبتت أن بعض الأفلام التي لا تراعى فيها هذه المعايير قد أدت إلى انحراف نسبة خيالية ضخمة من مجموع المشاهدين تعدت أحيانًا 20%!.
نستطيع إذن أن نختم هذا المقال بأن الروايات، والقصص، والأفلام وغيرها من عوامل النشر يمكن أن تستخدم في علاج كثير من الأدواء الاجتماعية ثم في الوقاية من هذه الأدواء…
-نُشر أولًا بموقع حياتك.





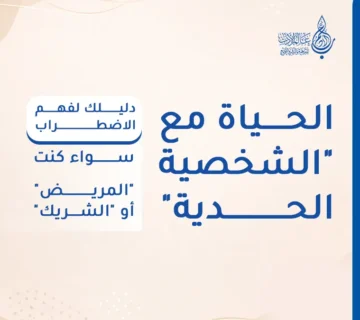

لا يوجد تعليق