(1)
في ذُروة صعود داعش اتصل بي صحفيٌّ أردني؛ ليحاورني في أسباب افتتانِ فئاتٍ مختلفةٍ بهم، وكان جوابي بأني رددتُ هذا إلى ثلاثة أسباب:
الأول: ظهورهم في لحظةِ إحباطٍ وانسدادٍ تاريخية، مع شعور مذلٍّ بالهزيمة عقبَ الثورات العربية.
الثاني: توالي انتصاراتهم على الأرض في تلك المرحلة، وجودة استعمالهم لوسائل الإعلام؛ بحيث تظهر انتصاراتهم، وتُداري في الوقت نفسه جرائمهم.
الثالث: استغلال نوستالجيا الخلافة، واللعب على عواطفِ الإسلاميين الذين تُشكِّلُ الخلافةُ لهم الحُلمَ المفقود، والخلاصَ المنتظَر، ولا يحتاج هذا أكثرَ من لحيةٍ تعتلي المنبرَ، أسفل عمامةٍ سوداءَ، مع لغةٍ تراثية، ودغدغة للعواطف بصورِ الحدود المطبَّقة، ومناهج المدارس الإسلامية، ونقاب النفاق يخطر في الشوارع.
لا تحتاج إلى أكثر من هذا لتغزو عقولَ آلاف الحالمين باستعادة الزمن المفقود.
لم تصنع داعش للإسلاميين وهمًا، بقدر ما استفادت من روح الحلم الكائنة في نفوسهم بالفعل، فالواقعُ أن العيش في التاريخ سمةٌ مميزةٌ للإسلاميين، استعادة الماضي بالشعارات، وتماثيل الصلصال، والأبنية الورقية، والأسماء الفارغة، كلها محاولات متفهَّمةٌ تمامًا لإبقاء جَذوة الهُوية مُتقدة في بحرٍ متلاطمٍ من الثقافات المتصارعة.
وسط كل ذلك تبرز الخلافة، كحلمٍ لا تهدأُ فورَتُه، وأملٍ لا تنقطعُ وعوده، وغايةٍ لم ييأس الطامحون لها.
إن تاريخَ الحركاتِ والتياراتِ الإسلاميةِ الحديث يُؤرَّخ عادةً بسقوط الدولة العثمانية، وتوضع المحاولات الأولى للكِيانات الإسلامية الحديثة تحت عُنوانٍ عريض: السعي لاستعادة الخلافة. وتُحدِّثنا عشريةُ سقوط الدولة العثمانية عن محاولاتٍ كرتونية مضحكة لتنصيبِ خليفة هنا أو هناك.
وليس ذلك -بالمناسبة- سمة خاصة بالإسلاميين في التاريخ الحديث، بل بعد سقوط الخلافة العباسية على يد التتار بسنوات، استضاف المماليكُ عباسيًا أعطوه اسم الخلافة فقط؛ ليستمدوا شرعيةَ الاسم، وليَسلِبوا عقولَ محكوميهم بالحلم، بصورةٍ تدعونا للحفر عميقًا في تاريخ بداية هذا الوهم.
(2)
هناك حالةٌ من الضبابية تسود غالب ما يُطرح من التصورات السائدة عن الخلافة، لا فرق في هذا بين ما يكتبه الإسلاميون وبين ما يكتبه العلمانيون، بل لعل المفارقة تكمنُ في أن الطرفين يتبنون تصورًا مشابهًا عن الخلافة، لكنهم يختلفون فقط في توظيفه وتأويله.
لدينا ثلاثة أخطاء مركزية في معظم التناول المطروح لقضية الخلافة:
الأول: التعامل مع الخلافة على أنها اسمٌ لنظام للحكم.
الثاني: التعامل مع التاريخ الإسلامي على أنه تاريخٌ للخلافة.
الثالث: استمداد تفاصيل هذا النظام -المدَّعى- من التجربة التاريخية وإعطائه طابع التوقيف.
يتفاوتُ حضورُ هذه الأخطاء كمًّا وكيفًا، لكنها أكثرُ الأخطاءِ دورانًا في الأُطروحات المعاصرة، وأكثرها تأثيرًا في الإضلال عن الحق في فقه هذا الباب.
وطلبُ الحقِّ في فقه هذا الباب عَسِرٌ جدًا، وليس شيئًا هَيّنًا يتعاطاه الناسُ من قريب، بحيث يسهل وُلوغُ أنصافِ المتعلمين، وأنصافِ الباحثين، وضعافِ الفقه من القانونيين الذين يُكثرون من الدخول فيما لا يُحسنون، وإنك لتجد في أطروحات الفقهاء الكبار من علماء القرنين الرابع والخامس أغلاطًا مذهلة فيما كتبوه في نظام الحكم والسياسة الشرعية، فما بالك بأغلاط من لم يبلغ عُشرَ أدواتهم.
وأكثرُ ما يشتبه من الدين، وأعظمه إشكالًا= أبواب الإمامةِ والجهاد؛ لذلك كان أول ما اختَلف فيه صحابةُ النبي ثلاث مسائل:
1ـ من يخلُفُ النبي ؟
2ـ قتالُ الروم، وإنفاذ بعث أسامة.
3- قتالُ المرتدين ومانعي الزكاة.
وشيءٌ من افتتان الناس وقلة فقههم هو فقط الذي يجرهم لكثرة الكلام في هذه الأبواب، يحسَبُ كل واحد منهم أن معه فيها علمَ النبوة، وهذا من علامات الاغترار الساذج، ودلائلِ الفقه الناقص.
وبعضُهم يحسب أن قضاءه بما معه فيها من العلم يرفع عنه إثمَ الدخولِ فيما لا يحسن، وليس كذلك، فبعضُ الكلام بعلمٍ ناقصٍ يكون أضرَّ من كلام الجاهل، فنصفُ حقِّ -أحيانًا- أضر من باطل تام، وبعض العلم الناقص أدعى لوجوب السكوت من عدم العلم.
والله وحده يعلم كم بيننا وبين النور الأول وعلم النبوة في هذه الأبواب، لكن المعلوم عندي يقينًا أن أكثر الناس يُثرثرون فيها بغير فقه، وأنهم موقوفون بين يدي الله مسؤولون؛ فإنهم بعضُ ظُلُمات الجهل التي تَحُولُ بين الناس وبين إبصار الحق.
| والحذرُ فرضُ عينٍ على كل من اشتغل بتلك الأبواب، فلا يُحجَر على فقيهٍ استفرغ وسعه، كما لا ينبغي أن يستخفَّ الناسُ الكلامَ فيها بغير بذلٍ للجهد وتعميقٍ للنظر. |
(3)
إن الخلافة ليست اسمًا لنظامِ حكم، والتجربة التاريخية للمسلمين في الحكم فيها مساحةٌ من الوحي القطعي، ومساحة من اجتهاداتهم في فقه الوحي فيها صوابٌ وخطأ، ثم المساحة الأعظم هي تجربةٌ إنسانية في معظم أنحائها، فيها من خصائص الزمان والمكان وحاجات الناس أكثرُ مما فيها من القيم الثابتة المتجاوِزةِ للمتغيرات.
بالتالي عند تقييمك لأي تجربةِ حكمٍ تاريخية أو معاصرة، فأنت لا تبني حكمك على الاسم، أو الدعوى أو الشعار، كل هذا يقودك للوهم الذي ختمنا فقرتنا الأولى في هذا المقال بالكلام عنه.
الخلافة: هي أن يخلُف حاكمُ المسلمينَ رسولَ الله ﷺ في الوظيفة العظمى له؛ إقامة الدين في الناس حاكمًا لهم بكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ.
وكما ترى فهذا أشبه بالرسالة الكلية والإطار المرجعي العام الذي ستندرج تحته آلاف التفاصيل، دون أن يملِك الحاكمُ المسلمُ في إدارة هذه التفاصيل نموذجًا تفصيليًا مثلها، هذا شيء يتسق مع طبيعة الشريعة الإسلامية نفسها التي تمزج بين تناول الأمور تفصيلًا أحيانًا، وإجمالًا أحيانًا، ووسطًا بينهما أحيانًا.
وتُتناول هذه الأمور بنصوصٍ لها طبيعة قطعية في ثبوتها ودلالتها أحيانًا، وبنصوصٍ لها طبيعةٌ ظنية في ثبوتها ودلالتها أحيانًا، وقد كان يمكن أن يرسلَ اللهُ نبينا بكتابٍ دقيقِ التفاصيل فيه النص على ما تقدم وتأخر، وتباعد وتقارب، وندر وكثر، بصورةٍ لا تُحوِجنا لا إلى بحثٍ، ولا إلى اجتهادٍ، وبصورة تقطع بابَ الخلاف، لكن:
هل هذا يتناسبُ مع طبيعة مسؤولية العبودية الملقاة على كاهلنا؟
الجواب: لا.
هل هذا يتناسبُ مع طبيعة مسؤولية الابتلاء والامتحان المُلقًى على كاهلنا؟
الجواب: لا.
هل هذا يتناسبُ مع طبيعة مسؤولية الدينِ الخاتم الذي ينبغي أن يبقى صالحًا للتعامل مع متغيراتٍ زمانيةٍ ومكانيةٍ وشخصيةٍ إلى قيام الساعة؟
الجواب: لا.
وبالتالي فكلُّ تاريخِنا الإسلامي بدايةّ من الخليفة الأول؛ أبي بكرٍ الصديق – رضي الله عنه- وانتهاءً بأيِّ حاكمٍ مسلمٍ ادَّعى أنه يريد إقامة الدين والحكم بكتاب الله= كل تلك تجارب إنسانية للقيام بهذه الوظيفة، تتفاوت في قربها وبعدها من النموذج النبوي، لكن لا شيء منها يستحق بمجرد دعوى الخلافة أن يكون دينًا، ولا شيء منها يملك أن يتحدث باسم الله ولا أن يزعم أن خلافته خلافة لله.
وإنما اكتسبت الحقبة الراشدة شرفَها، ودخلت عليها مساحةٌ من قدسيةِ المرجعية بسبب شهادةِ رسول الله ﷺ لهذه الحقبة، وبسبب شرفِ من تولى الحكمَ فيها، وكونِهم أكابر أصحاب رسول الله ﷺ الذين شهدوا الوحي وعاينوا التنزيل، وهي الحقبةُ الوحيدة في تاريخنا كله التي تستحق وصفَ الرُّشد، وكل ما كان بعدها فهو مُلكٌ عضوض وجبريّ، وسَلطناتِ حُكمٍ تَوسُّعِية، وإماراتِ حربٍ، مع استثناءاتٍ محدودة جدًا كالوَمضاتِ اليسيرة أهمها؛ خلافة عمرَ بن عبد العزيز رحمه الله.
وأما سائرُ نُظُمِ الحكم في تاريخنا فلا تستحقُ شرف الوسْمِ بالخلافة إلا من جهة الاسم اللُّغويّ، حيث يخلف كلُّ حاكمٍ سابقَه، أما الخلافةُ كاسمِ مدحٍ، فلا يُشهد بها إلا لمن كان غالبُ أمره في سياساتِ. حكمه، وخصائص وصفه، وفي امتيازات شخصه= كافٍ للشهادة له بأنه ساسَ الناس بحكمٍ رشيدٍ خلَفَ فيه رسول الله ﷺ، فأقام الدينَ في الناس بكتاب الله وسنة نبيه، كيفما كانت أدوات حكمه، وإجراءات إدارته، طالما كانت إقامة الدين في الناس بالوحي هي القيمة المركزية الضابطة لتصرفاته.
إن سلطنةً أعجمية تقوم على الجِباية، والتوسع القتالي، وامتصاصِ خيرات الشعوب، وإفساد بِناها التحتية، وتركِها مؤهلة تمامًا للاستعمار كالسَّلطنة العثمانية= لا تستحق أن تعطيَها حكمًا قِيَمِيًّا إيجابيا لمجرد أن بعضَ الناس أسموها الخلافة العثمانية، أو لمجرد أن لها حسناتٍ معروفة لا تُنكر؛ فإن الشر المحض قليل أصلًا، ويمكنك الشهادة بالحسنات دون أن تُضفيَ على هذه السلطنة الجائرة وهم الخلافة هذا.
سفاحو الدولة العباسية ومجرموها على تنوع أسباب الإجرام ودرجاته فيهم= يجب أن تتعامل معهم تعاملًا نقديًا يزِنُ الخيرَ والشرَّ، ويضع الأحكام القيمية في موضعها بأسمائها الحقيقية، لكن ممدحة الخلافة أبعدُ ما تكون عنهم.
وأصحابُ الإحداثِ الأول بنو أمية، من تَسلسلتْ أخطاؤهم، وتراكبت وتعاظمت عبر مراحل حكمهم، حتى أضاعوا الخلافة الراشدة، وجرى على أيديهم طمسُ أول معالم الدين؛ أعني الحكم، كيف يُمدح هؤلاء باسم الخلافة؟ أو يُعدَّ تاريخهم تاريخًا للحكم الرشيد الذي نتخذه أُنْموذجًا نحلم بالرجوع إليه؟!
(4)
إن وسمَ ممارسات الحكم الإسلامية عبر التاريخ باسم الخلافة، والعيش داخل هذا التاريخ دون ممارسة الفعل النقديِّ عليه، ودون الفصل الحاسم بين الحقبة الراشدة وما تلاها= وهمٌ شائع في الأطروحات الإسلامية، وكلٌّ يغنِّي على ليلاه التي يريد أن ينتزعَها من هذا التاريخ الطويل، فالتيارات الجهادية والقتالية تستحضر الممارسات التوسعية لإمبراطوريات الحكم الإسلامي وتُكسِبها جميعًا صفةَ الجهادِ الرشيد، وليس الأمر كذلك.
والاتجاهات الدعوية التعليمية تستحضرُ الثراءَ العلميّ والمعرفيّ والدعويّ في تلك التجارب التاريخية؛ لِتربطه بنظم الحكم وطبيعتها، وليس الأمر كذلك.
والإسلاميون الإصلاحيون/التنويريون يتحدثون عن الحضارة الإسلامية باعتبارها مصدرًا مرجعيًا يُخَلِّصهم من مضايق محاكماتِ خللِ سياساتهم الحداثية المعاصرة.
والتحدث عن الحكم الرشيد باعتباره دولة رفاه، ومنادي عمر بن عبد العزيز الذي لم يجد متلقيًا للصدقة، وسحابة هارون الرشيد التي سيؤول خراجها إليه= يشيع على ألسنة من لن يحسنوا أبدًا فقه الرشد في خلافة الفاروق ومجاعتها وطاعونها؛ إذ كان فهمهم للرشد أنه دولة رفاه.
ولا تقتصر صور العيش في التاريخ، وممارسة الوهم في التعامل، مع قيمةٍ عظمى كالخلافة، على ما تَقدَّم فحسب، بل كان الداء العظيم الذي لا يقل عما سبق متمثلًا في العيش في التجربة التاريخية سواء للخلافة الراشدة أو ما تلاها، والتوسعِ في استنباط التفاصيل منها، والتعاملُ مع تلك التجارب السياسية والإدارية التاريخية على أنها ثابتٌ ديني ينبغي أن تُنسَج نُظُم الحكم المعاصرة على وفقه، وأن هذه التجارب الإنسانية التي نسجها الحكامُ المسلمون عبر التاريخ، الراشد منهم وغير الراشد= هي من خصائص الحكم الرشيد ووسائله المتجاوِزة للزمان والمكان.
وزاد الطينُ بلةً حينما تمت قراءة هذه التجارب التاريخية نفسها بعين الدولة الحديثة، وتولى كِبَر هذه الخطيئة: القانونيون حسنو النوايا من الإسلاميين ومحبي الدين، وكلُّ ذلك بلا شكٍّ متغيرٌ في حدوثه كمًا وكيفًا، لا أزعُم أنهم كانوا فيه درجة واحدة، ولا أن أفهامهم خَلَت من حقٍّ وصواب.
ويمكنك أن تأخذ مثالًا طريفًا على هذه الصورة من الوهم عبر تتبعك لتطور مفهوم أهل الحل والعقد، وكيف أن نموذجًا إداريًا اقتضته طبيعةُ الشوكة وتوزُّعها، وطبيعة الولاءات القبلية في القرن الأول= أُريدَ له أن يكون متجاوزًا للتاريخ، ومتجاوزًا للظروف التي أنتجته؛ ليتحول إلى جزءٍ من نظام للحكم يوصَف بالرُّشد، ويراد استحضاره في مجتمعات تغيرت تركيبتها، وفي وسط قُوًى تغيرت خرائط توزيعها، ثم يُساق هذا الوهم كله على أنه نموذجٌ إسلاميّ للحكم الرشيد.
ولأجل مفارقة العيش في التاريخ نفسها تضطرب مواقف الإسلاميين وتصوراتهم لطريقة ضبط المجتمع؛ إذ أن التجربة التاريخية لا تحوي نموذجًا مماثلًا لأزمة المجتمعات الإسلامية المعاصرة واختراقها بالحداثة واضطراب معاييرها، فليس في التجربة التاريخية الإسلامية كلها مماثل للأزمة المعاصرة المتمثلة في حكم مجتمعاتٍ قد أُصيبت تصوراتُها عن الوحي ومرجعيتِه، ومجالات شموله، بهذا الاضطراب كله.
(5)
إن الخلافةَ كقيمةٍ ضابطة للحكم، بحيث لا يوصَفُ بالرشد الشرعي حُكمٌ لا يقوم على قصدِ خلافة رسول الله ﷺ في إقامة الدين في الناس بالوحي= ثابتٌ أصيل في ديننا، لا يمكن أن يتجاوزه التاريخ إلا من حيث أن الناسَ ينحرفون عنه، لا من حيث سقوطُ المطالبة به والحلم المشروع المتزن بعودته.
والخلافةُ؛ التي هي اسمٌ لنُظم الحكم الإسلامية عبر التاريخ= هي مجردُ اسمٍ لُغويّ لا يُمدح نظام حكمٍ به إلا من حيث معايرتُه بتلك القيمةِ الضابطة، وإِن الطُّرقَ الإجرائيةَ والإداريةَ لنظم الحكم الإسلامي عبر التاريخ هي بالضبط كالطرقِ الإجرائيةِ والإداريةِ في الدولة الحديثة= كل ذلك مُنتجٌ إنساني فيه الصواب وفيه الخطأ، وفيه ما يَصلُح للتوظيف الجزئي دون الكلي، وفيه ما يمكن أن يؤخذَ فيُمزجَ بغيره، وفيه ما هو صوابٌ في سياقه وظروفه بحيث إذا انتُزِعَ منه وأُريدَ غرسه في سياقٍ آخر، كان ذلك فشلًا ذريعًا، فلا قدسيةَ لتجربةٍ إنسانيةٍ محضة تؤهلها لتجاوز الزمان والمكان.
أما ما كان في تلك التجارب التاريخية من نقصٍ وخللٍ وانحراف، فوقوعه حقٌّ وصدق، لا إشكال في استحضاره والتحذير من الصورِ الوردية التي تَفرُّ من حقيقته، لكنه كله -فيما نرى- من صنع الإنسان، فإن الممارسة التاريخية لنظم الحكم في التاريخ الإسلامي استندت إلى نظام مرجعيٍّ فيه مساحة من المُقَدَّس، ومساحة من الاجتهاد والتنظيم البشري، ويقع الخلل أحيانًا بسبب انحراف الإنسان عن الجزء المقدس في النظام المرجعي، وأحيانا -وتلك يغفل عنها الناس- بسبب وجود أخطاء في الجزء الإنساني من النظام المرجعي نفسه، وأحيانًا ثالثة بسبب طبيعة الشر المتجذر في النفس الإنسانية وانحراف أهوائها وشراسة مطامعها.
وهذه خصلة لا يخلو منها نظام، طالما كان الإنسان جزءًا من هذا النظام، سواءَ كانت علاقته به أنه واضعٌ لأسسه كما في النظم الوضعية، أو كانت علاقته به أنه مفسرٌ للأسس ومنفذ لها كما في النظم المستنِدة لمرجعية مقدسة، ولذلك فإن محاولةَ تلمُّسِ جهاتِ العظمة في الحِقبة الراشدة يقودنا للحقيقة الكبرى المتعلقة بهذه الحقبة، وهي أن كلَّ واحدٍ من الراشدين الأربعة التزم تمامًا بالقيمة المركزية للرُّشد الشرعي، متجاوزًا مقتضيات الملك والسياسة الوضعية إلى التقيد بإقامة الدين واستحقاقاتها مهما كانت تحديات ذلك، والخلل الحاصل في الحقبة الراشدة ليس منه خلل واحد يمكنك أن ترده لانحراف عن تلك القيمة المركزية، وإنما كله راجع إلى ضعفِ المحكومين، وفسادِ نفوسهم، وقلةِ صبرهم على من يَعدِل فيهم، ونزوعِ النفس الإنسانية إلى الشر، وهو ما تَحسِب الدولةُ الحديثة حسابَه جيدًا، فتحاصر بروزَ تبعاتِه بأجهزتها الأيديولوجية ونظم الضبط فيها، بصورٍ مختلفةٍ من الاستبدادِ الناعم والسيطرة المُتَجَلبِبَة بعباءةِ القانون، وكل تلك وسائلُ ليست من العدل ولا من الرشد، ولكن أكثرَ المفتونين لا يعلمون.
وإن تاريخَ الدولة الحديثة الممتد عبر أربعمائةِ سنة هو تاريخٌ أقلُ ما يوصف به أنه تاريخٌ دمويّ، لا فرق في ذلك بين الحكم الليبرالي أو الاشتراكي الشيوعي، وإن أيَّ إحصائيةٍ لتاريخ الدم في التجربة الإسلامية لا يمكن مقارنتها بنتائج الحربين العالميتين، بل ولا يمكن مقارنتها من بعض الجهات حتى بممارسات الحلفاء من قتلٍ واغتصابٍ وتدميرٍ لألمانيا وشعبها؛ رجالًا ونساءً، عقب هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، ولا يعني هذا خُلوّ نظم الحكم الحديث من مقومات جودة ومميزات، كما لم تخلُ نظم الحكم التاريخية الإسلامية من مقومات جودة ومميزات.
لكن المرادَ تقريرُه هنا كحقيقةٍ صلبةٍ هو طبيعةُ الحكم في الدولة الحديثة وتحقُّقَاتها في العالم الغربي، والتي يمكن مدحها بأي شيء، لكن محاولةَ معايرتِها وموازناتِها مع البرامج المنافسة لها عن طريق معيار الدم= لن تُنتج إلا خيبة أمل كبيرة لوعاظ المدنية العلمانية الذين لا يختلفون في سذاجتهم وأوهامهم عن مُستحلبي أوهام خلافةٍ لا يفقهون طبيعتَها.
لا شيءَ في التجارب الإنسانية مثاليّ، وإن مسؤوليةَ كونِنا مسلمين، ومسؤوليةَ الفهم الدقيق لنصوص الوحي القطعية التي لا مفر من دلالتها= يفرضان علينا أن المعيار الذي تُحاكم إليه أية تجربةٍ إنسانيةٍ هو مدى قربها أو بعدها من هذه القيمة المركزية: إقامة دين الله في الناس إقامةً تتقيد بالوحي المُنَزَّل على النبي الخاتم المرسَل للناس كافّة، وهي إقامةٌ واجبٌ عليها أن تستجيبَ للتحديات النابعةِ من إشكاليات التفسير والتنزيل، والنابعةِ أيضًا من تحديات الظَّرف التاريخي، واحتياجها لتوليد الإجراءات والنظم المناسبة للزمان والمكان والأشخاص وفق القدرة البشرية، وما يستلزمه تجويدها من تحصيل الأدوات والموارد.
إن الحُلمَ بالخلافة -طالما فقهتَ معناها- حلمٌ مشروع، ولكن هذا الحلمَ المشروع لا ينبغي أن يتحولَ إلى حالةِ حنينٍ، ونوبةِ سُكْرٍ عن مسؤوليات الواقع وتحدياته؛ فإن أزمنة الرشد في التاريخ قليلة، ومسؤوليةُ الإنسان القائم بحق العبودية هي أن يوفِّيَ أيامَه حقَّها من الاستجابة لتحدياتها لا أن يعيشَ مستحلِبًا حلمًا لا تتوفر أدواته.
وقيامُ الإنسان بمسؤولياته وفقًا للتحديات التي تفرضها ظروفه التاريخية، هذا وحده هو ما يؤهله لمراكمة خبرات إجرائية، وإدارية، وفقهية تنزيلية ينتفع بها من قد يتحقق الحلم على أيديهم يومًا؛ فإن الخلافة قيمة ضابطة مركزية، ليست نظامًا تفصيليًا، ولذلك فإن إجراءاتِ إنفاذها في معظم مساحاتها تجربةٌ إنسانية، وبقدرة جودة الأدوات والموارد، وتراكم الخبرة الإجرائية، والإدارية، والفقهية= تؤتي تجربةُ تحقيقك للقيمة أُكُلَها.
وإن انحرافَ الإنسان عن الخلافة كقيمةٍ ضابطة رغم كونه انحرافًا له اسم الانحراف= فإن شرَّه كان أقلَّ بكثيرٍ من انحراف الإنسان عن القيم الحَداثية المُعَلمنة التي أُريد لها أن تكون ضابطة، وهذا شيء طبيعي جدًا؛ لأن هذه القيم المعلمنة صُبغت بطابعٍ مثاليّ فيه من خِداع الحكام للناس بالشعارات أكثر مما فيه من سلامة القيم وقابليتها للتطبيق، ولذلك فستبقى القيم الحداثية المعلمنة بيئة خصبة صالحة للتوظيف البراجماتي والانتقائية الميكافيلية، وستظل شعاراتُها واجهاتٍ كرتونية تُخفي وراءها نفوسًا نزَّاعة للهوى والشر، قد أنتج شرُّها فظائعَ لم يقع مثلها قطُّ في عمر الدنيا.


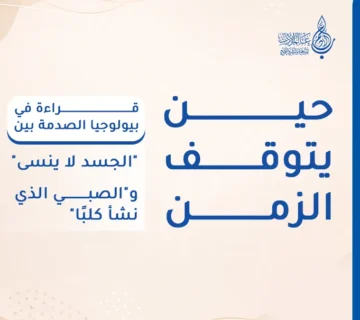
لا يوجد تعليق