لفضيلة الأستاذ الشيخ حسن مأمون
مفتي الديار المصرية
النفس المطمئنة هي النفس المؤمنة الراضية المرضية كما وصفها القرآن الكريم في قوله تعالى (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30).
والاطمئنان من علامات الإيمان ومن دلائل صدقه، أو هو أثر من آثار الإيمان الصحيح الذي يدخل في القلب فيبعد عنه شبح الخوف والقلق، والاضطراب والحيرة…
فمن شأن من يؤمن بأن للعالم إلهًا واحدًا، هو الله سبحانه وتعالى، الخالق لكل شيء الرازق، ذو القوة، المتين، الذي يخضع له الإنسان والحيوان وكل ما في الأرض والسماء من عوالم ويؤمن باليوم الآخر الذي يجازي فيه كل محسن على إحسانه، وكل مسيء على إساءته (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)…
ومن يعمر قلبه بهذا الإيمان وينشرح له صدره؛ أن يكون راضيًا بحالته، مطمئنًا إلى مستقبله، لا تزعزعه الحوادث، ولا تهزه الكروب والكوارث، ولا تنتابه الريب والشكوك والهواجس، ولا تعتريه حيرة قاتلة تقض مضجعه وتفسد عليه حياته… ولا يذهب بصبره وثباته الفقر أو المرض أو أي مكروه، بل يبتسم للحياة الناعمة المرفهة كما يبتسم للحياة الخشنة المؤلمة… فهو راض في جميع أحواله: في سروره وفي حزنه، في صحته وفي مرضه، يعرف الحق ويؤمن به ويعمل له بقوة وشجاعة وصبر…
إذا أغناه الله شكر وعرف له فضله، وتحركت في نفسه عوامل الخير والبر والإحسان بالفقراء والمرضى والضعفاء، ويجد في ماله وثرائه وسيلة لتخفيف آلام غيره ومواساتهم والعطف عليهم، ويتلذذ من فعل الخير، ومن البر، ومن كل عمل صالح يفيد الناس، وربما تجاوز ذلك إلى البر بالحيوان والرأفة به والعطف عليه…
وإذا أفقره الله صبر ولم يتبرم بنصيبه من الحياة ولم ييأس من تغيير حالته مرددًا قوله تعالى (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) وقوله تعالى (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156)…
يرضى دائمًا بكل ما يناله من خير أو شر في هذه الحياة ويرض عنه الناس ويرضى عنه ربه…
فالنفس المطمئنة ترجع إلى ربها راضية بما قدمت من عمل صالح ومن شكر وصبر، مرضية من الله تعالى، يرضى عما فعلت، ويرضى عما قدمت ويجازيها عليه الجزاء الذي يرضيها، ويدخلها في عباده الصالحين المؤمنين، وفي جنته التي أعدها لكل من آمن به واتقاه، وخشيه وراقبه في جميع أقواله وأفعاله وتصرفاته.
والمؤمن المطمئن الراضي يعرف أن لجسمه حقوقًا عليه، ولروحه حقوقًا عليه، فلا ينسى جسمه ولا روحه، بل يعمل لهما معًا، فلا يهمل رغبات جسمه، ولا يعرض عن مقومات حياته المادية ولا يلقى بنفسه إلى التهلكة.. لأن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وقد أمرنا الله، سبحانه وتعالى، بأن نستمتع بكل ما أحله لنا من الطيبات، وأن نتجنب ما حرمه علينا من الخبائث.قال الله تعالى (يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32).
ولا يهمل في الوقت نفسه حقوق الله عليه وحقوق الناس، فيعبده ولا يشرك به شيئًا، ويخلص له في العبادة، ويستعينه ولا يستعين أحدًا سواه… ويمتثل أمره ويطيعه مؤمنًا بأن الله سبحانه وتعالى، لا يأمر عباده إلا بما يحقق مصلحتهم وخيرهم وسعادتهم في الدينا والآخرة… ويؤدي حقوق الناس عليه فلا يظلم أحدًا ولا يهضمه حقه، ويعطف على الفقراء والمساكين، وينفق ماله في السر والعلن، ولا يبخل بكل ما يملكه، ويبر أقاربه، ويعيش في حياته محققًا المعنى السامي الذي خلق له، وهو الخلافة عن الله في أرضه…
لا يتواكل ولا يتكاسل، بل يشق طريقه في الحياة معتمدًا على السنن الكونية، وعلى توفيق الله له في سعيه وعمله، وإذا فشل لم ييأس بل يعاود العمل بعد أن يقف على أسباب فشله ليتجنبها سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يغير حالته ويوقفه في سعيه مرددًا قول الله تعالى (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (201).
أما غير المؤمن فإنه يعيش قلقًا مضطربًا لا تطمئن نفسه، ولا تستقر على حال لأنه لا يؤمن إلا بالحياة التي يحياها، فلا يؤمن بالله ولا يؤمن بيوم آخر يحاسب فيه على عمله، بل يكون همه أن يرضي رغبات جسمه وشهوات نفسه. وإذا أغناه الله نسب ذلك إلى نفسه وإلى حظه، ولم يذكر خالقه ورازقه ومدبر أمره… وإذا أفقره الله أو أصابه بمكروه أو مرض، ندب حظه، وأظلمت الدنيا في وجهه، وجزع ولم يصبر، وانتابته الهموم والأوجاع وعاش حياته منكدًا، وربما انتهى أمره إلى الانتحار الذي هو آية عدم الإيمان بالله…
ولذلك كان الإيمان ولا يزال دواء النفوس المريضة، يشفيها من علتها، ويعيد إليها الطمأنينة والهدوء والاستقرار، وكان في الكفر هلاك الروح والنفس.
فما أعظم الإيمان والصبر، وما أجمل التحلي بهما والانتفاع بهما في كل ما يصادف الإنسان في حياته من مشكلات وصعوبات ومتاعب، وكم في الحياة من مشكلات ومتاعب!
ويظن بعض الناس خطأ أن الإيمان معناه التواكل والاعتماد على الله بدون عمل أو سعي، وأنه عبارة عن الذكر والتسبيح والانصراف إلى عبادة شكلية لا أثر لها في نفس المؤمن، ويتصورون أن الزهد والتقشف والبعد عن مباهج الحياة وزينتها من مقتضيات الإيمان، ويتخذون من قصص بعض المتصوفين والزهاد حجة لهم على رأيهم… وهذا خطأ ظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، قدوة المسلمين، وإمام المتقين، كان يأكل ويشرب ويتزوج النساء. ولقد صح أنه علم أن ثلاثة من أصحابه اجتمعوا وقال أحدهم (أصلي ولا أنام) وقال الثاني (أصوم ولا أفطر) وقال الثالث (أعبد الله ولا أتزوج النساء)، فقال لهم (ما بالكم تقولون هذا. أنا أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني).
وقد عرف أصحاب رسول الله ذلك فجمعوا بين العمل وبين العبادة، ولم يحرموا أنفسهم من الاستمتاع بما أحله الله لهم، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم…
وها هو أبو بكر الصديق يراه بعض الصحابة صباح اليوم الذي اختاره المسلمون خليفة لرسول الله بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، يخرج من بيته على كتفه بعض الأقمشة فيسألونه عن وجهته فيقول لهم أنه ذاهب إلى السوق للتجارة كما كان يفعل لأنه محتاج إلى المال الذي يربحه من تجارته لينفق على نفسه وعلى عياله، وقد رده من لقيه من صحابته عن قصده بعد أن أظهروا له أن وقته لا يتسع لتجارته، وللقيام بتبعات عمله كخليفة لرسول الله ينظر في مصالحهم ويدبر شئونهم وفرضوا له في بيت المال ما يكفيه نظير قيامه بعمله، ولولا ذلك لاستمر أبو بكر في تجارته ليعول نفسه وأهله…
وكان أصحاب رسول الله لا يكادون يفرغون من الجهاد حتى يعود كل منهم إلى عمله الذي يوفر له ما يحتاج إليه هو وعائلته، وكان فيهم ذو المال الكثير ينفقه في سبيل الله.
هذا هو الإيمان كما أراده الله وكما فهمه المسلمون في حياة الرسول، وفي الصدر الأول، فليس لنا أن نبتدع إيمانًا آخر يصدنا عن السعي والعمل، وعن الاستمتاع بالطبيات من الرزق… ولعمري لم تتأخر الأمم الإسلامية إلا بعد أن انحرفت عن فهم حقيقة الإيمان، ودخل نفوسها الإعراض عن الحياة، أو الإفراط في حب الدنيا، والإعراض عن العمل للآخرة.
والنفوس المؤمنة المطمئنة هي النفوس العاملة التي لا تكف عن العمل والسعي، مع الرضاء والتسليم…
-نُشر أولًا بموقع حياتك.





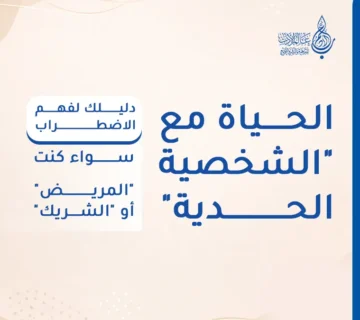

لا يوجد تعليق