توجب علي نفحات الهجرة أن أقتطع السلسلة التي ابتدأتها على هذه المنصّة لكي أعايش ما كان عندما اتسعت رقعة الإسلام وفتحت الأمصار، حين وجد الخليفة الملهَم، والصحابي المحدَّث أن الأمة الأمية التي علّمها نبيها صلى الله عليه وسلم أن تقرأ تحتاج اليوم إلى أن تكتب، لكي تُحصي الحقوق وتدوّن العلوم، ونشأ بجانب ذلك احتياجها لكي تؤرخ لأمجادها الناشئة، وهنا أريد أن أرحل قرونًا في الزمان لأستنطق روح الفاروق الزكية عما جال بُخلدها في هذا الأمر.
وقطعًا طُرحت أمامه بدائل عدة، هل يؤرخ استكمالًا على التقويم الروماني المؤرّخ بميلاد المسيح صلى الله عليه وسلم بكون هذه الأمّة امتدادًا لرسالته وتحققًا لنبوءته وتأكيدًا لأخوّة الأنبياء، أم يؤرّخ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بكونه الرجل الذي وضع للتاريخ بُعدًا آخر؛ فلا اختلاف ألبتة أن الحضارة والعمران، بل وصورة الملك والبلدان قبل مولده كانت شيئًا وبعده شيئًا آخر، أم يؤرّخ ببدء البعثة بكونها النقطة التي عندها التقت السماء بالأرض لبيان منهاج الحياة الصافية، أم ببدر الكُبرى بكونها يوم الفرقان كما سماها الله جل جلاله في كتابه وأنها كانت فاصلة بين زمان الاستضعاف وزمان التمكين. لكن عُمر الفاروق يختار أن يؤرّخ بالهجرة، وهي أصعب لحظات هذه الأمة؛ فالعدو من خلفها، والمستقبل المجهول من أمامها.
وقبل أن نستنطق روح الفاروق عن ذلك، ينبغي أن نُلقي الضوء على سمات عمر الفكرية لأنها التي لعبت دورًا في بناء هذا القرار الخالد، فشخصيّة عمر هي المثال الفذ على فعل رسالة الإسلام بطبائع البشر؛ فلقد نقل الإسلام عمر من النقيض إلى النقيض، من أحط دركات الظلم والعصبية والقومية، إلى أعلى درجات العدل والحق والإسلام. لقد كان عمر الفاروق هو الصاحب لصاحبيه، والتلميذ النابه لمعلّميه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته أبي بكر، فعلّمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يجُبُّ ما قبله، وأن رسالة الإسلام تجدد تاريخ البشرية، وعلّمه أبو بكر أن هذه الرسالة لا ترتبط بشخص النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف أمامه ساعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خطيبًا في الناس: «أيها الناس، من كان يعبدُ محمدًا فإن محمّدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيٌّ لا يموت».
فمن رأى عُمر وهو يخاطب أبا عبيدة: «لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزّة في غيره أذلنا الله» لن يعجب من اختيار عمر لعام الهجرة ليبدأ به تأريخ أمة الإسلام؛ فالهجرة هي اللحظة التي قطعوا فيها الصلة بالكفر والجاهلية والعصبية ونبذوها وراء ظهورهم، واستقبلوا فيها روح الإسلام الجديدة، وهي اللحظة التي باع فيها أولئك الأبرار أنفسهم واشتروا رضوان الله، وهي اللحظة التي تحقق فيها إيمانهم بالمطلق وتركوا خلفهم الأهل والمال، وهي اللحظة التي انتصر فيها يقينهم بالتمكين الغيبي على الاستضعاف المشهود، إنها اللحظة التي اختلط فيها القرشي بالخزرجي؛ فلا مفاضلة إلا بالتقوى، هي اللحظة التي نجح فيها المسلمون في الاختبار الصعب.
لقد كانت الهجرة هي الدرس الصعب الذي أراد الفاروق ألا تنساه الأمّة، وهو ينظر بعينيه البصيرتين إلى ارتفاع عز المسلمين وانفتاح الدنيا عليهم وحصاد زهرتها بأيديهم وقرب دخول الفتن عليهم من كل جانب، ودخول الفرس والروم إلى حظيرته؛ فالهجرة هي شعار الولاء والبراء، وبيان أخوّة المؤمنين الذين استقبلوا إخوتهم المضطهدين وبذلوا لنصرتهم الدم والمال، حين انصهرت الأمة الناشئة في بوتقة الإسلام الطاهرة لتخرج خير أمّة أخرجت للناس، وهي علامة الأخذ بالأسباب والتوكّل على ربها ومسببها، وعدم التواكل على أنهم أمة ينطق نبيهم بكلام الله جل جلاله.
ونحن اليوم بعد ١٤٣٧ عامًا من هذا الحدث الجلل أحوج ما نكون إلى أن نعي درس الهجرة، بل نحتاج إلى أن نجدد بيعة النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قبيل الهجرة حين البيعة «بايعوني على ألا تُشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف» فهذه الكلمات على وجازتها جمعت العهد على هذه الأمة بحفظ الدين وحقوق الخلق، وحفظ النسب والنسل، وانتظام الأمر الذي به يقوم دين الخلق! وفي واقع الأمر فإن الهجرة في سياقها التجريدي تحمل رسالةً لأولئك المُتعبين من أثقال الماضي، الذين نبتت جذورهم في تربةٍ قاحلة من الخوف والخزي والعار لكي يكتبوا لحياتهم صفحة جديدة، ولكي ينقلوا جذورهم إلى تربةٍ طيبةٍ من الحب والإخاء والقبول غير المشروط، وبيئة تحتوي الآلام وتتشارك فيما بينها لحظات السراء والضراء، لم تكن عملية الانتقال بالسهلة لكن النتائج كانت تستحق!
– نُشر أولًا بموقع صحتك.





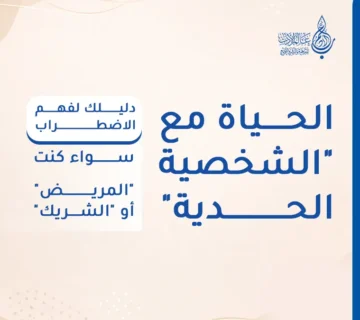

لا يوجد تعليق