عن أنس رضي الله عنه، أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: «وماذا أعددت لها؟».
(1)
هل أتاك نبأ الأسطول الروسي، والحشود الصينية، والتهيئة الإعلامية، والتحذيرات الأمريكية، والمشاورات الألمانية؟
- هل رجف قلبك؟
- هديرُ الهواجس يطحن قلبك؟
- طوفان الخيالات المرعبة يكاد يهلكك؟
كم مرة فكرت في الفرار من هذه البقعة الملتهبة من العالم؟
أنا لا ألومك، فسيلُ الأخبار والمعلومات الذي يحيط بنا من كل جانب يكمن فيه إرادةُ الإصابة بهذا التشويش عينه، لذلك قررتُ أن أكتب لك أنت بالذات هذا المقال.
هل يمكنني أن أطلب منك أن تهدأ تمامًا؟
اعلم يا سيدي الكريم أنه على أي جوانبها تدور الرحى، فإنها لا تدور إلا لتُلقي برأسك على عتبة مولاك، صابرًا على البلاء، شاكرًا على النعماء، مستغفرًا من الذنوب، مطيعًا مفتقرًا ترجو رضاه والجنة.
إن كل تقلبات الدنيا وأيامها ليس لها غرضٌ إلا اختبار جانب العبودية فيك، غنيًا كنت أم فقيرًا، معافًى أم مبتلى، مريضًا أم صحيحًا، في بقعةٍ هادئة آمنة من العالم أم في الجانب الملتهِب المستَعِر منه.
تختلف الأسئلة والامتحان واحد؛ امتحان العبودية، امتحان أداء الذي عليك، امتحان فعل ما يجب عليك فعله، امتحان قيامك بأمر الله ما استطعت في السراء والضراء، على المغنم والمغرم، والعافية والبلاء.
ليس مهمًا ما سيكون في الغد، المهم هو كيف ستصنع في هذا الذي تلقاه في الغد، ومَن رزقه اللهُ القيام باستحقاقات العبودية فهو الفائز السعيد سواء كان مجندلًا يتضرج في دمه أم مات في فراشه سليمًا معافًى لم يغادر الدنيا حتى سَئِمها.
احفظ هذا فإني أرجو إن وعيتَه أن ينجيك طول أمل يُذهل عن الطاعة، ويصرف عن الآخرة؛ فإن طول الأمل يقع في الخير والشر سواء.
والأصل الذي ينبغي أن يكون بَيِّنًا بين العين والأنف: أن هذه الأمة يُصاب منها لكنها لا تُستأصل، وأن عاقبة قضاء الله كلَّه خيرٌ، وأنه قد قضى الله لنا بدعاءِ نبينا أنه لا تزال طائفة من المسلمين على الحق، لا تُستأصل شأفتهم، ولا يضرهم من خذلهم، وأنه لن تموت أمة حتى تستكملَ أجلَها ورزقَها، وأن كل هذه الأصول الثوابت أجراها الله كَونًا، وكلَّفنا العملَ بما يُنتجها شرعًا، وأن الله أمرنا بالعمل لا نتخاذل عنه، ولو قامت القيامة وبِيَدِ أحدنا فَسِيلةُ خيرٍ فليضعها موضعها، لا يعجز ولا يكسل، ولا يُقعِده عن ذلك أن الحياة أُنُف، وأن غمسةً في الجنة تُنسي كلَّ بؤس وشقاء.
(2)
هناك خِيارٌ سيء اختارته الصحوة الإسلامية بِشقَّيها السلفي والإخواني بقصدٍ حسن أحيانًا، وبقصدِ شغلِ أذهان جُندِها أحيانًا أخرى، أعني خيارَ إسلام عقول وقلوب أتباعِها لسيلِ الأخبار اليومي تحت ذرائع فهم الواقع تارة، والاهتمام بأمر المسلمين أخرى، وكان لهذا الخيار السيئ ثلاثة آثار سلبية أساسية:
الأول: انشغالُ الناس وهدرُ مواردهم فيما هو خارج دائرة تحكمهم وتأثيرهم.
الثاني: ضعفُ القلب والنفسِ، والشعورُ المميت بالعجز وقلة الحيلة، بحيث يؤول كل ذلك إلى نوع مقيتٍ من البطالة وفقد الفاعلية والإحساس بفقدان الجدوى.
الثالث: تَصدُّر من شُغِل قلبه بهذا للتحليل والتنظير والقول بغير علم، بل شعوره بالاستعلاء بما بين يديه من قصاصات الأخبار.
| إن الأمم القوية أو التي تريد أن تمهد لقوتها لا تصنع هذا، إنما تسلك الأممُ مسلكَ التوزيع المنضبط للكوادر والكفاءات والمواهب، بحيث تشغل ثغور حاجتها الصانعة لمواطن قوتها، ويكون حظ كل فرد منها مما هو خارج موطن إتقانه وقوته= حظًا لا يعود بالنقص أو التقصير على عمله الذي يحسنه ويتقنه. |
نعم لا يخلو صاحبُ العزيمة من أن يكون طالبَ آخرة أو طالب دنيا، ولا يخلو واحد منهما من الهمِّ أبدًا، فمن استعاذ بالله من همِّ الدنيا، وجعل الآخرةَ أكبر همه، واستعان بالله، ولم يعجز وتوكل عليه سبحانه = كان أسعدَ الناس حقًّا، وليس موضع سعادته أنه لا يهتم، وإنما موضع سعادته أنه يهتم لأمر آخرته وما يتصل بها من أمر دنياه، ثم يُنزِل همه بالله، ويتوكل عليه ويستعين به، وما يكون في ذلك من مشقة هو ألم الطلب الذي لا تخلو منه الدنيا، والذي على قَدرِه يكون جزاء الآخرة.
وإن من حَملِ الهمّ أن يحمل الإنسان همَّ إخوانه من المسلمين؛ فإن المؤمنَ للمؤمنِ كالبنيان يشد بعضه بعضًا، ومثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
ورغم أن حديث “من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم” حديثٌ منكر شديدُ الضعف لا يَثبُت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم= فالنصان الأخيران هنا كلاهما صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنيان عنه، والاهتمام بأمر المسلمين شعبة إيمانية ثابتة لا تحتاج لهذا الحديث، لكن هذا الاهتمام لم يُقصد به أصالة في كلامه صلى الله عليه وسلم تتبعَ أخبار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بل رأس هذا الاهتمام هو ثغورُه المشهودة التي تستطيع أن تَؤثِّرَ فيها، وتصلح فسادها، وتَجبُر كسرها، وتُعوِّض نقصها أعني: برَّ الوالدين، وصلة الرحم، والسعي على الأرملة والمسكين، والصدقة على الفقير وابن السبيل، وتعليم العلم، ونفع الناس، فكل هذا من الاهتمام بأمر المسلمين، ومَن ضيعه وظنَّ أن تتبًّعَ الأخبار في القنوات وعصرَ العين تباكيًا ثم التولي عن الواجبات والمندوبات التي تحت يديه بالفعل= فهو آثمٌ مهدِرٌ لعمره، وقليلٌ يزعم أنه يحسن الجمع، ويوفِّي القريب والبعيد حقه، وقليلٌ من هذا القليل يَصدُق زعمه، وقد خبرنا أحوالَ من نعرفه فوجدنا أكثرهم يحرِق عمره وربما أضاع أهله.
هو يظن أنه منشغلٌ بأمر عظيم ما دام يتابع أخبار كوارث المسلمين الكبرى، والواقع أنه بطال ليس له من المتابعة إلا أجرُ ما يقع في قلبه من التأذي لضُرِّ المسلمين، لكنه بعد ذلك يظلُّ فارغًا لم يصنع شيئًا يُثقِل ميزانه ويجيب به عن سؤال العمر الفاني.
- (لم ينشغلوا بتغيير العالم، كان كل طموحهم ينحصر في إيصال أقلام الرصاص لأطفال المدارس في القبائل الأفريقية).
متى مضى على اقتناعي بالمفهوم الذي تشير له هذه العبارة المقتبسة؟
أظن عشْرَ سنوات، تعلمت فيها أن أكتفي بالضروري من المعلومات الذي لا أستغني عنه في تخصصي ولا أكون معه معزولًا، وفي الوقت نفسه لا يُقعِدُني ويفسخ عزيمتي أو يحرق عمري.
وليس يُعاب رجلٌ من المسلمين اختار لنفسه ما يحفظ قلبَه ويعينه على طلبِ ما ينفعه في الدنيا والآخرة.
إن سعادة الإنسان ومفتاح خلوصه من إحباطات الحياة المتتالية، ومفتاح العمل الحقيقي لا بطالة الشعارات= يكمن في نجاحه في صناعة الإنجازات الصغيرة المنتظمة والمتتابعة، التغييرات التي لا يشعر بها معظم الناس، ولا يجدونها أعمالًا عظيمة، لكنها تمثل شيئًا عظيمًا جدًا للذين فعَلتَها لهم.
وكما في اقتباس عظيم آخر:
(-إنَّ كل هذا الذي تفعله، ليس إلا قطرة في بحر.
=ربما، ولكن، ليس البحر يا سيدي إلا كمًّا من القطرات).
الفسيلةُ لن تغير العالم، لكنك أمرت بغرسها ولو قامت القيامة؛ لأنك تجدها في ميزان حسناتك تُثقِله، وهذا هو المهم
ثمانون بالمائة من وقتك وجهدك وتركيزك وعملك وتفكيرك يجب أن تنصرفَ للدائرة التي تؤثِّر فيها بالفعل، وتغير من واقعها بنفسك، هذا على الأقل.
أما دائرة الاهتمام بالأحداث والمواقف التي ليس لك تأثير فعال فيها، ولا تقدر على التحكم في مسارها= فينبغي أن تكون ضيقة جدًّا، وأن تسرِع بأداء ما يمكنك نحوها من دعاءٍ أو دعم معنويٍّ أو ماليّ، ثم تنصرف سريعًا لدائرة تأثيرك الفعالة.
بغير هذا: سيضيع عمرك دون إنجاز أو فاعلية، وستكتفي بأن توهم نفسك وتوهم الناس أنك مهموم مشغول.
في البخاري من حديث عمر أنهم كانوا يترقبون غزوًا من الروم، بينما عمر يداول الأيام بينه وبين صاحبٍ له هذا يعمل يومًا وذاك يذهب لرسول الله ومجالسه والعكس، ونصيبُ الغزو المترقَّب: مجرد سؤالٍ عابر يسأله عمر لصاحبه.
فإياك أن تسمح لما لا تستطيع تغييره أن يَحُول بينك وبين ما تستطيع تغييره.
(3)
“لا تتولوا ما كُفيتم، ولا تُضيعوا ما وُليتُم”.
هذا هو أصل الإصلاح وذروة سنامه؛ ألا يشغل الإنسان عمره إلا بما يتقنه ويقدر على تجويده والتميز فيه.
ابحث بهدوءٍ وأناة عن مواهبك ومكامن تميزك، وطوِّرها، وأصلحها، وأصلح بها.
فاعليةُ المجموع من فاعلية الأفراد، وعندما لا يقوم كل فرد بدوره على أتمِّ وجه= لا تنتظر من أية أمّةٍ أن تكون أمَّةً فاعلةً مؤثرةً.
وقيامُ كل فرد بدوره يعني عدة أمور:
أولًا: أن يبذل أقصى جهده في الفعل المتقَن لما يُحسنه.
ثانيًا: أن يستمر في تطوير نفسه على مستوى الرؤى والأفكار، ثم على مستوى تجويد الأدوات، وتجويد الفعل، وتجويد ما يُحسن وزيادته.
ثالثًا: أن ينطلق في فعله من مرتكزاته الخُلقية والقِيمية، وأن يجعلها أساس تحديد الخيارات.
رابعًا: شُعَبُ الخير والإيمان وأبواب خدمة الدين كثيرة؛ فلا تنصرف عما تحسن إلى شيء لا تُحسنه، أو إلى شيء لا تطيقه، أو إلى شيء قد قام به غيرك.
خامسًا: دوائرُ اهتمامك لا ينبغي أن تطغى على دوائر تأثيرك، اهتم بقضايا المسلمين لكن لا تبذل في هذا الاهتمام إلا أقل طاقتك، والباقي اصرفه للقضايا التي تستطيع أن تُحدث فيها تغييرًا ملموسًا.
ستُؤجر على كل بابٍ من أبواب المسلمين تحمل همَّه، لكنك ستُسأل عن كل باب لم تقم فيه بما كان في وسعك، ووزرُ التقصير يأكل أجر الهمِّ العاري عن الفعل.
أي شيءٍ ينفعك الهمُ والحيرة والضيق بواقع المسلمين= بينما أمام عينك وبجوار بيتك، وعلى طَرَفِ الثُّمَامِ منك، وبين جَنَبَات نفسك= أبوابٌ مُشرعةٌ وشُعبُ إيمانٍ تنتظر من يشغَلها؟!
مشروعُ الحياة: هو أفضل أداة اتزان تحمي الإنسان في مسيرته الشاقة في هذه الدنيا.
هذا المشروع أشبه بخطوط السكك الحديدية، مهما اعتور القاطرةَ من فتور، أو محاولةَ زحزحة أو توقف، يظل دائمًا بالنسبة لها مصدرَ جذبٍ وتثبيت، ودافعَ إعادةِ تشغيلٍ وحركة.
صياغة هذا المشروع نفسها أشبه بنَسَقٍ مفتوح، وليس مغلقًا، بمعنى أنه قابلٌ دائمًا للتعديل والتطوير.
هناك الإطار العام للمشروع وهو تحقيق العبودية لله عز وجل، والقيام بأمره في العسر واليسر، والمنشط والمكره، تأتي بعد ذلك محاور هذا المشروع، تمتد من النفس إلى المجتمع بكل تقسيمات هذا المجتمع، وبكل مجالات عمل هذه النفس.
كل محور سيتم تشكيله من مجموعة من حلقات الأهداف المرحلية والنهائية، صياغةُ هذه الأهداف لا بد أن تُراعَى فيها إمكانات الشخص الذاتية، وفرصُه المتاحة لتوظيف إمكانياته، وطبيعةُ بيئته ومجتمعه.
في كل ذلك ومعه يكون دور المعرفة والعلم؛ فالمعرفةُ لحياة الإنسان عمومًا، وللمشروع الحياتي خصوصًا أشبه بالغلاف الجوي، لا تتنفس أيةُ مرحلة من مراحل حياة الإنسان، ولا أيُّ محورٍ من محاور مشروعه؛ إلا من خلاله، وهي الوقود المُغذِّي وآلة التطوير لهذا المشروع.
لا بد أن تترك هذه الانشغالات اليومية التي تأكلك أكلًا، وتَنحِت أيامك نحتًا، وتغرَق أنت فيها جميعًا دون أية حصيلة إنجازٍ طويلةِ الصلاحية!
أنت تحرق نفسك وعمرك بهذه الصورة.
| استعن بالله عز وجل، واكتب، وأكثِر من الكتابة: من أنا؟ وما إمكانياتي؟ وما ظروفي؟ وما الذي أُحسِنه وأتقنه؟ وما الذي ينقصني؟ وما الذي يحتاجه الناس من حولي أستطيع نفعهم به؟ |
وكيف يمكن أن أكون؟ بحيث ألتفت إلى ما مضى من حياتي عند موتي؛ وأقول: هذا حسنٌ، قد فعلت ما أستطيع.
الطريق من هنا.





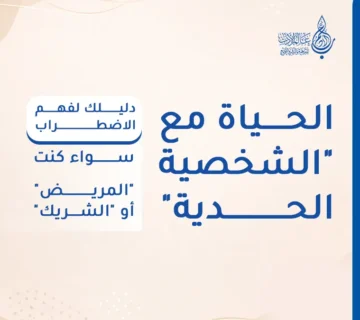

لا يوجد تعليق