للدكتور إريك فروم
مؤلف كتاب (المجتمع العاقل)
تجلت في الآونة الأخيرة حاجة الناس إلى الإحساس بالأمن، باعتباره الهدف الرئيسي للحياة، وجوهر الصحة العقلية.
وقد تجلت هذه الحاجة على الخصوص في الآباء الذين بدأوا يستشعرون القلق خشية أن يفتقد أولادهم وبناتهم في مستقبل أيامهم الإحساس بالأمن، ومن ثم راحوا يبذلون قصارى جهدهم في تجنيب أولادهم أسباب الصراعات والمشاكل، آملين أن تمضي حياتهم سهلة آمنة…
تمامًا كما يعمدون إلى تطعيم أطفالهم ضد الأمراض، ويحرصون على إبعادهم عن مواطن العدوى، والجراثيم! ولكن النتيجة في الحالين غالبًا ما تدعو إلى الأسف فالمبالغة في الاحتياط تفقد المرء- جسمًا ونفسًا- المناعة، وتجعله أسهل قابلية للمرض!
وهل يمكن أن يحس الإنسان الحي، المتوقد الإحساس، بالأمن؟
إن الظروف التي تحيط بنا، توشك أن تجعل الإحساس بالأمن ضربًا من المستحيل.
فأفكارنا وآراؤنا واستنتاجاتنا في أفضل صورها- ليست إلا جوانب وحسب من الحقيقة، مختلطة بأكبر قدر من الأخطاء! وحياتنا وصحتنا خاضعتان منذ مولدنا لمجموعة من الصدف والظروف التي لا سيطرة لنا عليها..
وفي كل مرة نتخذ فيها قرارًا، لا نستطيع أن نجزم بما يتمخض عنه هذا القرار، بل أن أي قرار نتخذه ينطوي ضمنًا على احتمال الفشل.. ومهما نبذل من جهد فإننا لا نستطيع أن نضمن النتائج سلفًا.. فالنتائج تتوقف على عناصر أبعد من أن نستطيع السيطرة عليها..
وتمامًا كما أن الإنسان الحي، المرهف الحس لا يستطيع أن يتجنب الشعور بالخوف، فهو- بالمثل- لا يستطيع أن يتجنب افتقاد الإحساس بالأمن..
والوقاية النفسية التي يستطيع المرء- بل يجب- أن يأخذ بأسبابها، ليست السعي لبلوغ الإحساس بالأمن، وإنما التكيف لظروف الحياة بحيث يغدو المرء قادرًا على احتمال الشعور بافتقاد الأمن أن يصيبه الذعر والارتياع، والاضطراب!
* * *
والحياة- بمقوماتها وطبيعتها غير مستقرة ولا آمنة.. شيء واحد فقط هو الذي نستطيع أن نجزم به، وتملؤنا حياله الثقة وذلك هو أننا نولد ونموت!
ولن تجد أثرًا للإحساس المطلق بالأمن، ولا حتى بين الممتثلين امتثالًا تامًا لكل ما تأتي به الأقدار ويدعون للأقدار أمر اتخاذ ما تشاء لهم من قرارات، دون أن يتكبدوا حتى مسئولية اتخاذها!
ولكن الإنسان الحي، المتحرر الفكر، المرهف الحس، على نقيض القدري المتمثل، ومن ثم فهو أبعد ما يكون عن الاستقرار والإحساس بالأمن.
فكيف إذن يمكن للإنسان العصري المفكر، أن يحتمل افتقاد الإحساس بالأمن؟
في وسعه أن يبلغ هذا الهدف إذا استطاع أن ينمي شخصيته الحقيقية بمميزاتها، وقدراتها، وإمكانياتها، بحيث يسعه أن يقول صادقًا (أنا)!..
وهو خليق بأن يصيب هذا الهدف إذا نما قدراته الإنشائية إلى درجة تمكنه من الاتصال بالعالم الخارجي دون أن يغرق في خضمه ويتوه في زحمته.
ولا نقصد بذلك أن يعتزل المرء الناس، فالشخص المنعزل يجتني إحساسه بالأمن من السير في ركاب الآخرين ما أمكن..
وهدفه الرئيسي هو أن يكون وفق ما يرغبون له أن يكون!. ولو حاول أن يختلف عن الناس فسيحس بالعجز والدونية، وهو إحساس يسلبه الشعور بالأمن!… وفي الوقت نفسه فإن سلوكه الذي يستهدف مطابقة سلوك الآخرين، يسلبه أيضًا إحساسه بالأمن، فهو يتفقد الإحساس بالأمن في الحالين لأنه لم يتعلم كيف يكون نفسه، وينطلق على سجيته… فأي نقد يوجه إليه يشعره بأنه شذ عن المجموع، ويوقظ فيه الخوف والإحساس بالذنب، ويثبط عزيمته، ويقوض ثقته في نفسه.
* * *
وكما أن الإحساس بالأمن أساس من أسس الصحة العقلية، فإن من أسسها أيضًا الحب… حب الزوج للزوجة، وحب الزوجة للزوج، وحب الوالدين للأطفال، وحب الفرد للناس، وحب الناس للناس.. فالرضا الذي يجنيه المرء من إغداق الحب، ومن إحساسه بأنه محبوب كل ذلك أساس جوهري من أسس الصحة العقلية.
فإذا غداك الإحساس بالأمن، وغداك الحب، كنت أقرب إلى أن تصبح إنسانًا سعيدًا..
* * *
ولكن ما هي السعادة؟
قد يجيبك أكثر الناس عن هذا السؤال بقولهم أن السعادة هي المتعة وأن السعيد هو الذي يقضي وقتًا ممتعًا..
فما هي المتعة؟
أهي ارتياد المجتمعات، ولعب الكرة، والاستماع إلى الراديو، والذهاب إلى السينما، وقيادة السيارات، والبقاء في الفراش إلى ساعة متأخرة من صباح أيام العطلات، والسفر، والرحلات..؟!
إذا كانت هذه هي مقومات السعادة، فهي إذن مرتبطة بمنابع اللذة، وعلى هذا يمكن أن نعرف السعادة بأنها عكس الألم والحزن..
والواقع أن الرجل (العادي) يرى السعادة في تحرر عقله من الحزن والهم… وهذه النظرة تطلعنا على مدى الخطأ في اعتبار السعادة عكس الحزن، والأسى، والهم. فالرجل الحي، النشط المتوقد الذهن والحس لا يستطيع أن يتجنب الحزن، أو في الأسى أو الهم مرات في حياته!.. لا بسبب المتاعب التي يسببها له النظام الاجتماعي فحسب، بل أيضًا بسبب الطبيعة البشرية التي تجعل من المستحيل أن ينجو المرء من الإحساس بالحزن والأسى، والهم. فطالما أن الموت حقيقة ثابتة وطالما ندرك أننا سنموت قبل من نحب، أو سيموتون هم قبلنا.. وطالما نرى التعاسة، والضياع، والتفاهة من حولنا كل يوم، فكيف يمكن أن نتجنب خبرتنا الدائمة المتجددة بالألم والحزن؟!
وأي مجهود نبذله لاجتناب هذه الإحساسات، إنما هو في الواقع مجهود نبذله لاجتناب الانفعال بالحياة، والتأثر بها، وهو هدف- كما ترى- لا يمكن بلوغه!
ولو أننا أردنا أن نعرف السعادة بمقابلتها بما يناقضها فينبغي أن نقول أن السعادة ليست عكس الحزن، وإنما هي عكس الكآبة.
فما هي الكآبة؟
إن الكآبة هي الرغبة في ألا نحس!.. هي الرغبة في أن نشعر بالموت، ونحن في أوج الحياة! الرغبة في عدم الاستمتاع بالسرور، حتى في الوقت الذي يدعو فيه كل شيء حولنا إلى السرور!
إن الرجل المكتئب يحقق راحة عميقة إذا استطاع أن يشعر بالحزن!.. وذلك أن الاكتئاب حالة يصبح فيها المرء غير قادر على الإحساس بشيء.. لا الفرح.. ولا الحزن!
وإذا كانت السعادة عكس الاكتئاب فهي إذن الانشراح أو الابتهاج.. وهو إحساس نحسه حين نعمل عملًا إيجابيًا.
نحسه حين نغدق الحب.. وحين نستخدم العقل فيما يجدى وينفع.. وحين نقف على أرض الواقع ونرى أنفسنا وحدات متميزة مستقلة، تكون مع سائر وحدات هذا العالم.
* * *
السعادة هي إذن نشاط داخلي وشعور متزايد بالرغبة في تنمية علاقاتنا بأنفسنا.. وبالناس.. ويتبع هذا استحالة وجودها مع المشاعر السلبية.
إنها الشعور بالامتلاء، لا بالفراغ الذي يحتاج لمن يملؤه.. وهذا هو هدف الإنسان في الحياة.
إن هدفنا من الحياة هو أن نحياها كاملة.. وأن نحس بوجودنا، وأن نكون يقظين منتبهين.. وأن نتحرر من أحلام الطفولة تدريجيًا لنواجه قدراتنا الحقيقية، ونعرف حدودها…
أن تكون لنا القدرة على أن نحب الحياة.. وأن نقبل- في نفس الوقت- الموت بلا رعب.
أن نواجه الشك الذي تثيره ظروف الحياة، دون أن نفقد ثقتنا في أفكارنا، وإحساساتنا طالما أنها تمثل حقيقة عقولنا.
أن تكون لنا القدرة على أن نكون شيئًا مذكورًا سواء وحدنا، أو مع من نحب، أو مع كل أخ لنا على الأرض، أو مع كل شيء حي…
أن نتبع صوت ضميرنا.. ذلك الصوت الذي يرشدنا إلى أنفسنا.. وألا نمقت أنفسنا إذا لم يصل صوت الضمير إلى أعماقنا.. وألا نفقد الأمل في أن نسمعه، ونتبعه في المرة القادمة..
إن الشخص السعيد هو الذي يحترم الحياة: حياته هو، وحياة الآخرين.
– نُشر أولًا بموقع حياتك.


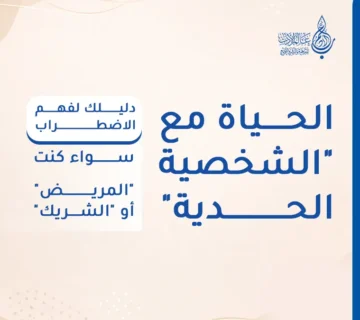



لا يوجد تعليق