لماذا لا تدوم المشاعر الدافئة في العلاقات؟ … لماذا لا نجد بعد الزواج مشاعرنا التي دفعتنا له؟
لماذا «نبذل الجهد الكثير للوقوع في الحب، لكن لا نبذل الجهد الكافي للبقاء فيه!» كما يقول إريك فروم؟
بل إن هناك سؤال أكثر عمقا … لماذا تبدو العلاقات العابرة أكثر دفئا من تلك التي يربطها عقد الزواج؟!
هذه كلها استفسارات تعبر عن أن حميمية الصداقة تفتر بعد الزواج، ويشكو الأكثرية أن أزواجهم ليسوا هم أولئك الذين أحبوهم حين ارتبطوا بهم! فأين إذن ذهب الحب، أم أنه لم يكن كذلك في البدء؟ وإن كان حبًا حقيقيًا فكيف ضاع؟!
من رؤية بيولوجية، ترى هيلين فيشر أن لدينا ثلاثة أنظمة من الدافع العاطفي:
– الانجذاب «الهرمونات الجنسية».
– الحب «هرمون الدوبامين».
– الارتباط «هرمون الأوكسيتوسين».
ومن نظرة تطورية ترى أن غاية «الانجذاب» هو شد انتباهنا إلى الآخر، ثم ينشأ «الحب» فتتحرّك طاقتنا الوجدانية بتركيز على موضوع «شخص/ آخر» واحد، والهدف من «الارتباط» (attachment) هو المحافظة على محبتنا لذلك الآخر.
هل تشعر أن حرارة مشاعر فترة الخطوبة قد انطفأت وتركت مكانها برودة الاعتياد؟
أو السؤال الدائر في الغرب: «لماذا يقتل الزواج الحب؟!» وما السر في اعتياد العلاقة، وفي الأمان الزائف الذي يمنحه عقد الارتباط، مما يجعلنا نتصور أن هذه العلاقة هي ارتباط أبدي يجعلنا نهمل في رعاية الحب، ونقصر في تأجيج المشاعر، بالصورة التي كنا عليها من قبل حتى لا يهجرنا الطرف الآخر، لكننا الآن في مأمن فنحن أثقلناه بتكاليف الزواج والمهر والمؤخر، أو يربطنا به عقد مؤبد، فلا مجال للهرب، هذا الشعور الزائف بالأمان يقتل الحب، لأنه يحمل في طبيعته مخاطرة وانفتاحًا وقبولًا لاحتمالية الفقد والرفض، وربما هذا هو سر لذة الحب!
تبدو هذه المعادلة غير منطقية، لكنها مع الأسف صياغة واقعية نرى آثارها بأعيننا، فالنهاية غير المكتوبة لـ «نظرة فموعد فلقاء» ليست على ذات المسار دائمًا، فلم يعد القمر يعكس وجه الحبيب، ولا تطول الساعات في غيابه وتُختصر عند حضوره، كلها تساؤلات ترمي بحياة ما بعد الزواج إلى الفتور، نستكمل الطريق إما وفاءً لعقد الزواج، أو صيانة للأبناء، لكن أين الوفاء لمواثيق الحب، قليلًا ما تبقى، حينها يكون الولاء للعلاقة وليس لأشخاصها!
- التعلق المرضي:
واحد من أهم خوانق الحب هو التعلّق المرضي، أو الاعتمادية العاطفية، فيشعر الاعتمادي أن أمانه الداخلي يعتمد على وجود الشخص الآخر.
وغالبًا ما ينشأ الاعتمادي في بيئة خالية من الحب، فهو شديد العطش لكثير من المشاعر، وهذا يضعه في احتمال تحوله إلى مصاص للمشاعر من الطرف الآخر، أو بمعنى آخر «عَلَقة عاطفية».
والمثال الأشهر لهذه الحالة هو ما ذكرته إحداهن: «كان زوجي يمثل لي كل شيء، الأب والأخ والزوج والحبيب ثم توقف كل هذا، لقد أدركت أنني قد أستنزف طاقته ومشاعره، لكنني أدركت ذلك متأخرًا» … هذه شكوى ليست بالنادرة، ومن كلا الطرفين، فهذا الارتباط من أجل التشافي لا يخلق زواجا ناجحا، وإنما ينقل الاضطراب إلى البيت الجديد، فطرفا الزواج لا ينبغي لهما أن يلعبا دورًا آخر في حياة كليهما، زوجًا وزوجة لا أكثر.
وكما عرّفنا العلاقات الاعتمادية، فهي نمط لا يكون مركز الأمان خارج صاحبه، فالآخر هو من يحقق له الاستقرار النفسي، وهذه صورته المجردة «لا أستطيع الحياة بدونك»، أما الصورة السلبية فهي: «أنا لا أحتاج لأحد» وهو شعار يخرج كرد فعل نتيجة التطرف الآخر.
وعكس هذه الحالة هو النرجسية، وهي حين يشعر الفرد أن الآخر لا يمكنه الاستغناء عنه، وأحيانا تكون هذه المركزية الذاتية نتيجة للاعتمادية وشكلًا من أشكال التواطؤ، حين يستعذب الفرد مهمة الإنقاذ التي ألقاها عليه الطرف الآخر، فهو الأب والأخ والابن والزوج، وشيئًا فشيئًا لا يعود مرحبًا بهذا الثقل، فيتوقف عن اللعب إذ إن مجرد وجوده هو ما يعطي معنى للحياة، فيكف هو عن سقاية المشاعر معتمدًا على احتياج الآخر له، وهو ما يدخل ضمن الشح العاطفي!
الشح العاطفي:
ما أشرت إليه قبل قليل هو أحد مسببات الشح العاطفي، وهو الاستنزاف، حيث يجد الشخص هنا أنه ليس لديه المزيد ليمنحه، بل يبدأ في الشعور بأن هذه العلاقة أصبحت حملا يضغطه وليست اختيارًا.
لكنّ هناك نوعًا آخر من الأفراد تكون بيئة النشأة لديهم خالية من المشاعر أيضا، غير أنّ استجابته تكون بإسقاط الحق في منحها واستقبالها، فهو فرد جامد لا يستطيع إدراك مشاعره فضلا عن التعبير عنها!
ما نحتاجه إذًا هو أن نراجع أنفسنا، علاقاتنا، ارتباطاتنا … لماذا اختلفت؟ وهل فقدت الوقود الذي يدفعها لتستمر؟
والخطأ الشهير هو الظن بأن هناك من لا يحتاج إلى هذه الوقفة، لماذا أفعل ما أفعله؟
ربما أيضا علينا أن نعتني بمشاعرنا، مجتهدين أن نتخلص من اعتياد الآخر.
وحتى نلتقي في مقال قادم، خذ واجبًا معك: قم بتأمل شريك حياتك واكتشف فيه شيئًا جديدًا، ربما نوع العطر المفضل لديه، ربما لون حذائه الجديد، ربما عدد الخطوط البيضاء التي تنبئ بعمر قد عشناه معًا!
– نُشر أولًا بموقع صحتك.





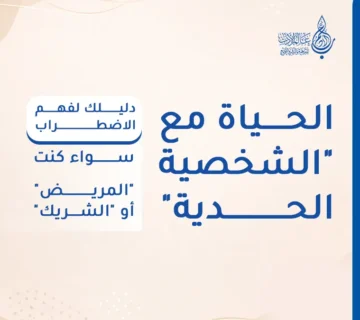

لا يوجد تعليق