(قالوا: إن مَلِكًا طلب من علماء بلاطِه أن يُلخِّصوا له تاريخَ العالم في جملةٍ واحدة، فلخَّصوه له في تلك الجملة: يُولَدُ الناسُ.. يتألمون، ثم يموتون.
حسنًا أنا أحب أن أقولَها بهذه الطريقة: يُولَدُ الناسُ.. يُجبِرُ بعضُهم بعضًا على الألم، ثم يموتون).
مارك توين.
(1)
– ((أُمّال لمّا أختها قمر كدا، مرات أخوكي طالعة لمين كدا: تخينة وسودا ومناخيرها كبيرة)).
في البداية لم يستطع أن يفهمَ هذا التعليق الذي قالته عمَّتُه عن أمِّه بعد أن غادرت خالتُه الغرفة، استطاعَ أن يفهمَ أن عمَّتَه معجبةٌ بجمال خالته الملحوظ، واستطاع أن يفهم أن الكلام هنا انتقادٌ لشكلِ أمه، وأن عمته تُقارن جمال خالته بما تراه قُبحَ أمه -زوجة أخيها-، لكن رَغم ذلك لم يستطع أن يستوعبَ هذا التوصيف، وحتى عندما يسترجع هذا المشهد الآن، ويقارنه بصورةِ أمه الباقية في ذهنه بعد وفاتها= لا يساعده ذلك.
1- أمُّه ممتلئةٌ –نوعًا-، وقصيرة، لكنها ليست سمينة لهذه الدرجة.
2- سمراءُ نعم، لكنها سُمرةٌ لطيفة ليست داكنة، ومع ذلك هو لا يرى أية مشكلة في كونها داكنة.
3- الأنفُ ليس صغيرًا ولا مستقيمًا، ويمكن أن يكونَ كبيرًا لكنه -بلا مجاملةٍ لأمه- لا يشك أنه متناسقٌ مع باقي ملامح وجهها، ولو لم يكن متناسقًا، هو أيضًا لا يدري كيف يكون هذا عيبًا في أمه.
بالتأكيد لم تكن أمُّه في نصف جمال خالتِه، لكنه لم يرَ أنها قبيحة، في الواقع كانت امرأةً تهتم بشكلها ولبسها، نظيفةٌ جدًا، لم يشتكِ منها أبوه قط، وهي فوق ذلك لطيفةُ المعشر، حسنةُ الخلق، جيدةُ التربية في حدود ما يسمح به تعليمها، وكانت بالفعل تُحسِن معاملتَه، ومعاملةَ أبيه، وأهل أبيه؛ الذين ينهلون من كرمِ ضيافتِها ويسبُّونها الآن، ولو كانت وفق ذوقِ أيِّ شخصٍ أو معايير أيةِ جماعةٍ= قبيحةٌ، لماذا يكون هذا وسيلةً للذم أيضًا؟!
لكن التساؤل الأهم هو ما ظل يكبُر داخل نفسه من يومها: لماذا تتكلم أنثى عن أنثى بهذه الصورةِ أصلًا؟
وعندما استطاع -بنصيحةٍ مني- أن يُكسِبَ سؤالَه المصطلحاتِ الكافية التي تجعله يشبه الأسئلةَ العميقة التي يحرصُ الناسُ على الاحتشاد لجوابها= سأل نفسه: ألا تليق تلك النظرة للمرأة بعقلٍ ذُكوريٍّ لا يرى في المرأة إلا جسدًا، ولا يستطيعُ الحكم عليها إلا كـ”مانيكان”؟
بعد ذلك بزمن طويل استطاع أن يجدَ الجواب، وإن كان يشك في قدرته على صياغته بصورة تُعبِّر بصدقٍ عما في نفسه من بُغضٍ لذاك الجواب.
(2)
مواقعُ التواصل الاجتماعي العربية تشيعُ فيها ظاهرةُ الصُّور النسائية المُستعارة، وهذا مفهومٌ طبعًا أنه يحدث لعوامل دينية واجتماعية ونفسية، لكن كم مرة رأيتَ امرأةً تبغضُ ذكوريةَ الرجال، ونظرتهم للجسد، وهي مع ذلك تستعمل صورةً لامرأةٍ عادية الجمال؟
جميلٌ هو الدفاع عن حق المنتقبات في اتخاذ قرارهن بخصوص زِيِّهن وشكلهن بلا تدخُّلٍ سُلطَوِي، أو ثقافي عنصري ومتحيز، لكن السؤال المحير: لماذا تتمتع كلُّ صور المنتقبات التي يتم تداولُها في هذا السياق بحسٍّ انتقائي ظاهر، يحرص على جاذبية الصورة، وزيادة جرعة الـ”كيوتنِس” والبراءة، وأحيانًا الجاذبية.
فئةُ المنتقبات اللواتي لا يبدو تنسيقُ لِباسهنَّ بهذه الجاذبية، لماذا يتم استبعادُهنَّ من هذه الصور التسويقية؟!، ولماذا تقول إحدى المنتقبات لأختها على صفحة فيس بوك: ((إوعي تلبسي النقاب والعباية والملحفة زي الستات المدهولين دول))؟!
الصورُ الحقيقية أو الكارتونية اللَّطيفة لصفحاتِ (لن أتزوج إلا ملتحٍ، ولن أتزوج إلا منتقبة أو محجبة)= كلها صورٌ أنيقة لرجالٍ وسيمين، -وسيمين أُوفر الحقيقة-.
في رحلة صعود أحمد زكي الممثل المصري المعروف، هناك مرحلةٌ دائمًا تستوقفني، يحكيها أحمد زكي دائمًا بعبارةٍ موجزة كأنما يريد أن يَفرَّ من أمامها: ((الواد الأسود ده جايبينه يعمل إيه هنا؟!)).
يتذكرُ القاهريون أزمةَ الإخوة السودانيين وتجمعاتهم في القاهرة من قرابة عشر سنوات، وقتها كتب أحدُ الصحافيين المِصريين عن عنصريةِ بعضِ المصريين في التعامل معهم، -وإزاي السواق داكن البشرة بيشتكي له من العيال السودا المعفنة اللي عاملين قلق-.
عنصريةٌ ضدَّ السود في العالم العربي؟!
نعم يا سيدي، من المحيط إلى الخليج، وفي مجتمعات أكثرُها فعليًا من داكني البشرة وفقًا للمعايير العرقية= نحن نملِكُ قدرًا عظيمًا من العنصرية ضد داكني البشرة، نملك قدرًا يُثير عَجَبَ أيِّ أُورُوبِّيٍ أو أمريكي، بل هو عندنا أشدُّ أذًى لهؤلاء؛ فَهُم هناك لا يعدمون من معايير التقييم ما يسمحُ لهم بتقدير أنفسهم، وتظل لهم أُطُرُ العيش التي تعينهم على التعامل مع ما يلقون.
نعم، هو عندنا أشدُّ أذًى؛ لأن تلك المجتمعاتِ لا زالت تحاول مقاومةَ هذه الأخلاق، ولو على المستوى الإعلامي والثقافي، ونحن هنا -حتَّى- لا نملك وعيًا كافيًا بالأذى الذي نتسبب فيه، فكيف نرتقي لنُداويَ أثرَه؟!
الأذى النفسي للأطفال البُدَناء، هذه ظاهرةٌ عالمية بلا شك، وهو أذًى يَصعُبُ تجاوُزُه في أحيانٍ كثيرة، وبلا شكّ من الأصعب تفادي وقوعِه.
–لكن ما تفسيرُ تحوُّلِه لأذًى مقصودٍ ومُتعمَّد عندما نَكبُر، وهو عندنا لا يُستعمل فقط كوسيلةِ سَبٍّ لأُناسٍ نتنازع معهم، أو لا نعرفهم، كما يقع في الدنيا كلها= بل كوسيلة للخطاب داخل دوائر القرابة والرحم والأصدقاء؟!
=ما هذه الأسئلة؟!
–أبدًا يا سيدي، إنها نفسُ السُّؤال الأول الذي افتتحت به كلامي هنا، والجواب للأسف عنها جميعًا واحد.
(3)
حبُّ الجمال شيءٌ فُطِرنا جميعًا عليه، ومهما اختلفت معاييرُ الجمال عبر الأزمنة والأمكنة، ومهما تنوعت أذواقُ الأشخاص فيه، فسيبقى لكل جماعةٍ من الناس رؤيتُهم المتقاربة لحدودِ الجمال والقبح، واللهُ نفسُه جميلٌ، يحب الجمال، لكن لم يأتِ هذا الحديث قط في سياق الجمال إلا حيثُ يكون هذا الجمال مُكتسَبًا، يقدِرُ الإنسانُ على تحصيله بِحُسنِ الهيئة وطِيب الرائحة، وهو نفسُه سبحانه أعطانا مفتاحًا عظيمًا لهذا البابِ كله، أنه مهما كان هواك للجمال، ونفورُك الطَّبعِي مما تراه قبحًا= لا يصلح أن يتعدى هذا الخواطرَ العابرة، التي يتم دفعها عن النفس سريعًا ليكونَ معيار العدل والحق والتعامل بين الناس: «إن اللهَ لا ينظرُ إلى صوركم وأشكالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
ليس من العدل أن نطلبَ من الناس خوضَ حربٍ مُجهِدةٍ مع الخواطر التي تعرض لنفوسهم، وتُوَلِّدُها قوالبُ أذواقهم وطباعهم، لكن المسؤوليةَ الإنسانية عن فعلِ الخير، والقيام بالعدل، وجمال النفس= تقتضي أن يخوضَ الإنسانُ تلك الحرب مهما كانت مُجهِدةً؛ لأجل ألا تُؤديَ به عوارضُ طباعه لإيذاء الخلق، ثم إِلفِ هذا الإيذاء، حتى يتحولَ به الإنسانُ إلى حيوانٍ ذي نابٍ ينهش النفوسَ فَيُدميها بأشد مما تؤذيها السباعُ الضارية.
نعم. هذا هو جواب السؤال: نحن نختارُ باختيارٍ مستقلٍّ وواعٍ ومُتعمَّدٍ أن نتفنَّنَ في الأذى، وأن نَدَعَ لأهوائنا منصَّة المعايير التي ينبغي أن تَضبِطَ أقوالنا وأفعالنا؛ والهوى إذا استولى على تلك المنصة أَفسَدَنَا، وأَفسَدَ أقوالَنا وأفعالَنا، وأخضعها لعاطفةٍ غير رشيدة، وذوقٍ ذاتيٍّ، إن أمكن أن نتسامح معه في دائرة الخيارات الشخصية المباحة= فإنه لا يسعُنا أن نتسامح معه إذا أراد أن يتحول إلى قانونٍ تُعامَل به الناس فيضرهم ويؤذيهم، بعد أن يُفسِد روحك ويحرِق إنسانيتك التي يحبها الله.
الجواب: أننا نخوض الحياة، قد أعطانا اللهُ سبيلًا لنفعِ الناس، والإحسانِ إليهم، وطلبِ رضاه بطيب القول وجميل العمل، ثم إننا نختار أن نُعرِضَ عنه، وفي لحظةٍ تتكرر في اليوم عشرات، وربما مئات المرات، نَدَعُ زِرَّ التحكم لِيُسيطرَ عليه ذلك الجانب منّا، الذي لا يُحسِن اختيارَ شيء إلا الطريق الغلط.
ومِن أقبحِ ما أرى من أخلاق الناس، وأكثرها إثارةً لعَجَبي، أن يَصدُرَ من متدينٍ= السخريةُ من قبحِ الشكل.
فأنت تؤذي خلقَ اللهِ لشيءٍ لا يدَ لهم فيه، وأنت تعمَى مع هذا عمَّا قد يكونُ اللهُ رزقهم إياه من جميلِ الخِصال، وكريم الأفعال.
كتب الرافعيُّ قديمًا مقالتَه العظيمة: قُبحٌ جميل؛ ليدلَّ الناسَ على سوء مسلكهم، وما فيه من ضعف الإيمان، وضحالة الإنسانية، ورَغم ذلك لا زلت ترى في الناس من يطلبُ إضحاك الناس، وأن يوصف عندهم بالظُّرفِ، ولا يجد طريقًا لهذا إلا هذا الفعل القبيح الذي لا يَرعى حقَّ المؤمنين، ولا مروءة الإنسانُ من حيث شرَّفه اللهُ وكلَّفه بالتعالي عن سفاسف الأخلاق وطلب معاليها.
لا تستهن بهذا قط؛ فإن أذًى تُوقِعه بقلب مؤمنٍ لربما أضاع عملك وأنت لا تشعر، وإن من أَجَلِّ أفعال الله التي يُؤمرُ المسلم أن يقتديَ بها= أنه سبحانه ينظر إلى أعمال الناس لا إلى صورهم.
نحنُ نُحسِن الشعارات، ونُحسن كتابةَ المثاليات عن الجمال الداخلي، لكن في الواقع نحن كحمقى ديزني، حيث يكون الدرس المستفاد من قصة الجميلة والوحش: أن نفسَ الوحش الداخلية لا تكون جميلةً حقًّا إلا إن كان في الأصل أميرًا مسحورًا، لكن الوحش الحقيقي لا يكون جميلًا أبدًا -هكذا نفكر نحن-، والأسوأ: أنه هكذا نُعامل الناس.
(4)
لسنا معصومين، وليس في بني آدم من لا يُذنب، وبالتالي: فالآدابُ والأخلاقُ في جميع مجالاتها، ليس معنى خطابك بها أن تحوزَها فلا تفقدها أبدًا.
وإنما معنى الخطابِ بها: أن تكونَ واعيًا بوجوب تحلِّيك بها، وأن تبذل وسعك في طلبها وإصلاح نقصها، ومجاهدةِ النفس لسرعة الأَوبَة عندما تزِل عن الخُلُقِ الحسن قدمُها.
معنى الخطاب بها: أن تخوض معركة التحلي بها، فتَغلِب، وتُغلَب، ومجموعُ ما تسجله من النقاط هو عيارُ فوزك -إن تغمَّدك اللهُ برحمته-.
لا يحاسب اللهُ الناسَ على توفيتِهم شُعَبَ الإيمان ومكارم الأخلاق كمالَ حقها؛ فإن ذلك يكاد لا يبلغُه أحد، ولذلك شرَعَ الله الاستغفارَ، وسؤال القبول والإعانة عقب العبادات.
وإنما الشأنُ والمحاسبةُ: على الوعي بالحق، ومجاهدة النفس على التحلي به، ودوام التوبة والاستغفار من كل سقطةٍ وذنبٍ ونقص.
نعم. نحن نحب المثالية، ويُعجبنا أن نظن أن فلانًا من الناس أحسنُ منا، وأنه لا يُخطئُ أخطاءنا؛ لذلك نحن نرجُمُه بكل ما نعرف ونجد من حجارة إن وجدناه -ويا للعجب- يغلط، أو يخالف قولُه فعلَه.
لكن الحقيقة التي ينبغي أن نحمدَ اللهَ على كونِها موجودة: أن الشخصَ المثاليَّ الذي لا تُخالفُ أقوالُه أفعالَه ليس موجودًا، وأن بابَ إعادة إصلاح الطباع، والوقوفِ بها من جديد على أول الطريق الصائب= ممكنٌ دائمًا، مهما بدا صعبًا -وهو لا يكون صعبًا في الحقيقة إلا بعدد الخيارات الغلط التي تُصِر عليها قبل أن تختار العودة، لكنه يظلُّ ممكنًا، وتعريفُ القنوط من رحمة الله، بأقرب عبارةٍ ممكنة: هو أن تظن أن تلك العودة ليست ممكنة.
نعم. يمكنك دائمًا أن تعود حيث يحبك الله، وأن تختار منذ اليوم أنك لن تدعَ المَيلَ العارضَ للشكل، والنُّفورَ العارض من الهيئة= يتحكمان في الطريقة التي تُعامل بها الناس، وأنك أبدًا ومطلقًا: لن تقولَ لأحدٍ من الناس كلمةً تؤذيه بها، وتجعله يعود إلى بيته كسيفَ الخاطر حزينًا، قد ساء تقديرُه لنفسه، وكلما حصل لك نقصٌ أو تقصيرٌ في الوفاء بهذا= فكن شجاعًا لتعترف بخطئك، وكن على قدرِ المسؤولية لتعود ثانيةً لوضعية الخيارات الصائبة، ولن يَمَلَّ اللهُ حتَّى تَمَلُّوا.
| إن المطلوبَ منك هو أن تختارَ ببساطةٍ هذا الخيار السهل: “من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت”. |





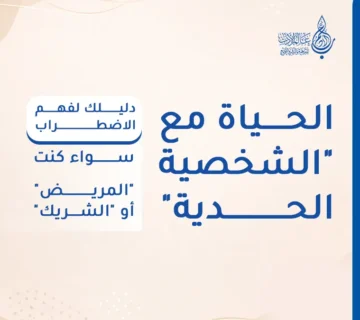

لا يوجد تعليق