للكاتب الهندي المسلم ك. ت. محمد
ترجمة الأستاذ صالح الغمراوي
كل من يشاهدني وينعم النظر في وجهي لا بد أن يستغرق في الضحك والسخرية! وكل من يعرفني يجد لذة غريبة في رواية القصص المضحكة عني لكل من يقابلهم من أصحابه…
وأنا أعرف كل ما يرددونه عني من قصص ساخرة… ولهذه السخرية سبب… وهو أنني أطوي بين جوانحي قلبًا نقيًّا طاهرًا يعرف الحب، ولأنني وقعت فعلًا في حب إحدى الفتيات!
إنهم يعتبرون هذا الغرام حادثًا فريدًا.. وقد فاتهم أنني لست إلا بشرًا مثلهم، له قلب يخفق مثل قلوبهم بالحب… برغم أنني قصير القامة، أسمر اللون، غليظ الشفتين، ضخم الرأس، ضيق العينين، مفلطح الأنف، ضيق الجبهة، طويل الأذنين..
نعم، إن هيئتي مجموعة منفرة من القسمات والملامح قل أن يوجد لها مثيل، حتى إن الناس كانوا يطلقون على اسم (الرجل القرد)!
ولكن الذي كان يغيظني أن الناس لا يسخرون من القرد، فما بالهم يسخرون مني؟! لعل السبب أنني آدمي له قلب حساس يهفو إلى الحب والجمال!
ولقد مات أبي كما سمعت وأنا في السنين الأولى من عمري لا أعرف معنى الحياة، ولا أفطن إلى دمامة خلقتي… وتركني في رعاية أمي.
ولكن من المسؤول عن دمامتي؟
أهو أبي الراحل؟ أم أمي؟ إنني لا أعرف على من منهما ألقي اللوم ولكن… لماذا أوجه إليهما اللوم؟ لقد ولدت وانتهى الأمر..
وعندما بدأت أعي الأمور كنت أرى أمي تبدو دائمًا حزينة مكتئبة.. وحين أستفسرها عن مبعث حزنها كانت تجيبني إجابات لا تشبع نهمي إلى معرفة الحقيقة.. ولكني توصلت أخيرًا إلى معرفة السبب…
فقد كنت سائرًا بصحبتها ذات يوم، ومررنا برجل عجوز أشيب الشعر، فما أن لمحني حتى نظر إلى في إشفاق، وتمتم ببضع كلمات، وصلت إلى مسامعي بصعوبة.. سمعته يقول: (يا للولد المسكين.. يا إلهي.. لم خلقته على هذه الصورة؟!)
وقد تألمت جدًّا من قول الرجل الأشيب ورحت أحاول أن أبدو أقل دمامة، بوضع المساحيق التي تستعملها النساء ولكن محاولاتي باءت بالفشل، فقد ازدادت سخرية الناس من هيئتي الجديدة!
ولا أطيل عليك.. فقد عثرت على الفتاة التي بادلتني حبًّا بحب.. ثم كللنا أخيرًا ذلك الحب بالرباط المقدس!
عثرت عليها بعد أن ناضلت أمي وجاهدت في سبيل العثور على زوجة لي بين من تعرفهن من بنات العائلات الكريمة الصديقة. ولكن بلا جدوى! فقد كانت كل منهن تأنف حتى من مجرد النظر إلى وجهي فتحطم قلب أمي المسكينة حسرة، وأصابها شلل لم يمهلها طويلًا، فقضت نحبها دون أن تكتحل عيناها برؤية عروس وحيدها وهي تمرح في بيته!
تركتني أمي وحيدًا لأناضل الحياة القاسية.. وبكيت عليها بكاء كاد ينضب ماء الحياة من عيني، ولكن المقادير أشفقت على، وساقت إلى من تبادلني حبًا بحب…
كنت جالسًا بمنزلي ذات يوم، وكان باب المنزل مغلقًا نصف إغلاق عندما سمعت صوتًا نسائيًّا يهتف قائلًا بصوت فيه ضراعة وفيه حزن دفين:
– أنا فتاة مسكينة أيها السيد، هل تجود عليَّ بإحسان؟
ونهضت من مكاني، ووقفت بالباب.. فرأيت شابة في عمر الورود، حلوة التقاطيع، مكتملة الأنوثة.. ترتدي أسمالًا بالية، كانت جميلة، فاتنة رغم ما يبدو عليها من الفقر ورقة الحال.. ولكني وقعت في حبها من النظرة الأولى، وشجعني على ذلك أنها كانت فاقدة البصر.. وأنها لا يمكنها أن ترى قبحى ودمامتي!
ورحت أفكر سريعًا، ثم وجدتني أقول لها:
– ادخلي يا فتاتي.. تعالي لنتحدث قليلًا..
وقدتها من يدهما إلى القاعة التي كنت أجلس بها.. وأجلستها على أحد المقاعد.. وكانت هذه أول مرة في حياتي ألمس فيها يد فتاة!
وقدمت إليها طعامًا شهيًّا، وسألتها عن اسمها فأخبرتني بأن اسمها (ليلى)، وأنها تعيش مع أمها في كوخ صغير بضاحية صناعية.
وحين نهضت لتغادر (شقتي) طلبت منها أن تأتي إليَّ من وقت لآخر لأنفحها ببعض المال، فابتسمت لي ابتسامة الرضى وشكرتني على مروءتي…
وتكررت زيارات (ليلى) بعد ذلك، وكنا نتحادث في كل شيء وكنت أثناء حديثنا أنظر في عينيها المظلمتين فيطغى على إحساس غريب، أن ظلام عينيها هو الذي جعل الدنيا تبتسم لي.. فلو كانت تبصر لنفرت من خلقتي وامتنعت عن زيارتي، شأنها شأن قريناتها من بنات حواء!
وسألت (ليلى) ذات يوم:
– ليلى.. هل أنت راضية عني؟
فابتسمت ابتسامة عذبة، وانفرجت أساريرها، وظلت صامتة لا تتكلم.. وحثثتها قائلًا:
– تكلمي يا ليلى.. تكلمي.. فقالت برقة بالغة:
– وهل قلت ما ينبئ عن عدم الرضا يا سيدي؟
وجمعت عندئذ أطراف شجاعتي لأقول لها:
– هل تشعرين بحبي لك يا ليلى؟
فامتلأ وجهها بحمرة الخجل، وأشاحت به إلى الناحية الأخرى، وتمتمت بكلمات غير مفهومة.. وكان منظرها فريدًا حقًّا، ينطق بآيات الحسن والفتنة.
ولما حضرت ليلى في اليوم التالي كنت قد قررت في نفسي أمرًا.. فلم ألبث بعد برهة قصيرة من وصولها أن سألتها قائلًا:
– ليلى.. هل تقبلين الزواج مني؟
فاهتزت كعصفور بلله القطر.. ولم تتكلم.. فسألتها مرة أخرى مستفسرًا.. وانقضت فترة قصيرة من الصمت قالت لي بعدها:
– أجل.. أقبل الزواج منك.
ولقد سمعت بعض الناس وأنا في طريقي إلى هنا ينعتونني بأني عشيقة (الرجل القرد) فعرفت أنك دميم الخلقة..
فاهتز بدني لسماع جملتها الأخيرة، وسألتها متلهفًا:
– والآن بعد ما سمعته.. بماذا تشعرين نحوي؟
قالت بهدوء:
– إنني لا أهتم بجمال الوجه، فليس عندي، وأنا عمياء فرق بين الجمال واليمامة، ولكني أرى جمال الرجل بقلبي فقط.
وبعد بضعة أيام تزوجت وليلى، رغم أنف جميع سكان الحي الذين تزايدت سخريتهم كلما شاهدونا سويًّا في الطريق!
ومرت شهور.. وبدأت زوجتي تشعر بأعراض الحمل.. وبدأت حياتي تتغير. كنت أشعر حقًّا بالسعادة لأني أصبحت محبًا، ومحبوبًا، وزوجًا.. وعما قريب سأصبح أبًا!
وسقطت (ليلى) مريضة قبل موعد الوضع بشهرين.. وحضر الطبيب لزيارتها فطمأنني على صحتها ثم سألني:
– هل فقدت زوجتك البصر في صغرها؟
فأجبته بالإيجاب، فاقترب من (ليلى) مرة أخرى، وطفق يفحص عينيها ثم قال:
– سآتي لزيارتكم غدًا مساء..
وفي مساء اليوم التالي حضر الطبيب وبرفقته زميل له من كبار أطباء العيون. وتقدم طبيب العيون منها وأخذ يفحص عينيها بدقة.. ولم يلبث أن نهض واقفًا والبشر يعلو وجهه ثم قال:
– أبشر يا سيد عبد الله.. أن من الممكن إعادة النور إلى عيني زوجتك بعد إجراء عملية دقيقة. ولكن ليس قبل أن تسترد صحتها من أثر مرضها الحالي..
وكانت كلمات الطبيب كخنجر حاد النصل غرس في سويداء قلبي!
إن ليلى لم ترضَ بي بعلًا إلا لأنها لا ترى قبح خلقتي.. فماذا يحدث لو عاد إليها نور عينيها؟ لا شك أنني سأفقد حبها.. وستسخر مني وتضحك كالأخريات!
ومر شهران.. ووضعت (ليلى) طفلًا جميلًا يشبهها كثيرًا، فحمدت الله على ذلك، فسوف لا يلقى المصير الذي عانيت منه..
وسألتني يومًا ونحن جالسان إلى مائدة الطعام:
– عبد الله.. ألا يجدر بك، وقد شفيت تمامًا، أن تذهب إلى طبيب العيون لتنفق معه على إجراء العملية؟
فما كادت تتفوه بكلماتها حتى شعرت بأن قلبي يكاد يسقط بين قدمي.. ولكني وجدت نفسي أجيبها مرغمًا:
– أجل.. سأذهب إليه الآن..
وارتديت ملابسي، وغادرت المنزل وأنا أشعر كأني تائه في بيداء واسعة.. ومكثت ساعتين بالخارج أجوب الطرقات على غير هدى، ثم عدت أدراجي وأخبرت (ليلى) بأن الطبيب قد مات منذ أسبوعين!
وشهقت (ليلى) مرتاعة لهذا الخبر، وبكت بكاء مرًا كنت أشعر له بوخز الخناجر! لم يكن أمامي إلا الكذب لأنقذ حياتي من الضياع.. برغم أن هذا الكذب أحال حياتي قطعة من السعير، سعير الإحساس بالذنب والأنانية، والقسوة البالغة!
وانقضت أشهر قليلة، وعدت إلى مسكني يومًا لأستقبل مفاجأة مذهلة… لقد اصطدمت (ليلى) أثناء سيرها نحو المطبخ بغير عصاها في (طشت) كبير للغسيل، فسقطت، واصطدم رأسها صدمة قوية بحافة الباب فشج، ونقلها الجيران الذين استغاثت بهم الخادم إلى المستشفى..
وأسرعت إلى المستشفى وأنا كالمجنون.. فليلى هي حياتي.. ودنياي.. ونعيمي.. ووقفت بجوار فراشها أربت يدها في حنان.. وكانت مستغرقة في النوم، ورأسها مختفٍ داخل الضمادات، وقد ازداد بياض وجهها حتى بدا كوجوه الملائكة.. وقبضت على يدها الصغيرة البضة ورحت أربتها برفق.. وأفاقت ليلى بعد برهة، ولكنها ظلت مغمضة والعينين ثم سمعتها تقول بصوت خافت؟
– عبد الله؟ هل حضرت؟
– أجل يا حبيبتي.. إنك بخير..
– عبد الله.. أود أن أفاجئك بشيء سوف يثلج قلبك..
فسألتها متلهفًا: – وما هو؟ قالت:
– إن أمنيتي الوحيدة التي كنت أتمناها دائمًا أن يرد الله لي بصري ولو دقائق قليلة، ثم لا يهمني بعد ذلك أن أعيش أو أموت…
– ليلى.. حبيبتي..
– ولقد حقق الله لي أمنيتي..
– كيف؟
لم أفهم ما كانت تقصده.. ولكني رأيتها تفتح عينيها كمن تنظر إليَّ.. ثم ارتسمت على وجهها فجأة دهشة بالغة، وارتجف جسمها.. فتعجبت لذلك، ولكن عجبي ما لبث أن زال حين سمعتها تقول:
– عبد الله.. لقد أصبحت في عداد المبصرات.. إنني أراك الآن..
وصعقت! وقلت كالمذهول:
– هل ترينني الآن بعينيك؟
وصمت لحظة، ثم قلت بصوت متحشرج كمن يوشك أن يلقى حتفه:
– ولكني أخشى أن تكرهيني وقد رأيت الآن منظري القبيح..
– عبد الله، يا حبيبي.. وزوجي.. إن صورتك النبيلة مطبوعة في قلبي بحروف من نور. ولن تُمحَى أبدًا من أمام عيني المبصرتين.. إن وجهك الذي تعده أنت ويعده الناس قبيحًا، أشعر أنا في قرارة نفسي بجماله!
وجثوت بجانبها، ورفعت يدها إلى شفتي، وأخذت أغمرهما بالدمع الغزير.. دموع الشكر والفرح!
حياة كاتب هذه القصة هي في ذاتها قصة إنسانية تضرب أحسن المثل على أن المركز لا يمنع الإنسان، وإنما الإنسان هو الذي يصنع المركز!.. فقد نشأ الكاتب الهندي المسلم (ك. ت. محمد) في أسرة فقيرة، لم تستطع أن توفر له التعليم، فتقلب منذ حداثته في المناصب الصغيرة، فعمل أولًا جنديًّا بالبوليس، ثم عاملًا بأحد المتاجر، وأخيرًا ساعي بريد… ولكنه استطاع بالداب والمثابرة على تثقيف نفسه، أن يغدو كاتب قصة ممتازًا، ظفرت أكثر قصصه بجوائز عالمية… منها هذه القصة التي فازت بالجائزة الأولى في مسابقة عالمية للقصة القصيرة نظمتها إحدى دور النشر البريطانية.





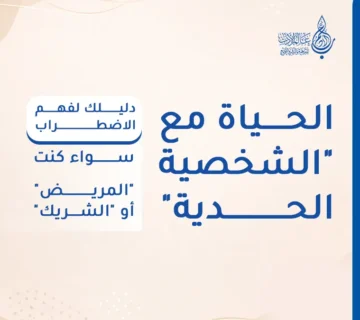

لا يوجد تعليق