((إن لم تكن حذرًا= فإن الصُّحُفَ ستجعلك تكره المقهورين، وتحب أولئك الذين يمارسون القهر)).
مالكولم إكس
(1)
في تاريخ الأمم كلها على اختلاف تنوعه؛ لم تبلغ مساحةُ الإعلام وتأثيره وصناعته للواقع ورهاناته= كما بلغت في أيامنا هذه.
لدينا أداتان أساسيتان هاهنا يتم توظيفهما:
الأولى: الوسائلُ التي تعتني بتوفير معلومات عن الحقائق لعموم الجماهير، وهي النشرات، والتقارير الإخبارية، وبرامج التوك شو، والبرامج التعليمية والتثقيفية الموجَّهة لعموم الجمهور.
الثانية: الثقافة الشعبية، والتي حلَّت بالنسبة للجمهور محل الفولكلور، وصارت هي أساطير الشعب، وقصصه، وصانعة خيالاته، وفي الوقت نفسه: تصوَّر له هذه الخيالات على أنها امتداد للواقع.
يقول هربرت شيللر: ((إن بنية الثقافة الشعبية التي تربط عناصرَ الوجود بعضها ببعض، وتشكل الوعي العام بما هو كائنٌ، وبما هو مهم، وما هو حق، وما هو مرتبطٌ بأي شيء آخر، هذه البنية أصبحت في الوقت الحاضر مُنتَجًا يتم تصنيعه))([1]).
وهو نفس ما يُصوِّره إريك بارنو -مؤرخ التليفزيون الأمريكي- على النحو التالي: ((إن مفهوم الترفيه، في تصوري، هو مفهومٌ شديد الخطورة؛ إذ تتمثَّل الفكرة الأساسيَّة للترفيه في أنه لا يتصل من بعيدٍ، أو قريب بالقضايا الجادَّة للعالم، وإنما هو مجرد شغل، أو ملء ساعة من الفراغ. والحقيقة أن هناك أيديولوجيةً مُضمَرةً بالفعل في كل أنواع القصص الخيالية، فعنصرُ الخيال يفوق في الأهمية العنصرَ الواقعيَّ في تشكيل آراء الناس)) ([2]).
وفي النظام السائد في العالم اليوم، فإن مضمونَ هذه الأيديولوجيا التي تتم عَوْلَمتها يحدده شيللر تحديدًا دقيقًا بقوله: ((ألوان الترفيه والتسلية المنتَجة تجاريًّا، هي الأدوات الرئيسة لنقل قِيَم الرأسمالية الأمريكية القائمة على الشركات العملاقة وأساليب حياتها… إن ما يشاهده الناس، وما يقرأونه، أو ما يستمعون إليه، وما يرتدونه، وما يأكلونه، والأماكن التي يذهبون إليها، وما يتصورون أنهم يفعلونه، كل ذلك أصبح وظائفَ يمارسها جهازٌ إعلاميٌّ يقرر الأذواقَ والقيمَ التي تتفق مع معاييره الخاصَّة، التي تفرضها وتعززها مقتضيات السوق))([3]).
ولا بد أن يكون واضحًا أن هاتين الأداتين: -المعلوماتية الشعبية، والثقافة الشعبية- يحدث بينهما تناسقٌ كبيرٌ جدًّا، خاصَّةً في القضايا الأساسيَّة والعظمى، والتي يهدد الاختلافُ فيها -إذا اتسع- تجانسَ المجتمع، ويهدد بالتالي الوحدة الصناعية للدولة الأمة.
والتناسقُ والتشابهُ والسيرُ في مجرىً واحدٍ في معالجة القضايا الكبرى، والذي تلحظه وأنت ممسكٌ بالصحيفة بنفس الدرجة الذي تلحظه في أفلام العام، ولا تجد ما يخالفه على المحطات التلفازية الكبرى إلا بصورةٍ شكلية= كل هذا يدلك على حقيقة أساسيَّة: ((إن التشابه الجوهريَّ في المادة الإعلامية وفي التوجهات الثقافيَّة التي تنقلها كلُّ وسيلةٍ من وسائل الإعلام بصورة مستقلة، يستلزم بالضرورة أن ننظر إلى الجهاز الإعلامي بوصفه وحدة كاملة))([4]).
يقول أدورونو وهوركهايمر عن هذه الوحدة: ((الوحدة الجذرية التي توحِي بها الصناعةُ الثقافيَّة تعلن بوضوحٍ ما يجري في السياسة؛ فالفارق بين الأفلام من الفئة (A)، أو من الفئة (B)، أو بين القصص التي تُطبَع في المجلات المختلفة الأسعار، لا يُقام على محتوى هذه الأفلام أو القصص بقدر ما هو لخدمة المستهلكين، ولإعادة تربيتهم؛ فقد وُضع لكُلٍّ ما يناسبه، حتى لا يستطيع أحدٌ الفلتان))([5]).
وينبغي التنبيه إلى أن تأكيدنا هنا على قضية الوحدة لا ينفي وجود الاختلافات، وهو ((لا يعني أن كل صانعِ أفلامٍ يلعب دورًا مشابهًا لأدوار الآخرين؛ فالاستجابات تختلف، ووظيفة النقد أن يرى موضع الاختلاف)) ([6]).
| والبصيرة بموضع الاختلاف هي التي تقود إلى فهم طبيعته، وهل هو دائمًا اختلافٌ جوهري أم هو اختلاف داخل إطارٍ ونطاقٍ محدَّدَين؟ وما هي طبيعة التعامل السلطوي مع الاختلاف الذي يجاوِز هذا الإطار المحدد؟ |
يقول بودريار: ((إنَّ السُّلطة تلعب لعبةَ الواقع، لعبة الأزمة، لعبة إعادة صناعة رهانات اصطناعيَّة اجتماعيَّة، واقتصاديَّة، وسياسيَّة))([7]).
وإعادة الصناعة هذه لا بد منها؛ فإن السلطة لا يمكنها أن تبقى مستقرة على قمةِ هرمٍ لا يتجانس معها، أو وهي تحكم مجتمعًا يموج بتنوعات في الرؤى والتصورات تؤدي لخللٍ في العلاقة والاتصال بين السلطة والمجتمع.
صناعةُ الرأي العام ينبغي أن يُنظَرَ لها نظرةٌ تراعي شمولية اشتغالها، فصناعةُ الرأي العام عظيمةُ الأثر في السياسة الحديثة من ناحية، وفي تكوين الدولة الحديثة من ناحيةٍ أخرى.
يذكر جوزيف كلابر([8]): ((هناك منطقةٌ أخرى يُمارِس فيها الاتصالُ الجماهيري تأثيرًا بالغَ الفعالية، وتتمثل في خلق رأيٍ عام فيما يتعلق بالقضايا الجديدة، وأعني بالقضايا الجديدة: تلك القضايا التي لا يملك الفرد حولها رأيًا محددًا، والتي لا يملكُ إزاءها رأيًا محددًا أيضًا أصدقاؤه، أو زملاؤه في العمل، أو الأسرة، والسببُ الذي يؤدي لفعالية الاتصال الجماهيري في خَلقِ مناخ من الرأي فيما يتعلق بالقضايا الجديدة واضحٌ تمامًا، فالفرد لا يملك مَيلًا مُسبقًا يدافِع عنه، وبالتالي فإن الاتصالَ يُهاجِم -لو جاز التعبير- تربةً غير مُحصَّنَة. وما إن يتم تخليقُ رأيٍ ما، حتى يصبحَ بمنزلة الرأي الجديد الذي يسهل بعد ذلك تعزيزه، ومن ثَمَّ يصعُب تغييره. وفضلًا عن ذلك، فإن عمليةَ تخليق الرأي هذه تكون فعالةً أكثر في حالة الشخص الذي لا يملك أيَّ مصدرٍ آخرَ للمعلومات حول الموضوع يمكنه استخدامه كمحك للاختبار، وبالتالي فإنه يعتمد اعتمادًا كليًّا، أكثر من غيره، على ما يُقدَّم له من معلومات حول الموضوع الـمُثَار))([9]).
(2)
إن الوعي بالحقيقة الصلبة التي حاولنا رسم معالمها في الفقرة الماضية= هو الذي يقودنا إلى أهمية صناعةِ وعي إعلاميٍّ، وإلى أهميةِ تكوين وإعانة الراغبين في حيازة تأهيل راسخ في الجوانب الإعلامية سواء كان هذا التأهيل نظريًا أو تطبيقيًا.
والوعي بوسائل وطرائق التأثير الإعلامي، خاصَّة ما كان منها تأثيرًا تشويهيًّا، أو مختزِلًا، أو غيرَ أمينٍ، أو غيرَ نزيه= هو من الأدوات المهمة التي تعين على صناعة الأفكار، وبذل الجهد، وابتكار الوسائل، وتكوين حالة القدرة والفاعلية في مواجهة هذا التشويه.
إنَّه شيءٌ أشبه بمعرفة المرض، وموطنه الأصلي، وأعراضه، ودرجة قوته، والفيروسات المسبِّبة له، كل ذلك مما يعين على مواجهته وعلاجه.
إنَّ الخطر الحقيقي كما نبَّهنا أكثر من مرة هو في الجُدُر العازلة، التي تُضرَب بين أي تيار ثقافي اجتماعي إصلاحي وبين المجتمعات، وإنَّ التشويه الإعلامي وتزييف الوعي، وتزوير الواقع، وصناعة الصور غير الأمينة وغير النزيهة عن جماعة من الناس= هو من أكبر وأعظم الجُدُر الفاصلة التي تُفسد ما بينهم وبين المجتمعات، وتقطع التواصل، وتسدُّ منافذ البلاغ.
والإدراك الإجمالي لوقوع التشويه لا يكفي هاهنا، فإنه يشبه أن تدرك إدراكًا إجماليًّا أنَّ هناك خطرًا، هل يغني هذا عنك شيئًا، حتى تعرفَ طبيعته، وقوته، ومداه، ومن أين يمكن أن يتسرَّب إليك، وأيُّ زِيٍّ سيرتدي حال تسربه هذا؟
إنَّ الوعي بذلك كله: طرائقه، وسبله، وأنماطه، ولغته، ورموزه، وإشاراته، وعلاماته، ومقولاته الأساسيَّة التي يتم صياغتها في شكلها الإعلامي الجادّ والترفيهي= هو أول ضربة مِعْول تدقُّ في أعناق هذه الجُدُر.
ولعل هذه الورقة التي قام على كتابتها مسؤولو المجلس الإعلامي بنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (مويك) بجامعة عين شمس= تكون لَبِنَةَ بدايةٍ وأساس للراغبين في هذا من المشتغلين بهذا اللون من النشاط .
([1]) هربرت أ. شيلر، ((المتلاعبون بالعقول)) ، (الكويت، عالم المعرفة)، (ص/113).
([2]) بواسطة: ((المتلاعبون بالعقول))، (ص/114).
([3]) ((المتلاعبون بالعقول))، (ص/204،214).
([4]) ((المتلاعبون بالعقول))، (ص/36).
([5]) ماكس هوركهايمر، وثيودور ف. ادورنو، ((جدل التنوير))، (( بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2006)، (ترجمة: جورج كتورة عن طبعة: ألمانيا، 2003)، (ص/144).
([6]) ((أفلام ومناهج))، (1/53).
([7]) جان بودريار، ((المصطنع والاصطناع)) ، (بيروت، المنظمة العربية للترجمة)، (ص/74).
([8]) مدير قسم البحوث الاجتماعيَّة بشبكة كولومبيا للإذاعة والتليفزيون.
([9]) بواسطة: ((المتلاعبون بالعقول))، (ص/234).


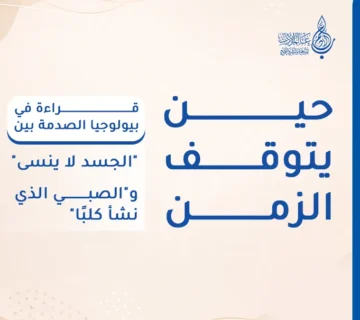
لا يوجد تعليق