إن فتق بابٍ من أبوابِ المعرفةِ على نحوٍ يُعيد الباحثين لساحة اشتباك التفكير في موضوعٍ ما = هذا هو أساسُ مفهوم الإبداع العلمي.
وفتحُ أفقٍ جديدٍ للتفكير والبحث في مسألةٍ ما، أو بابٍ ما، -ولو بمجرد إثارة الأسئلة- = هو من أشرف العلم؛ لأنه يَفتَح بابًا لزيادة العلم وزيادة بيانه؛ لأجل ذلك قال النبي ﷺ: «هذا جبريلُ عليه السلام، جاءكم يعلمكم دينَكم»، رغم أن جبريل لم يَزد عن السؤال؛ لكن لما كان السؤالُ فاتحًا لباب البيان= جُعل هو نفسُه بيانًا وعلمًا.
وكذا كل مسلكٍ يكون سببًا في زيادة الاهتداء؛ لذلك كان الصحابة يعجبهم أن يأتيَ الرجل من أهل البادية فيسأل النبي لما يفتحه ذلك لهم من أبواب بيان الوحي.
| ومفتاح الإبداع العلمي: إنما يكمن في إعادة التفكير مرة أخرى، وفي تقليل عدد المسلمات التي يبدأ الإنسان تفكيره من بعدها، واضعًا إياها خلف حاجز ما لا يُعاد فيه النظر. |
لكن فتح آفاق التفكير، ودوام المراجعة، وتكرار النظر، كل ذلك إن لم يكن يسير بالتوازي مع دوامِ الاطلاع، وجمعِ مادة النظر، وإن لم يكن مع دوام صقلٍ لأدوات المعرفة، فإن لم يكن كل ذلك يسير إلى جوار خطوات بناء منهج النظر والتحليل والتفسير= فهو بابٌ من أبواب الضلال عن الحق، مهما خدعك عن تلك الحقيقة أسماء التفكير والمراجعة والنظر التي سمى نفسه بها؛ ولأجل ذلك اعتَبر الصحابة أسئلة صبيغ بن عسل من باب الفتنة، وليست من باب سؤال الأعرابي الذي كانوا يفرحون به وكان يعجبهم.
فلدينا هنا ثلاثة أركان:
الركن الأول: الاطلاع وجمع المادة.
من الأمثلة التي تُضرب للسخرية من الفلاسفة، ما يحكونه أن أحدهم كتب كتابًا في التدليل العقلي على أن عدد أسنان المرأة أقل من عدد أسنان الرجل، وكان يُساق للتعليق على ذلك قول القائل: قد كان يكفيه أن يفتح فم امرأته فيعد أسنانها.
ربما ضربت هذه الحكاية سخرية ولا أصل لها، وربما سيقت أصلًا للتدليل على الفرق بين المنهج العلمي القائم على الحس والمشاهدة، وبين المناهج العقلية التجريدية، لكن كل هذا لا يمنع من أن نسوقها هنا للدلالة على طريقة سيئة شائعة في الناس= وهي أن يُدليَ كلُّ واحدٍ منهم بقوله أو رأيه بِناءً على ما عنده من معلومات قبْلية في الموضوع محلَّ النقاش.
ولو كان هذا الشخص متخصصًا متقنًا لموضوع النقاش= لأمكن فهم هذا، لكن غالب من يسلكون هذا المسلك يكونون من أبعد الناس عن هذا، وقد استَشْرت هذه الآفة في الناس حتى صار الرجل يقول برأيه في مسائل عِظام بِناءً على فتيلةٍ سوداءَ بقت في نفسه، أو سلخةٍ اهتبلها من محرك بحثٍ أو موقعٍ إلكترونيّ، وصار الناس يَعُدُّون نظرهم في المسألة بما في نفوسهم من معلوماتٍ قَبْليةٍ ناقصة، وأطراف علمٍ غير محقق، وقدرةٍ ذهنيةٍ على تشقيق النظر، دون أن يكونَ مع ذلك استيفاءٌ للنظر في مصادر المعرفة، جمعًا وتصنيفًا، وتنقية وموازنة= صاروا يعدون كل ذلك قولًا ينبغي أن يُسمع له، والواقع أنه نوعٌ من القول على الله بغير علم، ليس إلا.
وجمع المعلومات الكافية عن الموضوع محل البحث= هو الخطوة التي لا يستغني عنها عالمٌ أو متخصصٌ في أي نوعٍ من أنواع العلوم، بل وحتى الصناعات والحرف.
الركن الثاني: صقل الأدوات.
المقولات التي في كتب التنمية البشرية ومساعدة الذات؛ لا أثق كثيرًا بصحة نسبتها لأصحابها، لكني على كلِّ حالٍ أستفيد من مضمون هذه المقولات، بقطع النظر عن صحة نسبتها.
من تلك المقولات مقولة قرأتها منسوبة لإبراهام لِنكولن يقول فيها: لو كانت عندي عشْرُ ساعاتٍ لقطع شجرة= لقضيت ستًّا منها في شحذ الفأس.
هذه المقولة تعبر ببلاغة شديدة عن قضية مهمة، تنتشر أهميتها في مجالات الحياة كلها وهي: أن جزءًا كبيرًا من نجاحك وتوفيقك في بلوغ ما تحب= يعتمد بدرجة أساسية على جودة الأدوات التي تملكها: مواهبك ومدى قدرتك على صقلها، وأدواتك المعرفية والتقنية، ومدى قدرتك على تطويرها، وعلاقاتك، وبيئتك، وظروفك، ومدى قدرتك على تهيئتها، بحيث تكون عونًا لك.
والفكرة هنا: أنه كلما طال الوقت وزاد الجهد المبذول في تحصيل وتجويد الأدوات= كان ما بعده أيسر وأسهل.
إن أبواب العلم والمعرفة ليست استثناءً هنا؛ فلكل باب من أبواب العلم أدواته العامة التي يشترك فيها مع العلوم المجاورة له، وأدواته الخاصة التي تتعلق بالتجويد والإتقان فيه هو، وإن لم تكن من لوازم غيره من العلوم، وإتقانُ نوعيّ الأدوات هذين= هو الركن الثاني من أركان الإبداع في أي فرع من فروع المعرفة، فلا إبداع في علوم الوحي بلا إتقانٍ لأدوات تفسير النصوص -بعد التحقق من ثبوتها-، ولا إبداع في الفيزياء بلا إتقان للرياضيات، ولا إبداع في العلوم السياسية بلا إتقان لحصيلةٍ أساسيةٍ في مجالات الاقتصاد والاجتماع.
الركن الثالث: بناء المنهج.
لمنهج النظر واكتمال الحد الأدنى منه فضلٌ عظيم جدًا، وكل إنسان اكتملَ منهجه في النظر والتفسير، والتحليل والتركيب، والتقييم والاستنتاج= فقد اكتملت عدته العلمية، وأمكنه أن يكون له رؤية مستقلة في أي مسألة بمجرد أن تجتمع لديه معطياتها الأساسية.
وبدون منهج النظر: يظل الإنسان الذي حصَّل معطيات المسألة= أسيرًا لوجهات النظر المطروحة حولها، وقصارى أمره أن يتخير، أو يلفّق بينها، دون أي رؤيةٍ مستقلة.
وإصلاح المنهج هو وظيفة العمر، وهو نسق مفتوح يموت أكثر الناس ولم يتمه، وإصلاح المنهج حلقات، في كل حلقة ميزان يجب أن تدركه، فإذا أدركته= وَزنتَ به ما وُضع هذا الميزان له.
| يقول بيجوفيتش في نصٍّ مهم: ((هناك أناس يُكدِّسون المعارف في عقولهم من دون أن تتسعَ رؤيتهم؛ فهذا الاتساع لا يتحقق إلا من خلال الأفكار)). |
قلت: لدينا هنا ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: الحصيلة المعلوماتية؛ وهذه يكفي لتحصيلها مواصلة القراءة والاطلاع الثقافي من غير درسٍ منهجي لتحصيل الأدوات.
المرتبة الثانية: إنتاج الأفكار؛ وهذه لابد لها من خطوتين أساسيتين:
1) الدرس المنهجي الذي يقصد إلى ضبط أدوات ومفاتيح العلم أو المجال المراد إنتاج الأفكار فيه.
2) مداومة الاطلاع المخلوط بالتأمل النقدي على كتابات المبدعين والمجددين وأصحاب النقلات المحورية في العلم المراد إنتاج الأفكار فيه، -وتزداد القدرة على إنتاج الأفكار بزيادة الاطلاع الثقافي خارج مجال العلم المراد إنتاج الأفكار فيه.
المرتبة الثالثة: صياغة منهج النظر، والذي يليه-إن استطعته- صياغة رؤية منهجية مترابطة ومتكاملة.
وهذه أشق المراتب وأعسرها، ولا تُنال إلا بطول الزمان وتكرار النظر، ومداومة البناء والهدم، وإعادة التشكيل مع التواصل والحوار، والصبر التام والانقطاع التام.
والحقيقة إن التأمل وتكرار النظر وتقليب وجوه الرأي= هو الأداة الأهم لإنتاج الأفكار وصياغة المنهج؛ لذلك يقول بيجوفيتش في نص مهم آخر: ((كثرةُ القراءة لا تجعلنا أكثرَ ذكاءً، فبعض الناس يلتهمون الكتب من دون الوقفات الضرورية للتفكير، هذه الوقفات ضرورية من أجل هضم المقروء ومعالجته، من أجل استيعابه وإدراكه… ،إن القراءةَ تقتضي إسهامَ القارئ فيما يقرأ، ويحتاج هذا إلى وقت، كالنحلة تُحوّل الرحيق في بطنها إلى عسل)).
وبعدُ..
فالنظر الذي يعتمد على؛ جمع ما يتعلق بالمسألة، والنظر في أجزاء المسألة جزءًا جزءًا، مع جودة ترتيب المقدمات والنتائج، واختبار ما يتم إيراده من الحجج، والعمق في استقراء أسباب الظواهر وصولاً إلى تفسيرها، مع الحذر من السطحية، والتفسيرات الواحدية، ومع فتح النسق، وتقدير احتمال الخطأ= هذا هو التفكير المستقيم الذي يقود للعلم، ويُنقذ صاحبه من براثن المغالطات والأوهام، وبمثلِ هذا التماسك المنهجي؛ أقام الأئمة صروح العلم.
وأنا أريدك أن تتأمل في أمر عظيم يغفل عنه الناس:
أنت تسمع كثيرًا عن أن علماء هذه الأمة كانوا يقولون ويعظمون من يقول: لا أدري.
وأنا أريد أن أقول لك: إنَّ أكثر قول (لا أدري) عند السلف ليس باعثَها الجهلُ، وإنما حملهم عليها احتياجُ القول لفضل اجتهادٍ ونظر.
وهذا هو ما غُفل عنه في زماننا؛ فكثُرت الفتيا فيما يحتاج للنظر والاعتبار، وقَلَّتْ في الناس (لا أدري)؛ لأنهم ظنُّوا أن مجردَ استحضار جوابٍ يغني عن (لا أدري)، وأن (لا أدري) لا تُقال إلا مِن جهل، وأن “العلم” أن تنظر في المسألة يومًا ويومين، ثم تقول فيها!
وليس كذلك.
والواقع أن كثيرًا مما قال فيه الواحد من السلف: (لا أدري)= قد كان معه فيه من العلم؛ ما لو كان مع رجلٍ من الناس اليوم= لحسب نفسه فقيهًا بريء الذمة إذا أفتى، أما أئمة السلف: فما كانوا يرون ذاك الذي معهم يقوم بالفتيا، ولا كانوا يسوغون للرجل أن يهجم على المسائل بما معه من علم ناقص، وكانوا يرون فرقًا عظيمًا بين أن تعلم شيئًا هو؛ إلى فضل النظر أحوجُ منه إلى عجلة الجواب، وبين أن تحيطَ بعلمٍ قد اكتملت أركانه.
ولأجل ذلك، كانت الطبقاتُ المتقدمة أهلًا لأن تُؤسَّس على أيديهم العلوم، وأهلًا لئن تكونَ أزمنتُهم هي ذروة الإبداع الإسلامي.





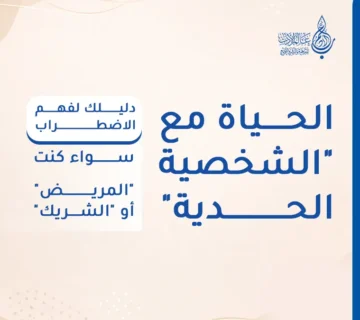

لا يوجد تعليق