المفتاح الثاني من مفاتيح الحياة الطيبة: ميزان النفع.
والمراد به هنا أن يكونَ النَّفع الذي يحبه الله، سواءَ نفع الذات أو المحتاجين، أو النفع بما يُصلِح الدنيا، والنفعُ بما ينجي يوم القيامة= هو المحور المركزي الذي نقيس به فعاليةَ وجدوى وقيمةَ الأشياء، والتصرفات، والعلاقات.
ولا زلنا مع هذا المفتاح أيضًا داخل دائرة المفاتيح المتعلقة بتحديد هُويةِ الخيارات عند مقامات التعارض والموازنة؛ فإن معياريةَ الوحي لا تمنع أن يغلَطَ الناس في الاختيار، لكنه ليس غلط اختيار الشر وترك الخير، وإنما غلط الاختيار داخل دائرة الخير، أو داخل دائرة ما ليس شرًا، فقد لا يبلغ ضرر الشيء أن يكون شرًا، لكن سيبقى له من الضرر ما يجعل اختياره غلطًا، قد يكون في الخيار من النفع ما يجعله خيرًا، لكنه لا يبلغ من الخيرية ما يجعل تفضيله على غيره هو الخيار الصحيح.
حقيقة هذا المفتاح: أن تجعل النفعَ قيمةً مركزية للخيار والموازنة، وأن تجعل طلب الأنفع هو محور تلك القيمة المركزية.
إن مادة النفع والنافع والأنفع تتردد في نصوص الوحي، فالله يقول: ﴿إِنَّ في خَلقِ السَّماواتِ وَالأَرضِ، وَاختِلافِ اللَّيلِ وَالنَّهارِ، وَالفُلكِ الَّتي تَجري فِي البَحرِ بِما يَنفَعُ النّاسَ، وَما أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِهِ الأَرضَ بَعدَ مَوتِها، وَبَثَّ فيها مِن كُلِّ دابَّةٍ، وَتَصريفِ الرِّياحِ، وَالسَّحابِ المُسَخَّرِ بَينَ السَّماءِ وَالأَرضِ= لَآياتٍ لِقَومٍ يَعقِلونَ﴾
[البقرة: ١٦٤].
والله يقول: ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَت أَودِيَةٌ بِقَدَرِها، فَاحتَمَلَ السَّيلُ زَبَدًا رابِيًا، وَمِمّا يوقِدونَ عَلَيهِ فِي النّارِ ابتِغاءَ حِليَةٍ أَو مَتاعٍ زَبَدٌ مِثلُهُ كَذلِكَ يَضرِبُ اللَّهُ الحَقَّ وَالباطِلَ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذهَبُ جُفاءً، وَأَمّا ما يَنفَعُ النّاسَ فَيَمكُثُ فِي الأَرضِ، كَذلِكَ يَضرِبُ اللَّهُ الأَمثالَ﴾
[الرعد: ١٧].
وفي الحديث: ((خيرُ الناسِ أنفعُهم للناس)) .
ومن أجمع الوصايا النبوية قوله ﷺ: ((احرِص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز)).
إن الدليلَ الإرشادي لعيشِ الحياة، واجتياز محنتها، وتحدياتها= لا يتكوَّنُ من عناصرَ كثيرة، هو بسيطٌ جدًا في عناصره، وأنا مُصرٌّ أنه ليس صعبًا في تنفيذه، الصعوبةُ الحقيقية هي في الصوارف التي تصرفك عنه، واستسلامك لها.
“احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز”.
هذه هي الوصفة السحرية، فكل من حرص على ما ينفعه وعاش حياته يطلب ما ينفعه ويُحسِّن ميزان العلاقة بين ما ينفعه في الدنيا وينفعه في الآخرة= فلن يعاني – فيما أظن- من الحيرة التي تسيطر على حياةِ من فَقَدَ بوصِلة الحياة.
تمر بنا جميعًا لحظاتُ ضعفٍ وقنوطٍ وإحباط، وجماع علاجها في ثلاثة أركان، تجمعها جملة نبوية واحدة: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز.
والعجزُ ليس هو عدم القدرة الذي يُعبر عنه الفقهاء بهذا اللفظ، وإنما العجز هنا هو: قعودُ النفس في وهدةٍ وهي تستطيع الخروج منها.
| إن كلَّ ما ينفعك في دينك، ويُصلح لك دنياك، التي هي مزرعةُ آخرتك، هو مطلوبٌ لله عز وجل، والوحيُ هو معيارُ تحديدِ النَّفعِ والضُّرِّ؛ فليس كل ما يعجبك ينفعك. |
أما ما سكت عنه الوحي بخصوصه= فَتَرجِعُ معاييرُ قياس النفع والضر فيه، لعمومات الشرع، وللتجربة الإنسانية وقياسها بأدواتها المتاحة لعلامات وأمارات النفع والضرر المادية والمعنوية.
فإذا ثَبُت كونُ الشيءِ مما ينفع في الجملة، أو مما يضر في الجملة= فيأتي الخيار في فعله أو تركه، ليخضع بعد ذلك لموازنات ما هو الأكثر نفعًا والأشد ضررًا، وما هو الأنفع لك تناسبًا مع شخصيتك وقيمك وأهدافك في سلسلة لا تكاد تنتهي من الموازنات بين الخيارات المتعارضة، فقد أعطيتك المفتاح، لكن أسنان المفتاح تتشكلُ بتشكُّلِ التجربة الذاتية وليست وجهًا واحدًا يشترك فيه كل الناس.
وإن مما ينفعنا هاهنا: كلامُ الفقهاء في أبواب المفاضلات في العبادات، وأنه ليس فيها تفضيلٌ مطلقٌ إلا من حيث التجريد عن المتغيرات، أما عند مراعاة المتغيرات الزمانية والمكانية، وحاجات الأشخاص، والجماعات= فإن تعارضَ المتغيرات سيجعل الفعلَ الأقلَ رتبةً (المفضول) خيرًا لشخصٍ معينٍ في سياقٍ معينٍ من الفعلِ الأعلى رتبةً (المفضول)، وأن أجوبةَ النبي ﷺ تنوعت عن سؤال: “أيُّ العملِ أفضل؟” بتنوع سائليه وحاجاتهم، وسيقودنا هذا لحقيقةٍ عظيمة: وهي أنه ليس ثَمَّ خطة عملٍ تصل كل الخلق، وهي الأفضل والأنفع لكل الخلق، هذا حديثٌ خرافة.
إن أصولَ الإسلام، وأركانَه الواجبة، وحزمة منظوماته الأخلاقية الملزمة= لا خيار لأحد في ترك شيء منها، وإنما يتفاوت الناس في كمالاتها لا في أصلها، وفي مداواتهم لنقصها والتوبة من التقصير فيها، لكنها في الجملة ليست ميدانًا لمفاضلات الفعل والترك.
أما كمالات الشُعبِ الإيمانية، وموازنات النفع في الخيارات الدنيوية= فإن التعارضَ فيها لا يصح أن تخلوَ الموازنة الترجيحية فيه من عنصر الذاتية، وإن الفرادة الإنسانية في محمدٍ ﷺ وأصحابِه، وتنوع قدراتهم، ومواهبهم، والتي تكلمنا عنها في تدوينة سابقة= لَتَدُلُّنا على أن تلك القوالب المصقولة فاقدة الهُوية، محايدة النوازع والأغراض= لا يعرفها ديننا في تصوره عن خيارات الناس في حياتهم، وإنما أنت تختار حياتك، وما تُحسِنه وتُبدعِ فيه فَتُتقِنَه، وتجعله مشروع حياتك، وحيث كان مباحًا ينفعك وينفع الناس= فإن الله يرضى منك به، فلسنا جميعًا نسخةً واحدة، إنما نحن أمة الجماعة، كل جدولٍ منها يصُبُّ في النهر؛ وإن مَصبَّ النهر على جنة الخلد.
لا تتولوا ما كُفيتم، ولا تُضيعوا ما وُليتُم.
هذا هو أصلُ الإصلاح وذُروة سَنامه؛ ألّا يَشغلَ الإنسانُ عمرَه إلا بما يتقنه، ويقدر على تجويده والتميز فيه.
ابحث بهدوءٍ وأناةٍ عن مواهبك، ومكامن تميزك، وطوِّرها، وأصلحها، وأصلح بها.
إن فاعليةَ المجموع من فاعليةِ الأفراد، وعندما لا يقوم كل فردٍ بدوره على أتمِّ وجه = لا تنتظر من أيِّ أمةٍ أن تكونَ أمةً فاعلة مؤثرة.
وقيامُ كل فردٍ بدوره يعني عدة أمور:
أولًا: أن يبذُل أقصى جهده في الفعل المتقَن لما يُحسنه.
ثانيًا: أن يستمرَّ في تطوير نفسه على مستوى؛ تجويد الأدوات، وتجويد الفعل، وتجويد ما يُحسن، وزيادته.
ثالثًا: أن ينطلق في فعله من مرتكزاته الخُلُقية والقِيَمية، وأن يجعلها هي أساسُ تحديد الخيارات.
رابعًا: لا تتولى ما كُفيت ولا تُضيع ما وُليت، شُعَب الخير والإيمان وأبواب خدمة الدين كثيرة؛ فلا تنصرف عمّا تحسن إلى شيءٍ لا تُحسنه، أو إلى شيء قد قام به غيرك، لا يزيده كونك معه فيه.
خامسًا: دوائر اهتمامك لا ينبغي أن تطغى على دوائر تأثيرك، اهتمَّ بقضايا المسلمين، لكن لا تبذل في هذا الاهتمام أكثر من خمسِ طاقتك، والباقي اصرفه للقضايا التي تستطيع أن تُحدِث فيها تغييرًا ملموسًا.
ستؤجر على كل بابٍ من أبواب المسلمين تحمل همه، لكنك ستُسأل عن كل بابٍ لم تقم فيه بما كان في وسعك، ووِزرُ التقصيرِ يأكل أجرَ الهمِّ العاري عن الفعل.
أي شيء ينفعك يومٌ من الهمّ والحيرة والضيق بواقع المسلمين، بينما أمام عينك، وبجوار بيتك، وعلى طرف الثمام منك، أبوابٌ مشرعة، وشعبُ إيمانٍ تنتظر مَن يشغلُها؟!
ما يبدو لك كخبرٍ عابر، يمثل لآخرين حياةً بأكملها.
هناك قَدْرٌ من الشعور بمعاناة الآخرين ضروريٌّ لحياة الإنسانية في قلبك، لكن هذا القدر إن زاد عن حده أماتَ فيك الرغبةَ في العيش، وأقعدك وأضر بك ولم ينفعك.
ربما لأجل ذلك أماتَ اللهُ في آذاننا القدرةَ على سماع عذابِ الأموات.
قد يبدو لنظرِ عَجولٍ أن ذلك السماع يعظ، لكن الفقيه يعلم أن ذلك السماع يترك النفس معطَّلةً، قد ذهل منها القلبُ العَقول.
ثم اعلم أن كل ذلك لن يحميَك من همِّ ازدحام النافع، لكنه في نفسه همٌّ نافع تستعين عليه بتطوير معارفك ومهاراتك الإدارية؛ فإذا ازدَحَمتْ في رأسك قُبيل نومك مئاتُ التفاصيل اليومية، وكلها مما أَجهد ذهنك وبدنك، شطرُها مما أنهك يومك الفائت، وشطرُها الآخر مما يختصمك في ساعات يومك القادم، وكلها مما لا تكاد تذكر همَّ واحدةٍ حتى تقدِم أختها تقاتلُ عن حظها منك، وكلها مما ينفعك، وينفع الناسَ، ويرضي الله= فذلك وحده هو الطريق يعصمك مما يفتِك بالناس من أدْواء البطالة، أو القاتل الصامت؛ الشغل بما لا ينفع.





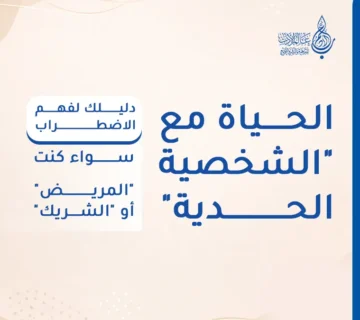

لا يوجد تعليق