في هذا المقال أحاول أن أرصدَ باختصارٍ أهم المعارضات التي تقوم في نفوس الناس تجاه أحاديث السنة، فتؤدي إلى رفضهم تصديق هذه الأحاديث، وإلى عدم التزامهم بحُجِّيتها ومعياريتها، وإذا تبين وهاء هذه المعارضات وعدم قدرتها على الاستقلال بمعارضة الأخبار، سنعود مرة أخرى إلى التسليم بأن المنهج العلمي لنقد الرواية والذي استعمله الفقهاء والمحدثون سيبقى هو الألصق بمعنى العلمية والأصلح لأن يُحاجج المرءُ به ربه يوم القيامة إذا رد خبرًا منسوبًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أولًا: معارضة السنة بالقرآن.
- يقول تعالى: ﴿وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدودَهُ يُدخِلهُ نارًا خالِدًا فيها وَلَهُ عَذابٌ مُهينٌ﴾ [النساء: ١٤].
- ويقول تعالى: ﴿وَمَن يَقتُل مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذابًا عَظيمًا﴾ [النساء: ٩٣].
هذه الآيات وبنفس طريقة الفهم التي يتَّبعُها الذين يزعمون أن القرآن عندهم معيارٌ حاكم في قبول السنة= تدل على أن العاصي والقاتل يُخلَّدون في النار، وبها استَدل من كَفَّر مرتكبَ الكبيرة، وخصوا المعصيةَ بالكبيرة استدلالا بالقرآن نفسه حين استثنى اللَّمم.
ولا يمكنك أن تستدل عليهم بالقرآن نفسه، والذي فيه أن الله يغفر ما دون الشرك؛ لأنهم يقولون لك: إن نفس ارتكاب الكبائر شرك؛ ويستدلون بقول الله: ﴿وَالَّذينَ لا يَدعونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًا آخَرَ وَلا يَقتُلونَ النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلّا بِالحَقِّ وَلا يَزنونَ وَمَن يَفعَل ذلِكَ يَلقَ أَثامًا﴾
[الفرقان: ٦٨].
بالطبع روى البخاري ومسلم وغيرهما أحاديث قطعية في أن مرتكب الكبيرة لا يُكفَّر، وأنه من عموم المؤمنين الذين لو ماتوا على الكبائر ولم تَغلب حسناتُهم سيئاتِهم= فَهُم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم.
الآن: هل الذين يزعمون أن القرآن معيارٌ حاكم عندهم في قبول السنة وردِّها يحتجون بالقرآن، ويكفرون مرتكب الكبيرة، ويضعفون أحاديث الصحيح في ذلك لأنها تعارض القرآن؟
الجواب: لا.
لأنهم في الحقيقة لا يصدرون عن نظرٍ منهجي يجعل القرآنَ معيارًا حاكمًا بالفعل، غايةُ ما هنالك أنهم أصحابُ أهواء، قد غلبت على قلوبهم بعضُ مفاهيم الثقافة الغربية الحداثية فاشمأزت هذه القلوب من بعض قَطعِيَّات الشريعة، ولم تجد بُدًّا من ردها، وأرادوا أن يكون هذا الرد بطريقٍ ديني؛ فجعلوا هذا الطريق هو معارضةُ القرآن.
والحقيقية أنه لا تعارضَ بين القرآنِ والسنة، لا في المسألة التي بدأت بها كلامي، ولا في المسائل التي أبطلوها من السنة، ولكننا نُلزمهم إذا كنتم تردون السنة عند المعارضة فهيا كفروا الناس إذا قتلوا أو سرقوا.
يبقى سؤال:
هل من مناهج نقد الرواية أن يتم عرض هذه الرواية على القرآن أو على محكمات الشريعة؟
الجواب: نعم.
وهو منهج مُتَّبع لدى أهل العلم منذ الصحابة وحتى أهل الحديث مرورًا بالفقهاء، وإن كانوا يتفاوتون في إعماله، على نحو ما أشرت له في فقرة “تنزيل الرواية منزلة السنة” من كتاب ما بعد السلفية.
لكن هنا يكون عرض الرواية على القرآن ومحكمات الشريعة عرضًا يرتكز على أسس علمية ومنهجية، يتم فيها النظر إلى كل مسألة على حدة، ووزن مدى الثقة بأسانيد الرواية، ووزن مدى الثقة بفهم القرآن المعارض لها، ومدى تحقق وقوع المعارضة بالفعل، ويقع الخلاف السائغ حينها فيُقدِّم بعضُ العلماء ثقته بالرواية وثبوتَها ويستطيع دفع المُعارِض، وبعضهم يقدم ثقتَه بوقوع المعارضة على ثقتِه بثبوت الرواية.
أما ما يقع من بعض المعاصرين من اتجاهاتٍ مختلفة فليس كذلك، وليس نظرًا يرجع للبحث في المسائل، وإنما هو نظرٌ يرجع لأسسٍ فكرية كلية يتوهمون صحتها (مثل الهزيمة أمام الحداثة أو عدم تحقيق علاقة الإخبار الغيبي بالمُشَاهَد الحسي)، وتكون هذه الأسس بمثابة المنطلق الكامن خلف حُججهم، وبها يعبثون في أحاديث ثابتة لا يتطرق إليها الشك، وبعضها متواتر رواه عددٌ كبير من الصحابةِ، والأسانيدُ إليهم مختلفة، ولا ترتكز معارضتها على أسسٍ علمية بقدر ما ترتكز على نقصٍ شديد في فهم الشريعة.
عندما يقول بعضهم: إن عائشة رضي الله عنها عارضت رواية ابن عمر لحديث “إن الميتَ يُعذب ببكاء أهله”، بقول الله: ﴿وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخرى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
نقول له: عائشة تعارض رواية صحابيٍّ واحدٍ خاطبها بحديثٍ واحد، وترى هي احتمال دخول الخطأ والنسيان والوهم عليه.
أنتم في أحيان كثيرة تعارضون بالقرآن أحاديثَ ثَبتَت من طرق شتى، ولمعانيها شواهد في أحاديث أخرى، وآثارٌ ثبتت عن الصحابة في المعنى نفسه، كما ضَعَّف بعضهم حديث الرجم، ولم يستطع أن يخبرنا ماذا سيفعل في حديث قتل الثيِّب الزاني؟!
وليس النصُّ القرآني الذي معهم في أحيان كثيرة بظاهرِ الدلالة على موضع المعارضة، كمعارضة بعضهم حديثَ: “أمرت أن أقاتل الناس -وهو في الصحيحين، ورواه خمسة من الصحابة- بآية لا إكراه في الدين ونحوها”.
فأنتم تعارضون شبكةً كاملة من النصوص والدلالات بفهمٍ للقرآن لا يقوى على تلك المعارضة، فأين فعلكم هذا من فعل عائشة، أو الفقهاء، أو حتى من المنهج العلمي؟
ثانيًا: معارضة السنة بالعقل.
وأكثر ما يُذكر في هذا الباب هو معارضة السنة بالذوق الخاص والرؤى الذاتية، وهي التي يسميها القرآن: الهوى، والأهواء.
وصاحبُ هذه المعارضات يُقِيمُ رأيه واجتهاده الخاص وتصوراته الذاتية المحدودة بحدودِ علمِه وخبرته= في خصومةٍ مع التصور المذكور داخل الرواية، والعجيب أنه إذا كانت هذه الخصومةُ مع مخالف له من عموم البشر، لم يكن هذا -بمجرده- دليلًا على صواب رأيه وخطأ مخالفه، فكيف يجعل هذا دليلًا يقوى حتى يَرُدَّ به روايةً ثبتت بمناهج علمية ليس معه ما يقوى على معارضتها؟!
وحقيقة الأمر: أن التصورات الذاتية التي تقوم في نَفسِ واحدٍ من الناس فيُنكِر بها، مثل حديث: ناقصات عقل، أو مثل حديث إن المرأة خُلقت من ضلع= لا تكفي لرد الروايات؛ فليس هذا التصورُ عن تشريف المرأة تشريفًا يمنع نقصها إلا رؤية خاصة لا بينة عليها تجعلها معيارًا للعقل السليم يُرَد ما خالفه، وليست عقلا يمكن معارضة الروايات به وتقديمها عليه، بل لو كان هذا التصور رأيًا يُذكر في مقال صحفي= لأمكن مخالفته ولما كانت هناك بينة على خطأ المخالف، فكيف ترد الروايات الواردة بأسانيد صُحِّحت بمنهج علمي، بمثل هذا الكلام؟!
والشيءُ الوحيد الذي يمكن أن يسمى عقلًا متجاوِزًا للذوق الذاتي، ويمكن معارضة الروايات به هو قوانينُ الفكر الثلاثة، وبالتحديد قانون رفع التناقض، فتكون معارضتك للسنة مقتضاها أنك ترى في ثبوت الرواية تناقضًا لا يمكن نسبته للشرع.
ومعارضةُ الروايات بقانون التناقض سيستلزم الرجوع للمعارضة بالقرآن أو للمعارضة بالروايات الأخرى، وهو منهج علمي صحيح من حيث الأصل كما أسلفنا، وإنما يقع الفساد مِن توهُّم معارضات لا وجود لها إلا في تصور الناقد وذوقه.
فالحقيقة أنه لا يوجد عقلٌ ذاتي مجرد يمكن أن تُعارَض الروايات به، وإنما الموجود إما معارضات فاسدة وهي المعارضة بالذوق الخاص والتصور الذاتي.
وإما معارضة صحيحة منهجية وهي المبنية على قانون التناقض، وبالتالي لابد من تأسيسها على إقامة معارضة بين الرواية المنتقَدة وبين القرآن أو بين الروايات الأخرى، فهي معارضة بعقل مؤسَّسٍ على نقل، أما عقل مجرد يعارِض به فهو هوًى وذوقٌ، وليس عقلًا.
ثالثًا: معارضة السنة بالحس.
وهذا النوع من معارضات السنة هو أشدُّ معارضات السنة ضعفًا؛ وذلك لأن معظم الأخبار التي يتم نقدها؛ لأنها تناقض المحسوس هي أخبار غيبية، وحقيقةُ الغيب نفسه أنه وراء الحس، وبالتالي فنقد هذه الأحاديث ،التي تخبر عن شيء غيبي وراء الحس، بسبب أنها تخالف المحسوس= هو في حقيقة الأمر خللٌ في تصور طبيعة مضمونها الغيبي، وهي معارضة يُتصور أن تَصدر من لا ديني أو ملحد لا من مسلم؛ لأن هؤلاء طريقتهم مَطَّردة، فهم لا يسلِّمون بأي متجاوِز: قرآن أو سنة أو غيرهما، يتجاوز المحسوس، أما المسلم الذي يُثبِت الملائكة والجن، ثم يعتبر أن حسَّه تعرض للتحدي من حديث سجود الشمس عند العرش، أو إيقافها للنبي= فهذا أمر غير مفهوم.
إن الأحاديث التي تتكلم عن سجود الشمس، أو عن الرعد، أو البرق، أو عن النيل والفرات وأنهما ينبعان من الجنة= كلها لا يجوز أن تعارَض بالحس، كما أنها لم تُنكِر المشاهدات الحسية الفيزيقية، هذه الأحاديث تتحرك في منطقةٍ غيبية ميتافيزيقية لا يستطيع الحس الذي لا يدرك سوى أبعادٍ زمانية ومكانية محدودة= أن ينكرَها لمجرد أنه لا يحيط بها.
إن حدود الأبعاد الزمانية والمكانية التي يدركها الإنسان محدودةٌ جدًا بقدر محدودية أدواته في الكشف، وبالتالي فليس في هذه الأحاديث إلا مصادمةُ مستوًى معينٍ من مستويات الإدراكات الحسية للإنسان، وهذا لا يقتضي أن يعارضَها الإنسان، وإنما يقتضي أن يُسلِّم بطبيعة هذه الأحاديث الغيبية، وأن يُسلم بتعلقها بمستويات إدراكية لا يحيط هو بها في ظروفه الحالية.
الآن الجدار يسبح بحمد الله هذا ثابت بيقين، فالله يقول: ﴿ وَإِن مِن شَيءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤]، ونحن لو وضعنا مائة سماعةٍ مكبِّرة على الجدار لن نسمع شيئًا، وعلميا الجدار جماد لا يسمع ولا يتكلم…
السؤال: هل خَلقُ اللهِ لجمادٍ قادر على التسبيح بطريقةٍ لا تدركها عقولنا ولا حواسنا ممكنٌ أم لا؟
أي مؤمن يعلم أن هناك غيبًا سيقول: ممكن.
حسنًا، هل هو واقع أم لا؟
الجواب: أي مؤمن يصدق بالنبي والقرآن سيقول واقعٌ بدليل النص.
وهل عدم سماعك له، وعدم إدراك الرصد العلمي له يصلح لمعارضة الغيب ونفيه؟
الجواب: لا. لأن غاية ما مع العلم أنه لا يُدرك، لكنه لا يستطيع نفي وجود هذا التسبيح في مستوًى إدراكي آخر ليس معه أداةٌ لرصده.
نفسُ المسألة في سجود الشمس، الواقع أن سجودَ الشمسً ثابتٌ في القرآن، وليس فقط في الحديث، وهذا السجود سجودٌ مستمر باستمرار وجودها وغروبها، والله يقول: ﴿أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسجُدُ لَهُ مَن فِي السَّماواتِ وَمَن فِي الأَرضِ وَالشَّمسُ وَالقَمَرُ وَالنُّجومُ وَالجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوابُّ وَكَثيرٌ مِنَ النّاسِ ﴾ [الحج: ١٨].
كل القضية أن هذا السجود يحدث بطريق غيبي خارج قدرة العلم الإنساني الحالي على الرصد، والواقع أنه وفقا لفلسفة العلوم المعاصرة وللثراء الكبير في النظريات الفيزيائية في النصف الثاني من القرن العشرين= لا يوجد أية استحالة علمية في وجود حوادث كونية قائمة، وتحدث بالفعل لكن يعجز الرصد العلمي المعاصر عن إدراكها.
إن الصِدِّيق إنما سُمي الصديقُ لأنه صَدَّق الرسولَ فيما كان يقطع الحسُّ وقتها باستحالته، والمؤمن إنما سُمي مؤمنًا لأنه يؤمن بغيبٍ لا يدركه الإنسان حال الخطاب.
وإن مسلمًا يؤمن بجنٍّ، وملائكة، وجنة، ونار، ومعجزات، ثم يعتمد على حسه في رد حديث هنا وهناك= لَيُعاني من تناقضٍ وخلل في فهم طبيعة الحس وعلاقته بالغيب.
والصواب هو الإيمان بمنطقة الغيب التي تُخبر بها هذه الأحاديث الصحيحة، وأنها لا تَرِد هي ومنطقة الحس على محلٍ واحد لتقوم المعارضة أصلًا، فليس معك أصلٌ تعارِض به رواية الراوي، بقطع النظر عن ضبطه للرواية من عدمه.





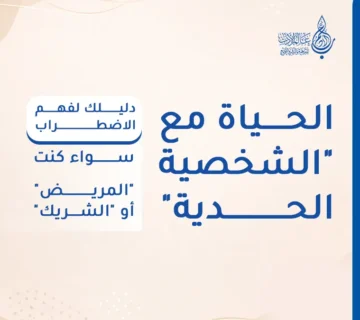

لا يوجد تعليق