((والنبي دعا الخلق بغاية الإمكان، ونَقَل كلَّ شخص إلى خيرٍ مما كان عليه بحسب الإمكان)).
ابن تيمية
(1)
إن تراجع الهمِّ الدعوي يُعدُّ في نظري أحد أعظم تجليات المحنة ومظاهر الإحباط التي يمر بها هذا الجيل، يأخذُ تراجعُ الهم الدعوي صورًا شتَّى، فتارةً يأتي في صورته البسيطة، مجرد كسل وقعود غير مبرر ولا يشتغل صاحبه بمداراته، ، وتارةً يَلبس لباسَ الترفُّع عن موضوعات الدراويش وحملة المباخر هذه، وتارة ثالثة يلبس لباس القدح في الناس ومدى استجابتهم ووعيهم، وتارة ليست أخيرة يلبس لباس ذم الداعين إلى شعب الإيمان، ووصمهم بالدروشة، والغفلة عن قضايا الأمة، وأنت إذا نزعت عنه أرديته هذه كلها أتاك في صورته العارية لا يتجمل ولا يتخفى= وهي أنه نوعٌ شديدُ الضرر من الضعف الإيماني ومن التخلي عن مسؤولية الرسالة، ومقتضيات الاتباع، وهو أحد أغراض الشيطان من بني آدم؛ فهو لا يطمع منهم بأكثر من هذه الخيانة للأمانة.
الصبر، والدعوة إلى الخير، واستصلاح الخاصة بتعليمهم نهجَ الحق فيما اختُلف فيه، وإرشاد العامة إلى جُمل الدين والمتفق عليه، والجمع بين شعب الإيمان، وألا يدخل الرجل في أمر السلطان إلا بقدر ما يعينه على دعوة الناس= هو صراط الحق الذي يُبقي الدينَ في الدنيا والناس مهما عظمت الفتن.
إن التربية والدعوة منهاجًا وممارسة من أكثر المناطق التي تحتاج إلى اشتغال وإعادة بناء، ولا يمكن ذلك إلا إذا تصدَّى لها عدد كبير من الكفاءات مسلَّحين بأدوات الفقه والعلوم الإنسانية، مع اعتدالٍ في المزاج وسلامةٍ في الصدر وصحة نفسية وأُفُقٍ واسع، مع سلامة من آفات التنظيمات المعسكرة.
| الدعوة المجتمعية، وإصلاح دين الناس ووعيهم= خِيارٌ ثابت، لا ينبغي أن تغيره الحوادث، ولا يردك عنه أذًى، ولا تزهدك فيه هزيمةٌ. وإن ضريبةَ الداعي إلى الله مهما رفق بالناس= أن يُؤذَى، وليس له إلا الصبر على أذى المدعوين. ومن لم يصبر صبر الأجر سلا سلو البهائم. |
ومن لم يُطق الصبر على الدعوة واحتمال الأذى فيها فلِمَ انتصب لمهامِّ الأنبياء؟!
لِمَ لم يعش من البداية على هامش الحياة يُرعى كما تُرعى الأنعام؟!
اللهم صلِّ وسلم وبارك على القائل: اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون.
وأنت إذا لم تُضع مقدورًا، ولم تُجاوز مشروعًا كنت من ورثة الأنبياء، صَلُحَ العالَمُ أم فَسُد.
إن العامل منا، والذي أرى ربَّه منه جهده وطاقته وصدقه واتباعه= ليس يؤلمه واقعُ الهزيمة المر، بقدر ما يُسري عنه علمه أن هذا إنما هو قضاء الحياة الدنيا، وأن وراء ذلك قضاءً أُخِّرَ لأجل معدود، الوزن فيه يومئذٍ الوزن الحق، وترى المجرمين يومئذ مُقَرَّنين في الأصفاد، بعضهم يموج في بعض، وضلَّ عنهم ما كانوا يفترون، يومئذٍ يوفيهم اللهُ دينهم الحق، لا بشرى اليوم، وخسر هنالك المبطِلون..
ومتى ما أَخرج حامل الحق هذا العنصر من حساباته = لم يصطبر على بلاء يصيبه، ولم تُطق نفسه احتمال هزيمة تَلحق بدينه، ولم يقوَ قلبه على حَمل تَبِعات الحق الذي معه..
وعاش ممرور النفس، مكتئبًا، محبطًا، قد نال العدوُّ من نفسه وقلبه وعزيمته أعظمَ مما نال من أرضه وحماه وبيضته.
(2)
الدعوة المجتمعية للناس ينبغي أن يكون مركزها جُمل الكتاب والسنة المنصوصة، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلِّمها الأعرابيَّ، ويبايع عليها الناس.
ما وراء ذلك من المفاهيم والأفكار والتفصيلات والاختيارات= لا ينبغي أن تكون مركزًا للدعوة، وإنما يتنوع ذكرها بتنوع الأمكنة والأزمنة والأشخاص، وليست خطابًا عامًّا للناس، ولستَ واسعًا كل الناس في مذهبك، لكن الإسلام يسعكم.
والخطأ العظيم هو جعلُ منظومة المفاهيم والأفكار -وإن كنتَ تعتقدها الدين الحق، ومذهب السلف- حقيبةً دعوية، وتطلب أن يحفظها كل الناس.
وأحد الإشكالات العظيمة في الخطاب الدعوي أنه كثيرًا ما يُخاطِب المجتمعات المسلمة بأعلى نقطة، بالنقطة التي لم يبلغها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد سنين من التربية الإيمانية وتأهيل النفوس، ثم بعد ذلك أيضًا لم تبلغها كلها إلا الصفوة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
الداعية والواعظ ويسانده الفقيه للأسف يأتون إلى الشاب يكاد لا يصلي، والمرأة قد لا تعرف عن دينها إلا قصصًا لعصر العين وإنزال الدمع= فإذا الخطاب الدعوي يريد أن ينقل هذا الفتى وتلك الفتاة نقلة واحدة من الظلمات إلى النور كما يقولون، فيكون الفتى مطالبًا بكسر أيامه السابقة كلها والانسلاخ منها إلى حالٍ فيها حزمة أعمال القلوب، وحزمة شُعب الإيمان الظاهرة مع كمالات الظاهر من اللباس والكلام وصورة الوجه، فيُطالَب الفتى بأن يخوضَ معركة مع هواه وأخرى مع مجتمعه لينسلخ من حالٍ إلى حال في أيام معدودات، وتُطالَب الفتاة بخوض معركة النقاب، وكسر هوى نفسها في النمص والزينة ودوائر الأصدقاء ونوع عملها وعلاقاتها ونمط اجتماعاتها، وكل ذلك لا بد أن يكون معًا وإلا كان هذا نقصًا في الاستقامة، وعلامةً على ضعف الاستجابة لله وللرسول، ومن يقبل الانتقال لتلك النقطة العليا في تلك الأيام المعدودة (الداعية مستعجل، يريد أن ينجز مهمته لينقل رجلًا آخر من الظلمة للنور)= جعلوه كالصحابة الذين أراقوا الخمر، بقطع النظر طبعا عن أنهم أراقوا الخمرَ استجابةً لخطابٍ لم يأتهم إلا بعد عشرين عامًا من أول خطاب بالرسالة.
ماذا تكون النتيجة؟
بداية لا يستجيب لخطاب أعلى نقطة هذا إلا قلة قليلة جدًا من المجتمع المخاطَب، ويبقى باقي المجتمع على حاله التي يعسر عليهم فيها جدًا أن يقفزوا هذه القفزة فيرضوا بما هم عليه.
ويفرح الداعية بهذه الصفوة المستجيبة ويعتبرها هي الطليعة المؤمنة، وجيل النصر والتمكين، والصفوة النقية التي ستحمل المشاعل لتهدي مَن وراءها.
هذه الصفوة بعد ذلك ينجو بعضهم يصلحهم الله، ربوا أنفسهم، وأصلحوا خطأ الدعوة الأولى وقللوا فسادها في نفوسهم.
ويغرق بعضهم في أمراض النقاوة والتعالي على الخلق، مع عداوةٍ شديدة لأي خلاف فقهي أو إصلاحي يُثار ليبينَ لهم أن بعض مفردات أعلى نقطة التي خاضوا لأجلها المعارك لم تكن بهذا اللزوم ولا هي بمنزلة الكليات المتفق عليها.
وتبقى فئة ثالثة من الطبيعي أن الانتقالة السريعة لم تكن كافية لدفعهم للاستمرار فتحدث الانتكاسة التي يتعامل معها الداعية بلسان حاله كما لو كانت ردة.
هذا الخطاب الدعوي ظاهرةٌ شائعة إلى حد كبير، وهو أحد الأسباب المسؤولة مسؤوليةً تامَّة عن ظاهرتين أساسيتين:
الأولى: ضعف النسيج اِلإيماني المجتمعي العام؛ لأنه لم ينقل كل فرد في المجتمع إلى أحسن مما هو عليه بقدر الإمكان، وإنما اهتم بطليعة مؤمنة، وترك الناسَ دونها على ما هم عليه، فدعوته لا تحمل إلا خيارين: أن تكون معي ملتزمًا بقائمة الالتزامات كلها دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، وإلا كنت ضعيفَ الاستجابة للوحي لا حاجةَ لأمة المصلحين فيك، اللهم طبعا إلا إذا احتاجوك في غزوة صناديق أو احتاجوا إلى الاستكثار بك في مواجهة بني علمان “باعتبار يعني إن الشعب متدين بطبعه”.
الثانية: الإشكالات النفسية والمعرفية في هذه الفئة النقية المختارة نفسها، والتي هي نتاج طبيعي لعملية الدعوة على السخَّان، والتي تنقل أفرادًا من الدور الأرضي للقمة الشاهقة في يومين، بينما القمة الشاهقة لا تُدرَك إلا بتربية النفس والصبر على تقليل شرها، ومحاصرته ومداواة نقصها ومكاثرته بالخير والإيمان.
ومن العجيب أن التدرج في البلاغ وفي الرفق بنفوس الناس ومراعاة زوال نور الخلافة= يستحضر هؤلاء مفرداته إذا أرادوا أن يسوغوا لساستهم الإسلاميين كوارث ممارساتهم، لكنَّا إذا دعوناهم لاستحضاره في خطاب المجتمعات وإصلاحها= اكتشفنا فجأةً أن الدين لا يتجزأ، وأن الصفقة واحدة، إما أن تقبلها وإما أن تردها.
يقول شيخ الإسلام: ((فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئًا فشيئًا بمنزلة بيان الرسول لما بُعث به شيئًا فشيئًا، ومعلومٌ أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأتِ الشريعة جملةً كما يقال: إذا أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع.
فكذلك المجدد لدينه والمُحيِيَ لسنته لا يبالغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يُلقَّن جميعَ شرائعه ويؤمر بها كلها. وكذلك التائب من الذنوب؛ والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين، ويُذكر له جميع العلم، فإنه لا يُطيق ذلك وإذا لم يُطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجبًا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداءً، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان، كما عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط. فتدبَّر هذا الأصل فإنه نافع)).
إن الشعوب المسلمة ليست كافرةً تنقلها من الظلمة التامة للنور التام، بل مسلمة معها ظلمة ونور، وعملك معها هو كعمل النبي ينقل كلَّ فرد إلى ما هو أحسن، ويبلغ الدين شيئًا فشيئًا، ويستصلح ويكمل، ويرضى باتساع دائرة المقتصدين، ولا يفرح بقلة نادرة من السابقين في الخيِّرات يعومون على وجه مجتمع من الظالمين المضيعين للإيمان والدين.
اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها، ولا جهاد فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «سيصَّدَّقون ويجاهدون إذا أسلموا».
وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين، فقبل ذلك منه.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إسلام من لم يُسلم إلا لأجل الدنيا، ويخبر أنس عن هؤلاء فيقول: «إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلامُ أحبَّ إليه من الدنيا وما عليها».
وهذا الباب كله يرجع إلى أصل واحد: السكوتُ عن البلاغ أو تأخير الإلزام، وهذا من الأبواب التي وسَّع اللهُ فيها للنبي ولخلفائه من الدعاة والعلماء والأمراء؛ تأليفًا لقلوب الخلق وتمهيدًا لتمكُّن الإسلام في قلوبهم.
وإن من أعظم مُحدثات الدعوة إلى الله -خاصة من السلفيين- رفعَ درجة النقاوة المطلوبة فيمن يدعونهم فلا يقبلون توبة الرجل (بمعنى دخولِه فيهم وعدِّه من أصحابهم وتسميتهم إياه ملتزما ونحوها) حتى يبلغ درجةً من النقاوة في ظنهم لا تقف فحسب على ترك الصغائر وأمورٍ مُختَلَفٍ فيها، بل تتعدى حتى إلى أن يُطلب من المدعو الالتزامُ بأمورٍ عرفية حَسْبها أن تكون من جنس المباحات فضلًا عن أن تكون سننًا.
وهم يظنون هذا شيئًا حسنًا، بل ويترفعون به عن غيرهم من التيارات التي يتهمونها بالتمييع لأجل أنها لا تفرز فرزهم هذا في قبول الناس.
والحق أنه بقطع النظر عن الأغراض التنظيمية -التي أكرهها وأكره ما وراءها- فإن التوسع في قبول الخير من الناس، وقبول توبة الرجل بمجرد عزمه عليها ولو لم يتخلص من كل ذنوبه، والسعي في تحسين النسيج، والفرح بزيادة نِسَب من يحب الدينَ والوحي ويسعى للاعتصام به ولو بقي على شيء من المعاصي غلبه عليها هواه، وإدخال الناس في الدين العام واستصلاحهم، وطَرق قلوبهم بالمعاشرة وحسن الخلق في المخالطة، وانتظار بشاشة الإيمان تعمل عملها في القلوب مع اليقين أن السابقين بالخيرات سيبقون هم الأقل في الأمة ولن يكونوا غالبها= كل ذلك أشبه بدعوة الأنبياء من مسالك الفرز والنقاوة ومقصلة الالتزام التي يظنها بعض السلفيين تصفية واجبة.
(3)
ستبقى أحوال الناس في أزماننا أحوجَ ما تكون إلى تدرج العفو والسكوت، ولين الجانب، واستصلاح الناس للدين كما يُستصلح المريض للحياة، وتوظيف العوامل النفسية في الدعوة، وعدم محاصرتهم بنصائح الفرز والنقاوة، والنصح ببلاغ الأصول، ثم ترك ما بعدها يعتمل في نفوس المدعوين بالمخالطة والإحسان وصالح الأخلاق.
أقم دعوتك على أن الظالمين لأنفسهم كثرة، وأنهم رغم ذلك من المسلمين، وأن العاصي يضيق عطنُه إن حاصرته بذكر معاصيه، لا تُحل حرامًا، ولكن احتمل واسكت وارفق، وتلمَّس للنصيحة خصب النفس وتهيُّؤها، ولا تُعن الشيطان عليهم؛ فإنك إن لم تسعهم وتحتملهم، وتتصل بهم على حالهم كما هم، لا يقطعك عنهم بقاؤهم كما هم= فلست داعية.
الدعوة بنية القطع إن لم يستقم: عِشرةٌ مخدوشة، ومودة ناقصة، ونهجٌ دعويٌّ مُحدَث، دعك من معاييرك في الفرز والاستقامة وما فيها من خلل.
ولستَ بمُستبقٍ أخًا لا تلمهُ *** على شَعَثٍ؛ أي الرجال مهذب؟!
الداعية لا يفرز الناس في الدنيا إلى أقسامهم في الآخرة، فمخبآت السرائر لا يعلمها إلا الله، وهو في سعيٍ مستمر لا يرى فيه أنه أفضل من أحد.
الذوبان في الناس بمحكمات الوحي، ومواصلة طَرق أبواب القلوب بلا أجل، والرضا من الناس بأقل بادرة استجابة، ومواصلة تنميتها واستصلاحها.
ستبلغ بعملك وخلقك ما لا تبلغه ببيانك، وثَمَّ معادن حسنة تواريها زحمة الحياة، اطلبها وانتفع بها، واحذر أن يفسدها معيارك في الفرز، صاحِب الناس على علَّاتهم، وارفق بهم، ولا تقطع قطُّ حبل الإسلام.
في غيابات السجن والظلم والقمع دعا يوسُفُ الناس، وقد ضرب الله دعوته مثلًا للداعية على بصيرة، وأرانا الله في خبر يوسف كيف كانت تلك الدعوة جزءًا مؤثرًا في منظومة واسعة من الأسباب والعوامل، قادت إلى تمكين يوسف.
ومن هنا تعلم:
أنه لو كان القمع يُزهد في الدعوة والإصلاح المجتمعي= لَقَعَدَ يوسُف.
ومن هنا تعلم:
أن موضعَ الدعوة من العمل للدين هو موضعُ المحور الثابت الذي لا يُقعَد عنه، وأن هناك منظومةً أعم تعمل فيها يد الله، ويختار سبحانه لعباده ما فيه الخير لهم، والمحكم: أنه لا يضيع أجر العاملين ما آمنوا واتقوا، وسلكوا سبيله، واتبعوا هَدي أنبيائه.





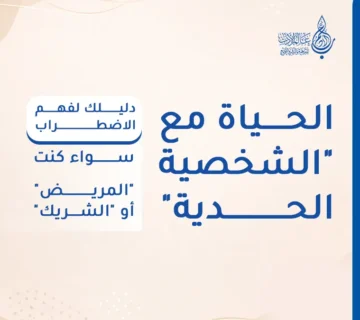

لا يوجد تعليق